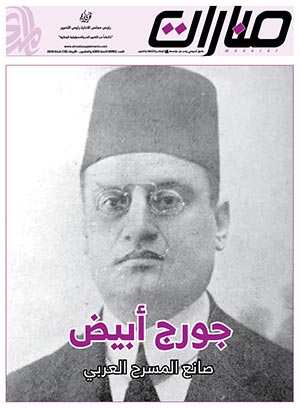حيدر نزار السيّد سلمان
شهدت نهاية أربعينيات القرن العشرين وخمسينياته عودة العشرات من الأكاديميين والباحثين ممن أكملوا دراساتهم في الجامعات الأوروبية وبتخصصات متنوعة. كما شهد العراق، وخصوصاً العاصمة بغداد، انفتاحاً غير مسبوق على العالَم الخارجي، فضلاً عن ظهور نخب متعلّمة شكّلت الأساس لطبقة وسطى جديدة التكوين اختلفت في أفكارها وتطّلعاتها عن النخبة والأوليغارشية الملكيّة الحاكمة، إذ عدّت هذه النخب نفسَها قوّةً اجتماعية هدفها الحداثة والتجديد على الأنماط الحديثة، متطلعةً إلى الإفادة من مؤسسات العالَم المتحضّر السياسية والاجتماعية والثقافية لِتشكّل مع سائر المتعلّمين العائدين من أوروبا الريادةَ في تحديث البلد.
في مذكّرات عدد من هؤلاء النخبويين ثمّة سرديات مغرية لِلتعرّف على محاولاتهم الأولى لِوضع أساس الحداثة وقيمها في مجتمعٍ مازال يرزح تحت هيمنة منظومات تمثّل مراحل ما قبل الدولة إذا حاولنا تصنيفها تاريخياً. كما يشير هؤلاء إلى نزعة تمردٍ على السائدِ من ناحية العلاقات الاجتماعية والسلوكية مثّلت بكلّ الأحوال تحدياً لِلجمود الفكري والثقافي والاجتماعي. وهنا لا يمكن إنكار الجهود التي بذلتها الدولةُ العراقية بعد تأسيسها في عام 1921 بالاتجاه نفسه والهادفة إلى بناء الهوية الوطنية العراقية على أنقاض ما وصفه الملكُ المؤسس فيصل الأول بـ"الكتل البشرية" المقادة بالأهواء والرغبات والتمردات. واعتماداً على كتاب فاطمة المحسن (تمثلات الحداثة في ثقافة العراق) يمكن لنا أن نجد البذور الأولى لِروّاد الحداثة العراقية من مهندسين وأطبّاء وفنانين وأدباء وغيرهم، ومثابرتهم في الخروج عن الأنساق التقليدية وبث أشكال جديدة من الحياة العصرية في السلوك والعمل، وهذا ما يظهر في الأعمال العمرانية والفنية والأدبية والحياة الاجتماعية. وبالفعل شاعت الحداثة إلى حدّ ما في صناعة أنموذج اجتماعي جديد يؤمن بقيمها، لاسيما المتعلّق منها بالعصرنة والعيش بروح الزمن الحاضر والتطلع نحو المستقبل، والانتقال من مراحل العلاقات ما قبل الدولة والهويات الفرعية والتمسّك بهوية عراقية. فلم تعد العشيرة على سبيل المثال هي الرابط الجامع، بل الرابطة العراقية، وسادت قيم جديدة تركّز على التعليم والحصول على المعارف الحديثة مثلما بدأت تأخذ الملابس العصرية وأساليب المعيشة المرفّهة طريقها بالانتشار مجتمعياً، وأصبح الكتّاب والمثقفون والصحفيون يركّزون على مسألة الترقية الاجتماعية ونبذ الخرافات واعتماد العلوم كأسباب للنجاح في العمل والصعود الاجتماعي، كما كانت النخب تجسّد حداثتها سلوكياً وإنجازات فنية وثقافية وفي تجمّعات وصالونات لِلحوار والنقاش تجمع هؤلاء المثقفين الرامين لنشر الحداثة. والأمر المثير للإعجاب يتمثل في عبور منطقة الطائفية والترويج لِلوطنية كرابطة أساسية، ومما يمكن ملاحظته بارتياح هو تشكّل طبقة وسطى متعلّمة وطموحة أخذت تتألق رمزياً كأنموذج لِلرقي والعصرنة ومواكبة العالم. وبالفعل أصبحت الحداثةُ ظاهرةً اجتماعية أخذت تَسود لِتتحول إلى سلوك وثقافة وفكر عند فئات اجتماعية كبيرة، مقابل تراجع واضح لِلقوى التقليدية المتضررة من هذه التحولات، إذ باتت العلاقات الاجتماعية المدنية بديلاً للعلاقات الاجتماعية القديمة القائمة على أساس القبيلة، وتطّلع الشبابُ إلى المشاركة في الحركات الحزبية والاجتماعية والنشاطات ذات الصبغة العالمية، وحبّ العلوم والموسيقى والآداب، وتطور الخطاب المتحضّر الدال على الحياة الجديدة. وأصبح ارتداء الأزياء والملابس الحديثة سمةً ثقافية، فكلّ شيء أخذ طريقَه نحو الجديد المتناغم مع روح العصر حتّى حلّت مجتمعياً قيم جديدة راحت تتجاوز القديم.
شهدت تسعينيات القرن الماضي انتكاسةً لِقيم الحداثة وتمظهراتها حينما عملت سلطةُ البعث على إعادة الروح لِلقوى التقليدية التي كانت في طور الكمون، إذ حطّم الحصارُ الاقتصاديُ على خلفية غزو الكويت الطبقةَ الوسطى وخيّب آمالَها التدهورُ الاقتصاديُ وفقدان التواصل مع العالَم الخارجي. فعلى سبيل المثال استعادت العشائريةُ بدعم من نظام البعث قوّتَها ونفوذَها الذي حجّمه الإصلاح الزراعي لعام 1959، وأفضت الحملةُ الإيمانية في عام 1996 إلى انتشار التدين الزائف، وتراجع القيم الحداثوية. بيد أن ما حدث بعد 2003 راكم هذا التراجع إلى حدّ كبير، فقد استعادت العشائرية والعلاقات القديمة والخطاب البدائي والسلوكيات غير المتحضرة، استعادت قوّتها ونشاطها، فلم يعد غريباً مشاهدة ما يدل على هذا التقهقر من خلال اللجوء لِلعشيرة وحمل السلاح بدل حكم القانون، وأخذ الثارات كوسيلة للانتقام، وصعود أشخاص يمثّلون مواصفات القبح والرثاثة كمؤثّرين اجتماعيين وفّرت لهم وسائلُ التواصل الاجتماعي طريقاً لنشر رثاثتهم، كحال ما يُطلَق عليهنّ الفاشنستات اللواتي حللن محلّ النساء المبدعات في الآداب والفنون والعلوم، وأمست الطائفيةُ الممزقة لِلمجتمع عملاً محموداً، وغابت روح التسامح وقيم الحداثة بالأفكار المستنيرة إذ حوربت بشدّة من قوى اجتماعية ترى فيها خطراً، وباتت الفوضى واحدة من سمات هذا الزمن، كما أصبح اللجوء لأساليب قديمة في العلاج من الأمراض بدل الطبيب المختص مَظهراً شديد الوضوح، ولم يعد المعلّم بشخصيته التربوية المعتبرة قادراً على مواجهة ردّات أفعال التلاميذ وأهاليهم والاعتداء عليه كقيمة علمية فائقة الأهمية اجتماعياً. وليس هذا إلا أمثلة من واقع فقدان الكثير من قيم الحداثة التي جاهد لنشرها نخبويون عدّوا أنفسَهم كأصحاب رسالة اجتماعية.
السؤال المهم في هذا الصدد: ما العمل لاستعادة هذه القيم الآخذة بالاضمحلال مع وجود من يسعى لِهدمها؟ لا يبدو العمل سهلاً مع هذه الموجة الصاخبة لتمجيد الشعبويات والتفاخر بالتراجع، غير أن الأمر ليس مستحيلاً أيضاً، فإذا سعى المثقفون الحقيقيون في عمل جاد ومنظّم مستعينين بكلّ ما توفّره وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام والصحافة يمكن الحفاظ على البقية الباقية من هذه القيم، ثم العمل لاستعادة دَورها، ويمكن القول بأنَّ المهمةَ صعبة، ونحن نرى الواقع المناقض لِكلّ الجديد والتركيز على المظاهر والشكليات حتّى عند مَن يدّعون انتمائهم لِلثقافة والنخب العِلميّة الذين يلجئون في أحيان كثيرة إلى مسايرة عملية التجهيل والتناغم معها، وحتّى الاستعانة بالروابط الاجتماعية لما قبل الدولة وإدخالها في خلافاتهم وحواراتهم.