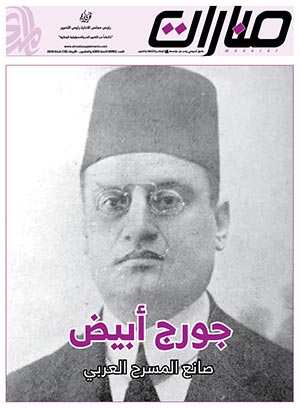د. طلال ناظم الزهيري
لا يختلف اثنان على أن الحافز هو الوقود الذي يشعل طاقة الطلبة ويدفعهم إلى بلوغ قمم التفوق. فقد يمتلك الطالب قدرات ذهنية جيدة، لكنه يظل في دائرة الأداء العادي ما لم يتوافر له دافع داخلي يحفزه على العمل الجاد والمثابرة. وهنا تبرز قضية صناعة الحافز، ليس كعامل طارئ أو هبة عابرة، بل كمنظومة متكاملة يمكن بناؤها ورعايتها.
الحوافز نوعان: داخلي ينبع من رغبة الطالب في إثبات ذاته وتحقيق أهدافه، وخارجي يتمثل في التشجيع والتقدير والمكافآت. والأكثر استدامة هو الداخلي، لأنه يرتبط بقناعة راسخة لدى الطالب بأن العلم سبيله للتميز والنجاح، أو هذا ما تربى عليه. غير أن الحوافز الخارجية تظل ضرورية، خاصة في المراحل المبكرة، إذ تشكل نقطة انطلاق تغذي الحافز الذاتي لاحقًا.
في هذا السياق، تؤدي الأسرة والمعلم الدور الأبرز في بناء الحافز. فالكلمة المشجعة من الوالدين قد تزرع في نفس الطالب ثقة طويلة الأمد، والإشادة من المعلم أمام زملائه قد تكون نقطة تحول في مسيرته الدراسية. إن صناعة الحافز عملية تراكمية تعتمد على التوجيه المستمر والتعزيز الإيجابي، ولا يمكن أن تنمو في بيئة طاردة أو مثبطة. ومن ثم، تبقى المدرسة والجامعة مطالبتين بتوفير مناخ تعليمي محفّز يقوم على التفاعل واحترام الطالب وإتاحة فرص المشاركة والإبداع، إضافة إلى ربط المعرفة بحياة الطالب الواقعية بما يزيد من دافعيته ويمنحه معنى لما يتعلمه.
ومع ذلك، يشهد التعليم الجامعي في العراق في السنوات الأخيرة حالة من التراجع الملحوظ في دوافع الطلبة نحو التحصيل العلمي. ويعود ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها ضعف الارتباط بين الدراسة وسوق العمل، حيث يشعر كثير من الطلبة أن ما يتعلمونه داخل القاعات لا يفتح أمامهم آفاقًا مهنية واضحة، فيفقدون الدافع لمواصلة الجد والاجتهاد. حتى أصبح الطالب الجامعي اليوم أكثر اهتمامًا بالحصول على الشهادة نفسها، بصرف النظر عن مستوى التأهيل أو الكفاءات التي يكتسبها أثناء دراسته، إذ تحولت الشهادة لدى البعض إلى مجرد ورقة عبور اجتماعية أو وسيلة لتحسين الوضع الوظيفي، بينما تراجعت مكانتها كدليل على المعرفة الحقيقية والمهارة العلمية.
كما أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية تؤثر بقوة في هذا الجانب؛ فالطالب الذي ينشغل بتأمين احتياجاته المعيشية قد ينظر إلى الدراسة بوصفها عبئًا إضافيًا لا فرصة للنهوض. وتضاف إلى ذلك البيئة التعليمية التقليدية التي تعتمد على التلقين أكثر من التفاعل، مما يضعف حسّ المبادرة ويجعل الطالب متلقيًا سلبيًا بدل أن يكون مشاركًا فاعلًا في بناء المعرفة. ولا يمكن إغفال أثر الانفتاح الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، إذ انصرف العديد من الطلبة إلى فضاءات بديلة استهلكت وقتهم وطاقتهم، فضعفت علاقتهم بالجامعة وخفّ لديهم الشعور بالانتماء إليها. ونتيجة لذلك، نشأ شعور باللامبالاة تجاه التحصيل العلمي، فلم تعد الدرجات أو الشهادات تمثل لهم قيمة معنوية كبرى رغم حرصهم على الحصول عليها، بل أصبحت وسيلة شكلية لا ترتبط بتحقيق الطموحات الواقعية.
وفي خضم هذا التراجع، يبرز مثال استحداث كليتي "التميز" و"الذكاء الاصطناعي" في العراق. فرغم أن الهدف المعلن هو الارتقاء بمستوى التعليم وتخريج كوادر خبيرة في تخصصات المستقبل، إلا أن التجربة تنطوي على ملامح إعادة إنتاج فجوة تربوية بين هذه الكليات وبقية التخصصات الجامعية. إنها خطوة تذكّرنا بتجربة "جامعة صدام" التي قامت على امتيازات ودعم خاص منحها خصوصية واضحة، لكنها لم تستمر بعد زوال ظروفها. واليوم، يبدو المشهد وكأنه يعاد دون دراسة كافية، حيث تُمنح هذه الكليات هالة خاصة بينما يعاني معظم طلبة الجامعات الأخرى من ضعف الحافز واللامبالاة. وقد يسهل على البعض أن يتصور أن مجرد استحداث هذه الكليات كفيل بانتشال الواقع الجامعي المتراجع والارتقاء به، غير أن الحقيقة أعمق بكثير؛ فبناء كوادر مؤهلة لا يتحقق بإنشاء مؤسسات جديدة فقط، بل يتطلب إصلاحًا شاملًا للبنية التعليمية وإعادة الاعتبار لقيمة الشهادة والجدية في التحصيل.
إن تجاوز أزمة الحافز لدى الطلبة الجامعيين يتطلب إصلاحًا متعدد الأبعاد يتكامل فيه الجانب التعليمي مع الاجتماعي والاقتصادي. فإعادة ربط الدراسة بسوق العمل من خلال تطوير المناهج وتوجيه التخصصات نحو حاجات المجتمع والمؤسسات الاقتصادية تمثل الخطوة الأولى، إذ تمنح الطالب قناعة بأن جهده الدراسي سيترجم إلى فرص حقيقية. كما أن تعزيز التعلم العملي والمهاري عبر التدريب الميداني والمشاريع التطبيقية والعمل التطوعي المرتبط بالتخصص يرسخ الثقة بقدرات الطلبة ويدفعهم للاستمرار.
وفي السياق ذاته، ينبغي تحفيز بيئة التفاعل داخل الجامعات من خلال استبدال أسلوب التلقين بطرائق تعليمية تقوم على الحوار والنقاش وحل المشكلات، بما يشجع التفكير النقدي والإبداع. ولا يقل عن ذلك أهمية إشاعة ثقافة التقدير والاعتراف بجهود الطلبة، سواء بكلمات الدعم أو الامتيازات، بما يعزز الشعور بالجدوى من بذل الجهد. كما أن إعادة الاعتبار للشهادة الجامعية لا بوصفها وثيقة شكلية، بل مرآة للمعرفة الحقيقية والمهارات المكتسبة يمثل عنصرًا محوريًا في إعادة بناء الثقة بالتحصيل العلمي. وإلى جانب ذلك، يمكن توظيف التكنولوجيا والمنصات الرقمية كأدوات مساندة لتعزيز التفاعل والاهتمام بدل أن تكون مجرد وسائل لتشتيت الانتباه وإضعاف الحافز.
إن إعادة بناء ثقافة الحافز لدى الطلبة الجامعيين ليست مهمة فردية، بل مسؤولية مجتمعية ومؤسسية مشتركة. ومن هذا المنطلق، على صناع القرار في المؤسسات التعليمية والجامعات النظر بعين الاعتبار إلى إصلاح البنية التعليمية وإعادة هيكلة المناهج وربطها بواقع سوق العمل، إضافة إلى تعزيز بيئة تفاعلية تشجع التفكير النقدي والإبداع، وتوفير دعم حقيقي للكوادر التعليمية والطلبة على حد سواء، وتقدير جهودهم بشكل مستمر. إن الاستثمار في صناعة الحافز هو استثمار في مستقبل الأجيال وفي جودة التعليم ذاته، فكل جهد يبذل اليوم لبناء بيئة تعليمية محفّزة وفعالة هو خطوة نحو تخريج جيل قادر على الإبداع والتميز وتحمل المسؤولية، جيل يرى في العلم فرصة للنمو والتطوير، وليس مجرد وسيلة للورقة أو الدرجة، وبذلك يصبح الحافز الجامعي حجر الزاوية في بناء مجتمع معرفي قوي قادر على مواجهة تحديات المستقبل بكفاءة وثقة.