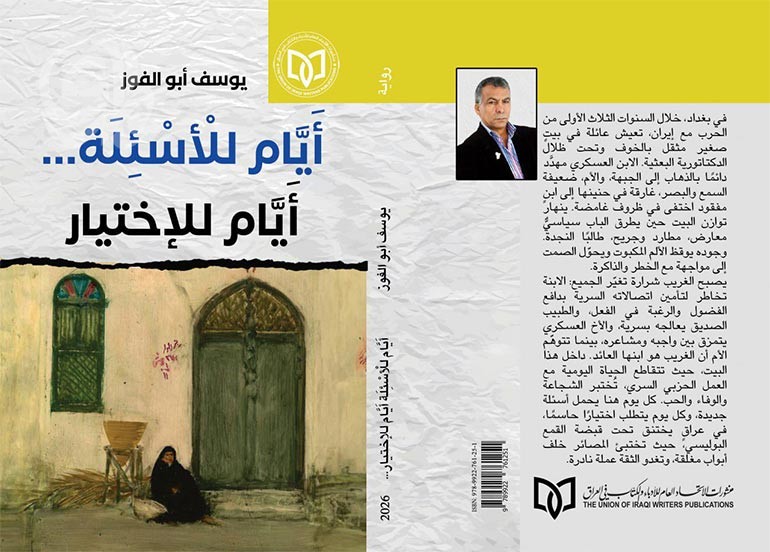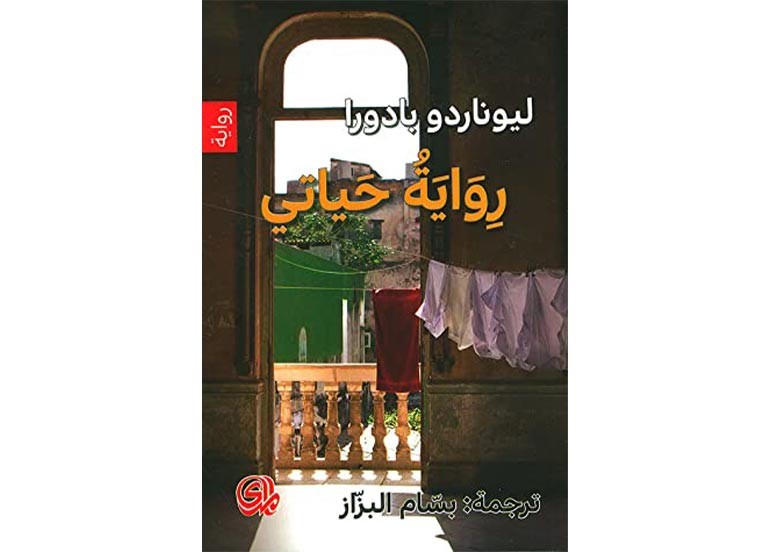د. نادية هناوي
تمركز القارئ في الطروحات ما بعد البنيوية، فانزاح الاعتداد بالسياق وأُميت المؤلف حتى صارا ثانويين يقبعان بعيدًا عن الواجهة النقدية. وساهمت نظريات أُخر في تعزيز هيمنة القارئ مقابل هضم حقوق المؤلف بكل ما يعنيه الهضم من بتر الجذور واستئصال المرجعيات والتقليل من أهمية السير على تقاليد أدبية كانت قد انتقلت وأدت دورا في نمو الآداب التي هاجرت إليها.
ومن النظريات التي بها يسوغ النقاد الغربيون بتر الجذور وتناسي أمر المؤلف وتقاليد الأدب، نظرية هارولد بلوم حول قتل الأبناء لآبائهم الأدبيين أو نظرية لايكوف وجونسن حول الاستعارات التي لا نحيا من دونها. بمعنى أن لا فضل للمؤلف في إنتاج نص هو عبارة عن استعارة مركبة من ثلاثة عناصر هي : 1/ الأفكار او المعاني 2/ التعابير أو الأوعية 3/ التواصل أو الارسال. وبهذا لا يكون للاستعارة أي أصل تدل عليه، فهي مجموعة دلالات لا تخضع لتاريخ أو سياق، لأنها غير مقصورة على الأدب، بل تشمل جوانب الحياة اليومية كافة. والسلوك نفسه ذو طبيعة استعارية بالأساس. وما من فكر بشري الا والسيرورة الاستعارية تؤلف جزءا كبيرا منه.
بهذا التفسير، لا يعود مع الاستعارة أصل سابق يمكن البحث عنه كما لا مؤلف يمكن له أن يبتدع جديدا أو يطالب بالسبق في ما هو أصيل. وإذا ما حصلت منافسة حول هذا الأصيل، فإنها في نظر لايكوف وجونسن لا تعدو أن تكون صراع حيوانات ناطقة. ومن حسنات هذا الصراع( أننا قد نحصل على ما نريد من دون اللجوء إلى صراع مادي حقيقي). وتذكرنا نظرية الاستعارات هذه بنظرية بلبلة الألسن وجدل الكتابة عند جاك دريدا، فهي تصبُّ في الإطار نفسه المتمثل بنسف الأصول، حتى أن أي تنقيب عنها هو ضربٌ من التهويم وبحث في السراب. فرولان بارت نظر إلى المؤلف بوصفه لحظة كتابة، ورأى ميشيل فوكو أن لا أهمية للمؤلف إلا عندما تتدخل الدولة أو السلطات العقابية كما لا علاقة بين النص ومؤلفه، إذ( أن لا شيء يوجد خارج النص) وأن الواقع نفسه هو بناء لغوي ونصي خالص كما يذهب الى ذلك جاك دريدا.
ولقد نالت نظريات الحوارية والتناص والمعتمد الأدبي والاستعارة الحية والنص الجامع وغيرها، اهتماما كبيرا من لدن نقاد الأدب العربي الذي فيه من الأصول، ما يستدعي تأكيد فاعلية المؤلف وليس العكس لأن في هذه الفاعلية ما يبرهن بشكل قاطع على ما لتاريخ الأدب العربي من حيازة للتقاليد والأصول التي تحفر بأبعادها عميقا الى ما قبل عشرة قرون. بيد أن الحاصل هو اكتفاء الناقد العربي بأداء دور التابع الذي يغالب في استجلاب النظريات الغربية لأنه يراها مثالا للجدة والأصالة والصحة فيتسابق من ثم في تطبيقها على الإرث الأدبي والفكري ونصوص الأدب الحديث.
ولقد تنبه عبد الفتاح كيليطو في كتبه الأخيرة - ومنها كتابه( جدل اللغات) - إلى هذه الظاهرة، فناقش مثالب تبعية النقد العربي للنقد الغربي. ومن ذلك مسألة هجرة الأصول، وابتدأ في البحث عنها من آدم، و( كل تساؤل عن لسان آدم يهدف بالطبع إلى تحديد الأصل والتعرف على اللسان الواحد والوحيد الذي كان في الأصل). ورفض كيليطو فكرة بلبلة الألسن، لأن ثمة لسانا أصيلا هو موجود وحاضر من ناحيتي اللغة ونطق الأصوات. ويتمثل هذا اللسان الأصيل بالإمبراطورية العربية – على حد تعبير كيليطو- التي أعادت إلى برج بابل وحدته. إذ استطاعت ( بفضل الدين الجديد من إصلاح كارثة بابل، فحلَّ الاجتماع محل التفرقة، وعُثر من جديد رغم التباين اللساني على الوحدة الأصلية ما قبل البابلية). ورأى أن للقرآن المنزَّل بالعربية أثره المهم في أن يميل العرب ميلا قويا إلى استخلاص تفوق لسانهم. ولذلك لم يكترثوا بالترجمة، لأن( البشر الذين كانوا في البداية يتكلمون جميع الألسن لم يعودوا يتكلمون إلا لسانا وحيدا لكنه مختلف من قوم إلى قوم). وتأسف كيليطو على أولئك الذين يعلون من شأن الترجمة، ويتمنون أن لو قرأ العرب جيدا منذ البداية كتاب أرسطو( فن الشعر) لكان مظهر أدبهم وربما حضارتهم مختلفا. وعلق بالقول: (أي نفهم أنه سيكون يونانيا. والحال أن مثل هذا القول ليس فحسب مجانيا، بل هو أيضا غير لائق بل أشبه بقتل الأسلاف. إنه يجرد الإنتاج الثقافي العربي من قيمته، فيعتبره ضمنيا معيبا ناقصا لا مجديا. إنه يجحد بلا قيد ولا شرط عشرة قرون من الأدب العربي.).
إن هذا التفوق الذي كان عليه اللسان العربي، جعل للكتب والمؤلفين والتاريخ أهمية وفاعلية. ومن ثم لا إغارة على كتاب ولا اغتصاب لحق مؤلف، لأن ذاك يقع في باب السرقة وإفساد ذهن القارئ.
وبهذا كله غدت كتب الأدب العربي نماذج، فيها نجد المتراكم من المرجعيات وما تمخض عنها من أصول وتقاليد. ولقد خضعت نماذج التراث الأدبي الكلاسيكي في العصور الوسطى للأقلمة فأنتجت نماذج جديدة فاعلة، خذ مثلا أقلمة الحريري لمقامات الهمذاني أو أقلمة النقاد المغاربة لكتب الأدب العربي التي ألَّفها المشارقة. ولكن هذه النماذج تنوسيت في العصر الحديث بعد أن صار يُنظر إليها بجمود وبرود بوصفها لا تماشي العصر الذي صار لا يجد نماذجه إلا في الأدب الأوروبي. وإذا كان لكتاب حكايات ألف ليلة وليلة أن يجتاز حدود العالم العربي ويكتسب قيمة عالمية بدون جدال، فليس لأنه نموذجي، بل لأنه ليس كتابا عربيا وإن اكتسب طابعا إسلاميا وسمي بالليالي العربية.
لقد أدى الاتباع لنماذج الأدب الأوروبي إلى تناسي النماذج العربية وما فيها من أصول وما لها في تاريخنا الأدبي من تقاليد. وهو أمر متوقع في خضم هيمنة الفكر الاستعماري، فغدا العربي ينظر إلى ذاته وأدبه وتاريخه بكثير من القصور والدونية في مقابل نظرة الإعجاب والاعتداد بالأدب الأوروبي الكلاسيكي منه والمعاصر بوصفه نموذجيا وله أصول، وأن من جراء التأثر به نهض أدبنا العربي وعرف الجديد والأصيل!!.
هذه مفارقة كبرى من مفارقات فبركة التاريخ الأدبي، فصار صاحب الأصول هو التابع في حين غدا من هو تابع أصيلا ونموذجيا!!. وما من تصحيح لمغالطات التاريخ الأدبي إلا باستعادة المؤلف لدوره وبكل ما له من ملكية. وفي مقابل هذا، نفهم لمَ واظب النقد الغربي على تجريد المؤلف من دوره والتقليل من أهمية فاعليته، كي لا يكون ذلك طريقا الى البحث عن النماذج الأصلية أو البدئية التي بها تتأكد أهمية المصادر والدور التاريخي للترجمة في انتقال التقاليد الأدبية.
ومن يعد إلى بدايات النقد الأوروبي الحديث فسيجد أمثلة كثيرة على ذلك، منها مثلا اعتبار ثرفانتس مبتكرا وأن كتابه( دون كيخوته) نموذج أصلي مع أن ثرفانتس نفسه ينص على أنه أقلم في كتابه هذا نموذجا أصيلا هو مخطوط سيدي حامد بن الأيلي. والمسافة الابداعية لا شك كبيرة بين كِتاب هو أصل، وآخر هو مؤقلم، ومن خلال هذه المسافة تتضح فاعلية المؤلف التي عنها تغاضت المنظومة النقدية الغربية، فتشوشت الأنساق بعد أن اختلطت عوامل النقل والتحوير ومُوهت الحقائق وفُبركت، لكن من حسنات فاعلية المؤلف أنه وإن غاب على مستوى الفكر النظري، فإن حضوره على مستوى النقد الإجرائي مؤكد؛ أولا باسمه الذي يأتي معاضدا العتبة العنوانية لعمله، وثانيا بصوته الذي يظهر بشكل مباشر باستعمال ضميري المتكلم أو المخاطب أو هو ظاهر بشكل غير مباشر من خلال سارد ذاتي أو موضوعي ينوب عنه. وثالثا بجينالوجيا الثقافة التي هي خزان الذاكرة الأدبية الواعية واللاواعية الفردية والجمعية، وفيها تحفظ شفرات الأنساق ومسارات السياقات، وجميعها تمت بصلة وثيقة إلى المؤلف.
نظريات سوغت بتر جذور الأدب

نشر في: 15 سبتمبر, 2025: 12:04 ص