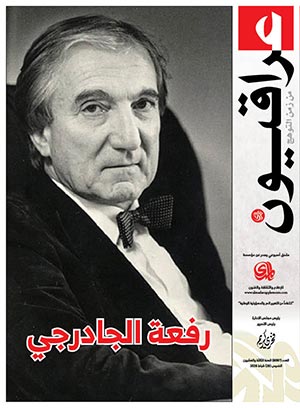طالب عبد العزيز
في الأول من يناير- كانون أول 2026 ستكون تمارا أفاكيان، الصبيَّةُ الجميلةُ التي رقصت على أنغام (قدك المياس يا عمري) في حفل (جار القمر) قد بلغت سنتها الخمسين. عارضةُ الأزياء، والإعلامية، والراقصة التي مازلنا نقتفي بأخيلتنا خطواتها؛ وهي ترقص على مكعبات شطرنج مسرح صباح فخري، في الحفل الاجمل، الذي مازلنا نشاهده في كلِّ محاولة منّا لاستعادة الكِسرِ المفقودة من فَخَارِ أعمارنا.
لم ترقص تمارا في السهرة تلك على أنغام صباح فخري لتُخلِّد أغنياتِه حسب، أو لتطبعها بصورتها الفاتنة، ولم تبق الساعاتُ حبيسة الزمن، أو لتجمد فيه، بل، ظلت ترقصُ لنا، إذْ كلُّ نظرةٍ وابتسامة كانت لنا، وكلُّ ذبذبة في الاثير الرطب ذاك كانت تقصدنا، نحن الذين ما زلنا نبحث في زمن وقوفها وتهدجها على رقعة الشطرنج عن أزمنتنا، وفي حركاتها عن ماظلَّ من لين في اجسادنا. نحن؛ الى اليوم نفتشُ عمّا يشبهها في ماضي أيامنا المفقودة، ونلجأ لطفولتها في كلِّ لحظة غادرة، نظلُّ مستسلمين للعينين والقدمين واليدين والخصرين وهي تستفزُّ كلَّ حركةٍ مبهمةٍ في معجم الجمال. تمارا أفاكيان، اللبنانية الارمنية، المتزوجة من ملك جمال لبنان ستيف باسمادجيان، بتنورة سوداء قصيرة وقميص منزوع الاكمام وبتراتيل جسد لا يفكُّ طلاسمها إلا الذين سهروا الليلة تلك؛ ومازالوا يسهرون، ورقصوا ومازالوا يرقصون، ورفعوا كؤوسهم ومازالوا يرفعون؛ ويرفعون ولا يحزنون، أولئك الذين علقوا في القدود، مازال الليلُ يمضي بهم حاسراً من كلِّ يأسٍ وعتمة.
الطاولاتُ بالشراشفِ الحُمر، وبكؤوس النبيذِ المُصرّحِ بها والمموهةِ بالعصائر وخلاصات الضوء، مع المنحوتة الزنجية؛ التي تظهرخلف المغني دائماً، فلا تتوقفُ عندها الكاميرا، أمام باقات الورد التي تزينُ الصورة التلفزيونية، هناك من يتظافرُ على صناعة شيءٍ ما. الراقصة التي تميلُ على كتف المغني كلما ألهبتْ الكمنجاتُ جمهورَ الصالة، بالكاد تمسكه المقاعد، أمّا تمارا التي أرهقتها الاغنية من دقائق؛ فقد أخذت مجلسها، بعيداً، ثمةَ ما يرهقُ، لكنها لم تمكث فيه طويلاً. كانت الاغنيةُ تتوحشُ في الجسد الانثوي، تطلبه، وصباح فخري ما زال يمسك بفضاء الحفل، يعيدُ ويعيدُ (أنا وحبيبي في جنينة)مع أنَّ وردَ الاغنية لم يخيِّمْ علينا، نحن الذين مازالت كؤوسنا تمتلئ وتفرغُ كلما صرنا أقرب الى الفجر، في البلاد التي تستباحُ، وفي الزمن الذي لم يعد.
لكلِّ أغنيةٍ رقصةٌ، ولكلِّ شجنٍ قصيدةٌ وكتاب، ولكلِّ نأمةٍ في الجسد مصباحٌ بزيت قليل، لكنه لا ينفد، فإلى أين يمضي هذا الليل الذي لا آخر له، وأنّى لهذه الروح أنْ تهدأ بأغنية واحدة، فلا يُغضبها كمانٌ يشذُّ وينشِّزُ وهذه التي بحذائها الرياضيِّ، وبسروالها الفيزون الاسود، حيث لا تحْتجبُ نقرةُ البطن طويلاً، وتتلقفها الكمنجات حالَ ظهروها، التي أبدلها المخرجُ بتمارا أفاكيان، الصبيةُ التي لم تعد من رقتصها الأولى بعد، وظلت مكعباتُ الشطرنجِ طريقَها الى حذائها الرياضيُّ، أخذت الأرضَ الى أرض أخرى، فنتيقنُ من أنَّ كلَّ حركةٍ محسوبة بعنايةٍ في الجسد الانثوي؛ المغمور بالضوء، وها هي تروّضُ النسورَ التي تركضُ بأجسادنا. نبصرُ شقَّ قميصها فلا يطلع قمرٌ من هناك، ولا نتهمُ أحداً بدمشق، وصباح فخري معنيٌّ بترتيب الألوان في صوته، والصبيّةُ تميل بحُزمِ شعرها عليه، تحاول أنْ تبلغ جمال الاغنية؛ فلا يعجزها شيءٌ، هي الآن تفصحُ عمّا يجبُ أنْ نقوله لأخيلتنا، تذرعُ الصالةَ؛ فتطيرُ نسورُ أجسادنا، الى هناك، الى حيث تتلقفنا الشائعات.
الثوب الاسودُ المنقّطُ بالابيض، أو الأبيضُ المنقّطُ بالاسود لا يريدُ أنْ يسترُ الصدرَ، تجاهدُ؛ تخفي ليونته؛ الصبيّةُ الراقصةُ بتنورتها الفيزون وحذائها الرياضي تعيد ترتيب الكمنجات، ومن طاولته بشرشفها الأحمر، يومئُ أحدُ الحاضرين، يريدُ خطىً أبطأ؛ جسداً أقلَّ تهدجاً، لكنَّها تظلُّ تذرعُ المكان، ذا الطول والعرض، وليس ثمة من مدىً وأمدٍ لمكعبات الشطرنج، فالصالة تسيرُ بنا؛ وتسبحُ به؛ وتمتدُّ بها؛ وتتسعُ بهم؛ ثم تعود فتميدُ بنا، تميد بنا، أجمعين، نحنُ الذين لم نقف على رقم بعينه؛ أبيضَ أو أسودَ في تنورتها التي ما زالت نطالعها في ما نقتطعُ من آمال.