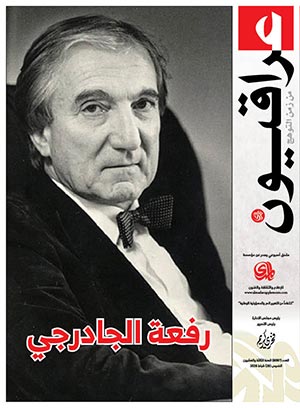طالب عبد العزيز
يحلُّ الليلُ في العشَّار باكراً، ويغادرُ تجّارُ التجرئة السوقَ؛ من بوابته التي على ساحة أمِّ البروم، ومن هناك، يدخلُ الغجرُ الليلَ، يدخلون العشارَ، الرجالُ حسب، أما نساؤهم ففي المهاجع المظلمة، تحت المراوح؛ ينعمن بالنوم مع أطفالهن. ما كنتُ أحسبُ ذلك يحدثُ لو لم يكشف حمزة العبدالله، صاحب مكتبة الصحراء عن ذلك، في حديثه المستقطع؛ من ليلتنا تلك، حيث أخذني صحبة أصدقاء آخرين، ممن يحبّون اكتشاف المدينة؛ بعد مغادرة تجّارها، وصباغي أحذية المتعجلين، وعتّالي سوق الجملة، ووقوف رجال الشرطة يقظين قرب سوق الذهب.
ليس الغجرُ وحدهم من يدخل؛ السوريون المشرّدون من حروب الطوائف أيضاً، الذين يبيعون المُكسّرات في الساحة، وعند كشك ظاهر حبيب، بائع(طريق الشعب)الذي مات بالقصف، في حرب الثمانينات، وفي النهاية المربكة لسوق المغايز أيضاً، حيث تطاردهم البلدية دائماً. هذه المدينة تنفلتُ ليلاً، بقليل من الوقائع، لكنْ بكثير من الهدوء. في المطعم، حيث يقدِّم صاحبُه البيضَ المقليَّ بالطماطم والخُضار آخر الليل، كنتُ قد تركتُ هاتفي الآيفون على الطاولة، لكنني حين هممتُ بأخذه، وأنا آخذٌ طريقي الى المغسلة؛ تنبسم الغجريُّ الذي يشاركننا الطاولة في وجبة العشاء المتأخرة تلك، قائلاً: “دعه، لا أحد سيسرقه هنا!!!” لكنني سلكته في جيب السروال الجيينز، قبل أنْ تخطفَ صورةُ الغجريِّ التي أحتفظ بها في رأسي.
في البدء لم أتنبه الى أنَّ هؤلاء هم أقوام من غير البصريين، كنتُ أعتقد بأنَّهم من نزلاء فنادق الدرجة الثالثة أو الرابعة، الذين يخذلهم نهارُ الخريف القصير، فيحطُّون رحالهم قرب شبه جزيرة الداكير، وسط العشّار، وفي سوق الهرج، أو سوق الحبال التي خلف جامع المقام، أولئك المساكين القادمين من القصبات البعيدة(الفاو، القرنة، المْدَينَة، السيبة، أم قصر، وخور الزبير)المتبقين من سبعينات وثمانينات القرن الماضي، الذين يبطئون الخطى؛ فيدركهم الليل، ثم حين لا يجدون مركبةً تقلّهم الى قصباتهم تلك ستكون الفنادقُ قد أغلقت أبوابها.
هؤلاء؛ وبثياب السفر المقتصدَة، وبالهيئات الفقيرة تلك، كنت كثيراً ما أصادفهم في طريق عودتي من القاعدة البحرية ومن الحرب بعد ذلك، وقد لفظتهم المقاهي والمطاعم والافران، ومخازن الحبوب، والحمّامات الشعبية، أولئك؛ الذين لا يُحسنون صبغ أحذيتهم، واختيار المفازات، الذين أدمنوا الدوران حول المدينة، غير خائفين من كلابها، وقططها المسعورة، وجرذان نهرها القديم، المتلصصين على مسوّدات ماضيها الغابر وقراطيسها، الذين يجدون في الليل فسحتهم القصيرة، بعد نهار مكدود وطويل.
يخايلنا التأريخُ أحياناً، فنحسنُ الظنَّ بالأزمنة والوجوه والمسافات، وتنبسطُ الشوارعُ، والاسواقُ، والازقَّة أمامنا؛ فلا نعود لسؤال الليل إلا بسؤال النَّهار، فيما المدينة تتقلبُ، وتتسعُ، وتنكمشُ، أو تضمرُ في أكثر من ليل، وأكثر من نهار، حيث لا يكفي قولُ، ولا تصمدُ حجَّةٌ. ظلَّ صاحبُ المطعم يحدّثنا عن ليل العشار الطويل، وعن أعداد الغجر في سككه وفنادقه، الذين تجوبُ قوافلُهم السوقَ، وعن باعة المكسَّرات السوريين، وعن الشرطة وهي تحتجزُ متشاجرَين، أو تدهمُ شقّةً، أو تحاصرُ منزلاً، ثم سألناه ما إذا ستظلُّ النسوّةُ أسيرات المخادع حتى الشمس، وعن أطفالهنَّ المُتوهَمِين، متحقّقين من حديث أمهاتنا البليد القديم، عن ما إذا كانت النساءُ الغجرياتُ مازلنَّ يسرقنَ أو يخنقنَّ الأطفال، وما إذا استبدل الغجرُ الرجالُ عرباتِهم التي تجرها الخيول بالمركبات؟ هكذا، كما لو أننا نوقف الزمن على صورتهم التي في الصفحة الأولى من رواية ماركيز، حيث اعلن الغجري ملكيادس عن مخترعه المغناطيسي؛ ثم وهو يجرُّ وراءه سبيكتين من معدن، يوم ذُهل الناسُ خوفاً، حين راوا القدور والمدافئ والكمّاشاتِ والمناقلِ وووو تتساقط من امكنتها وتتلقفها آلتُه العجيبة.. لكنَّ صاحب المطعم ظلَّ يسخِّفُ اسئلتنا؛ بأحاديثَ وقصص لا خرافة فيها ولا نهاياتٍ لها، أحاديث وقصص فيها من الكثير من الليل والغناء والجنس والسهر والقبل والحبوب المخدرة والدولارات.