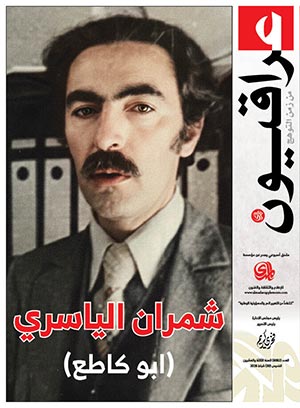طالب عبد العزيز
يفتتح خوان خوسيه مياس روايته (قصتي الشخصية) بعبارة أنا هذا الكائن الذي كانت تقول له أمُّه :" لا تصرخْ بابا يقرأ. لا تركضْ في الممر. با با يقرأ، اخفضْ صوت التلفزيون. بابا يقرأ، بابا، وبابا لم يكن يفعل شيئاً سوى القراءة" توقفنا بعضُ العبارات التي نطالعها في الشعر والروايات والكتب الاخرى على حقيقة موجعة؛ ألا وهي أنَّ نسبةً كبيرة من جماعة(المثقفين) وحتى خمسينات القرن الماضي، إنما انحدروا من أصول فلاحية، أوعمالية، أو من طبقة صغار التُّجار، الذين ليس في بيوتهم كتاب واحد، اللهم إلا المصحف، لذا، أجدُ أنَّ النخب المثقفة في شرقنا العربي-الإسلامي حديثة العهد بالقراءة والكتاب والبحث، بل وفكرة المكتبة في بيوتنا ولدت متأخرة جداً.
حتى عهد ليس بالبعيد كانت الكتاتيب مصادر الجيل الأول من الشعراء والكتاب، وهي محدودة جداً، إذْ قلما يفكر الفلاح بأخذ ابنه الى حلقات الدرس ذاك، لأنَّ وجوده في الأرض فلاحاً أهمُّ من وجوده هناك، مع أبناء طبقة الملاكين، لذا، نجدُ أنَّ غالبية شعرائنا وكتابنا أسسوا لأنفسهم تأريخهم القرائي، وأنشأوا لأنفسهم المكتبات، وواصلوا تعليمهم، وأصروا على أن يدخلوا عالم الكتابة والتأليف،بجهد يكاد يكون فردياً خالصاً، ولو فحصنا عمر المعرفة الحقيقية في اوطاننا؛ أو الانتقال من التلقين الى التحديث والفهم لوجدنا أنَّها لا تتجاوز ثلاثة ارباع القرن، إذا ما حسبنا بأنَّ التحديث اقترن بقصيدة الشعر الحر عند السياب ونازك والبياتي وبلند ورهط عبد الملك نوري وجماعة جواد سليم، وهو عمر قصير بالقياس الى ما نقرأه في سير شعراء وكتاب العالم في اوربا وأمريكا على سبيل المثال.
وتوقفنا مقاطع الصور الفيلمية التي صورها المستعمر البريطاني؛ عند دخوله المدن العراقية عن حياة وحركة الناس في البصرة وبغداد وغيرها، التي يبدو فيها غالبية مستعملي الطرق حفاة، وبثياب رثةٍ، لا أثر فيها للنعمة، وهم يعبرون الجسور الهالكة، أو يحملون الصناديق في الأسواق، التي بدت هي الأخرى متخلفة، وكما لو أنها تعود الى عصور الجاهلية. لا شكَّ أننا جميعاً، أجيال الاربعينات والخمسينات أبناء هؤلاء، الذين ولدوا قبل أو حوالي العام 1916 الذين لم تكن المعرفة شاغلهم الرئيس، فالخبز يومئذ أكثر وجوباً من القراءة والكتابة، بناء على التركة الثقيلة التي خلفها العثمانيون. حتى العام 1921 كان الملك فيصل الأول لا يجدُ في عرشه أهميةً، لأنه توِّجَ على شعبٍ لا علاقة له بما أحدثته الثورة الصناعية والنهضة الثقافية في اوربا من منقلب حياتي، لذا، كان يجد صعوبةً بالغةً في تأسيس الطواقم الوظيفية الأولى في وزارته، وجلهم مما ورثه عن شكل الدولة العثمانية.
تحيلنا أوضاع البلاد تلك الى شكوك كبيرة تكتنف صحة الاحاديث النبوية التي كانت معْتمدَ المعرفة عند آبائنا وأجدادنا، ولا نجد صواباً في الحديث الذي يقول:" خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه" ففيه إبعاد عن العلوم، وحصر العلم بالمصحف قضية لا تعقل، فالعلم مفردة تتسع وتشمل العلوم الأخرى، التي هي قوام حياة الانسان ومصدر التحولات والتطور، ولعل أسوأ ما كان سائداً، هي جملة ابن تيمية، التي وأدت العلم والفكر والفلسفة، وجعلت من مستعملها ضرباً من ضروب التزندق، والتهرطق، حيث كان يقول:"من تفلسف فقد تمنطق، ومن تمنطق تزندق"، وهكذا أضحى كلُّ متفلسفٍ شيطاناً، مبيناً، يُوسوس للناس، ويحرّضهم على المروق والزَيغ عن الدين.
هل نقول بأنَّ التصورَ القاصر للحياة عند رجال الدين في فَهْم واستعمال العلم والفلسفة والثقافة كان السبب في تأخرنا علمياً وثقافياً؟ أم نقول بأنَّ ستة قرون من الحكم العثماني المتخلف كانت وراء ذلك؟ أم نقول بأننا أمّةٌ ما زالت ترى في هؤلاء (العلماء)على اختلاف مللهم ونحلهم ومذاهبهم المنجّى الوحيد من النار ؟ أسئلة كهذه قد تكون صادمةً للبعض، لكنَّ الحقيقة تقول بأنَّ قروناً طويلة ما زالت تفصلنا عن اللحاق بالعالم المتاح جداً، فنحن أجيالٌ لم يقرأ آباؤهم شيئاً، ذا أهميةً ، ولا نملك في التاريخ المعرفي بعداً وعمقاً، وغالب ما نتداوله من (علوم) يعود الى القرون البعيدة تلك، وما نحنُ في ثقافتنا إلا عيال على غيرنا.