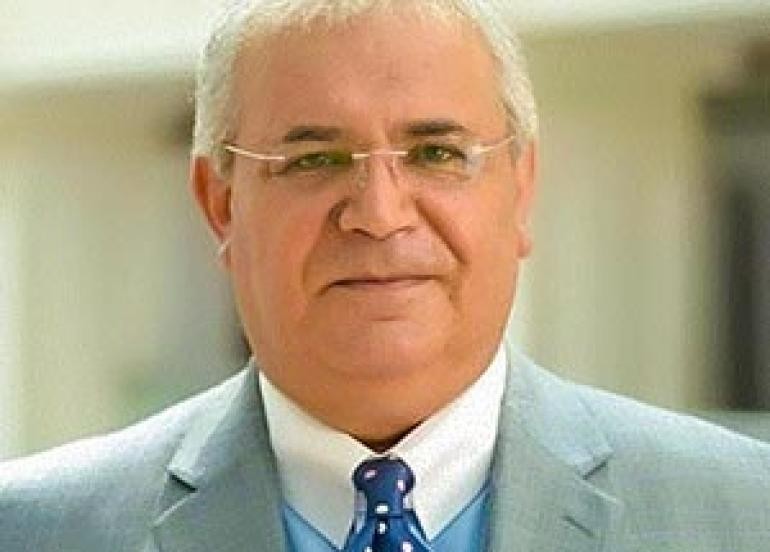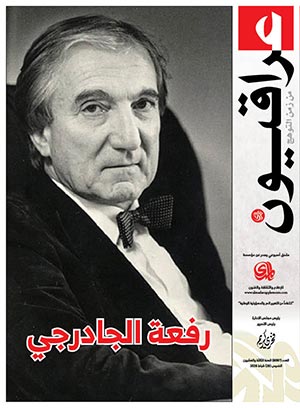إسماعيل نوري الربيعي
أضحى الحديث عن السياسة في العراق، مشتبكًا إلى حدٍّ بعيد مع مفهوم الزبائنية السياسية. تلك العلاقة التي تَشُدّ المواطن والسياسي في شبكةٍ من التبادلات غير المتكافئة، حيث تُقدَّم المنافع مقابل الولاء، وتُوزَّع الفرص بوصفها غنائم سياسية لا حقوقًا مدنية. هذا النمط من العلاقات ليس جديدًا في التاريخ السياسي، لكن تفكيكه النظري وقراءته في ضوء المشهد العراقي الراهن يُظهر عمق الأزمة البنيوية التي تعصف بالدولة الحديثة، ويكشف كيف تحولت الزبائنية إلى ثقافةٍ حاكمة أكثر من كونها مجرد ممارسة عابرة. يتأسس فهم الزبائنية السياسية على مجموعة من المقاربات التي صاغها عدد من المنظرين في علم السياسة المقارن. فـ»هربرت كيتشلت» يرى أن العلاقة الزبائنية ليست نقيضًا للديمقراطية فحسب، بل هي واحدة من آليات الربط بين السياسيين والمواطنين. فبدلاً من البرامج والسياسات العامة، يعتمد السياسيون في الأنظمة الضعيفة على توزيع المنافع الفردية؛ وظائف، إعفاءات، منح، مساعدات؛ لبناء قاعدة انتخابية مستقرة. في تحليله، تمثّل الزبائنية استراتيجية ارتباطية تعوّض عن غياب البرامج المؤسسية والهوية الحزبية المتماسكة. أما «جوناثان هوبكن» فقد وسّع الأفق المفاهيمي حين رأى في الزبائنية شكلًا من أشكال التبادل السياسي داخل الديمقراطيات نفسها، فهي ليست قاصرة على الأنظمة السلطوية أو التقليدية، بل قد تُمارس في الديمقراطيات الانتخابية التي تنقصها العدالة الاجتماعية وتغيب عنها الشفافية المؤسسية. الزبائنية، عنده، هي اختزال للسياسة في معادلة «خذ وامنح»، حيث يتحول المواطن من فاعلٍ سياسي إلى متلقٍ للمكرمة.
وفي مساهمته الكلاسيكية، قدّم «آلن هيكن» قراءة كمية وتحليلية تُظهر كيف تتغذّى الزبائنية على ثلاثة عناصر أساسية: "الفقر، ضعف المؤسسات، وقوة الشبكات الاجتماعية المحلية». إذ كلما ازداد الفقر، أصبح المواطن أكثر قابلية للتأثير عبر المنفعة المباشرة، وكلما ضعفت المؤسسات زادت قدرة النخب على التحكّم بتوزيع الموارد، فتصبح السياسة حلبة للمقايضة لا للمنافسة. من جهة أخرى، فسّر «جيمس روبنسون» و»تيري فيردييه» الزبائنية باعتبارها خيارًا عقلانيًا في اقتصاد سياسي غير متكافئ، حيث تُفضّل النخب توزيع المنافع الخاصة لضمان الولاء بدلاً من بناء مؤسسات عامة شاملة. فالنظام الزبائني في رأيهما، ليس انحرافًا عَرَضيًا، بل هو أداة هيمنة تحافظ من خلالها النخب على توازن القوة في مجتمعاتٍ تتسم بعدم المساواة. أما «كورشات جنار» فقد ركّز على البنية الهرمية للزبائنية بوصفها منظومة تقوم على الانتقائية والعلاقات الشخصية، إذ تُمنح المنافع على أساس القرب من مركز القوة، لا على أساس المواطنة أو الكفاءة. هذه المقاربات مجتمعة تسمح لنا بتكوين خريطة فكرية لفهم كيف تتغلغل الزبائنية في النظم السياسية، وكيف تتحول من ممارسة إلى ثقافة، ومن علاقة فردية إلى بنية مؤسسية كاملة.
الزبائنية السياسية في العراق: من الدولة إلى الشبكة
عند تطبيق هذه الرؤى النظرية على الواقع العراقي، نجد أن الزبائنية لم تَعد مجرد عرضٍ جانبي للفساد، بل أصبحت نمطًا مهيمنًا في تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع. فمنذ عام 2003، أُعيد بناء النظام السياسي على أسس محاصصية وطائفية، سمحت بتشكّل شبكات متداخلة من «الرعاة» و»التوابع»، تتوزع عبر الوزارات والمؤسسات والكتل البرلمانية. إن فكرة كيتشلت عن «استراتيجيات الربط» تجد تطبيقها الكامل في الحالة العراقية. فالأحزاب الحاكمة لا تقدم برامج سياسية واضحة أو رؤى اقتصادية شاملة، بل تَعتمد على تقديم الخدمات الجزئية والوعود الفردية لضمان الولاء الانتخابي. فالمواطن لا ينتخب على أساس الهوية الوطنية أو البرنامج الحكومي، بل على أساس الوعود الشخصية؛ وظيفة في وزارة، قطعة أرض، إعفاء من ضريبة، أو عقد تجاري. يتجلّى هذا النمط بشكل أوضح في الحملات الانتخابية، حيث تتحول الدعاية السياسية إلى مهرجانات للمنح والمساعدات؛ توزيع بطانيات، تبليط شوارع، أو دفع فواتير الكهرباء! وهنا تتجسد الزبائنية بوصفها اقتصادًا سياسيًا للمنافع الصغيرة، يستبدل العقد الاجتماعي بعقدٍ تبادلي محدود الأجل. وإذا أخذنا منظور هيكن، فإن الفقر البنيوي وضعف المؤسسات في العراق يفسران قوة الزبائنية وانتشارها. فالدولة الريعية، التي تعتمد على عائدات النفط، تولّد فائضًا ماليًا غير مرتبط بالإنتاج المجتمعي، ما يجعل النخب السياسية قادرة على توزيع الريع وفق الولاءات بدلاً من الكفاءة. ومع انعدام المساءلة المؤسسية، يتحول المورد العام إلى غنيمة شخصية. أما فرضية روبنسون وفيردييه عن الزبائنية بوصفها «خيارًا عقلانيًا» للنخب، فتنطبق بدقة على دهاليز السياسة العراقية. فالنخب السياسية تفضّل الحفاظ على نظام الولاءات القَبَلية والطائفية بدلاً من إصلاح المؤسسات الذي قد يهدّد امتيازاتها. فكل وزارة تتحول إلى مملكة صغيرة، يُدار ولاؤها من خلال تعيينات وامتيازات وحصص مالية. إنهم يدركون أن مؤسسات قوية وشفافة ستقوّض سلطتهم، لذلك يستمر النظام الزبائني بوصفه أداة بقاء.
الزبائنية كمسرح للتمثيل السياسي
يتخذ التفاعل السياسي في العراق شكل «مسرح زبائني» يقوم على تبادل الأدوار بين الراعي والتابع. فالمواطن الذي يطلب خدمةً من نائب أو مسؤول، لا يفعل ذلك باعتباره صاحب حقّ، بل باعتباره طالب مكرمة. والسياسي الذي يمنحه إياها لا يتصرّف كممثلٍ للمصلحة العامة، بل كفاعلٍ في شبكة تبادلية تُغذّي نفوذه. وفق رؤية هوبكن، هذه العلاقة تُفرغ الديمقراطية من مضمونها، إذ تتحول الانتخابات إلى طقوس تجديدٍ للولاءات، لا للمحاسبة. فبدلاً من أن تكون صناديق الاقتراع وسيلة لتقييم الأداء، تصبح وسيلة لتوزيع الغنائم الجديدة. هذه المفارقة تفسّر لماذا تستمر المشاركة الانتخابية رغم انعدام الثقة؛ لأن المواطن يرى في الاقتراع فرصةً للحصول على نصيبه من الفُتات، لا وسيلةً للتغيير البنيوي. كما أن الزبائنية في العراق لا تقتصر على الأحزاب، بل تتسلل إلى البيروقراطية والاقتصاد المحلي. فالتعيينات في المؤسسات الحكومية تتم غالبًا عبر وساطات حزبية أو عشائرية، والمشاريع الاقتصادية تُمنح وفق القرب السياسي لا عبر التنافسية. وهكذا تصبح الدولة شبكة من المصالح المتقاطعة، حيث تتراجع الكفاءة ويترسّخ الفساد.
التحول من الزبائنية إلى الزبائنية المؤسسية
حين نقرأ الواقع العراقي من منظور كورشات جنار الذي يركّز على البنية الهرمية للزبائنية، نجد أن العلاقة الراعي-التابع قد تحولت إلى منظومة مؤسسية معقدة. فكل حزب سياسي بات يمتلك شبكته من الرعاة: نواب، وزراء، مدراء عامين، ومكاتب اقتصادية. هؤلاء يشكّلون مستويات متعددة من الهرم الزبائني، حيث تنتقل المنافع من القمة إلى القاعدة مقابل الولاء والتعبئة. بهذا المعنى، لم تَعُد الزبائنية مجرّد علاقة فردية، بل أصبحت «نظام حكم» بديل، ينظّم توزيع الموارد والمناصب وفق منطق الولاء لا وفق القانون. إنها دولة موازية تعمل داخل الدولة الرسمية، تمتلك أدواتها المالية والإدارية والإعلامية. إن استمرار هذا النمط يؤدي إلى تفريغ مفهوم الدولة من جوهره القانوني، فبدلاً من أن تكون الدولة ضامنة للمواطنة، تتحول إلى وسيط في شبكة الزبائنية، حيث يمرّ كل شيء عبر الرعاة. لذلك، فإن المواطن لا يلجأ إلى المؤسسات الرسمية، بل إلى السياسي أو شيخ العشيرة أو القائد الحزبي، لأنهم وحدهم القادرون على «تفعيل» الدولة لصالحه.
النتائج السياسية والاجتماعية
تُنتج الزبائنية في العراق ثلاثة مفاعيل أساسية: أولاً، تعميق اللامساواة؛ فالموارد العامة لا تُوزّع على أساس الحاجة أو العدالة، بل على أساس الولاء، ما يؤدي إلى تكريس الفوارق الطبقية والطائفية. ثانيًا، تآكل الثقة بالمؤسسات؛ إذ يدرك المواطن أن القانون لا يكفي، وأن الوصول إلى الخدمة يحتاج «واسطة»، فيتراجع إيمانه بالدولة كمصدر للعدالة. ثالثًا، إعادة إنتاج النخب نفسها؛ فالزبائنية تُغلق المجال السياسي أمام القوى الجديدة، لأن الولاء المالي والشبكات الشخصية تحسم المنافسة مسبقًا. وبذلك، تتحول الديمقراطية العراقية إلى ما يسميه بعض الباحثين «ديمقراطية زبائنية»، أي نظام انتخابي يستند إلى منطق التوزيع الريعي أكثر مما يستند إلى المواطنة.
نحو تفكيك المنظومة الزبائنية
إن الخروج من هذا المأزق يتطلب، كما يقترح المنظرون، إعادة بناء الروابط بين الدولة والمجتمع على أساس مؤسسي لا تبادلي. فلا بد من تقوية آليات المحاسبة، وتحييد التعيينات عن الولاءات، وإصلاح النظام الريعي الذي يغذي اقتصاد المنافع الشخصية. فحين يتحول الريع إلى حقّ مواطني لا إلى منحة حزبية، وحين يصبح القانون هو القناة الوحيدة للحصول على الموارد، تبدأ الزبائنية بالانحسار تدريجيًا. كما أن التربية السياسية والمواطنة الفاعلة يمكن أن تخلق «وعيًا مضادًا» للزبائنية، يعيد تعريف العلاقة بين المواطن والدولة. فلا يمكن إصلاح الدولة من الداخل الزبائني إلا بضغطٍ اجتماعي من الخارج، يعيد الاعتبار لفكرة الحقوق لا المكرمات. من خلال أفكار كيتشلت وهوبكن وهيكن وروبنسون وكورشات جنار، يمكن القول إن الزبائنية السياسية في العراق ليست طارئة، بل متجذرة في بنية النظام نفسه. إنها ليست مجرد خلل إداري، بل منطق حكم متكامل يُعيد إنتاج ذاته عبر كل دورة انتخابية. فالدولة العراقية، في صورتها الراهنة، هي دولة زبائنية تُوزّع الريع لتضمن الولاء، وتشتري الاستقرار السياسي عبر المنافع لا عبر العدالة. لكن هذا النمط، مهما طال، لا يمكن أن يشكّل أساسًا لدولة حديثة. فحين تتحول السياسة إلى سوق ولاءات، وتصبح المواطنة سلعة في يد الراعي، يتآكل معنى الدولة ذاته. وحدها عملية تفكيك هذا الاقتصاد الزبائني، عبر مؤسسات عادلة واقتصاد إنتاجي وثقافة سياسية جديدة، يمكن أن تُخرج العراق من دهاليز الزبائنية إلى أفق الدولة المدنية الحقيقية.