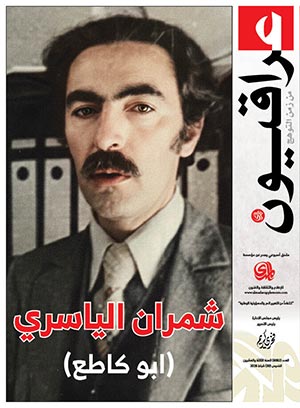طالب عبد العزيز
بسبب السياسة العراقية الهزيلة التي تدير البلاد منذ عقود، يتعرض الشعب العراقي لأبشع ابتزاز من دول الجوار بخاصة، وما يتعرض له في قضية الماء من حكومتي تركيا وإيران إلا نتيجة فعلية لتلك السياسة، ومهما قيل وسيقال بشأن الاتفاقية الأخيرة مع تركيا، فإنها الحلّ (المذلّ) لكنه الأمثل والأكيد؛ الذي لا بدَّ منه، وإلّا فمصير البلاد إلى ما هو أسوأ، ومستقبل النهرين بيد الجفاف، والتصحر وحشٌ قادم لا محالة.
ربما تكون الصورة قاتمة، وهي ليست وليدة هذه السنة، فالعراق، وعلى تعاقب الحكومات منذ التأسيس إلى اليوم، لا يرتبط باتفاقيات دولية مع دول المنبع، وكل ما عملت عليه السياسة المائية لا يعدو أن يكون بروتوكولات أخلاقية وإنسانية، غير مكتوبة وغير مودعة في المحافل الأممية؛ من هنا يمكننا اعتبار هذه الاتفاقية أول معالجة رسمية لحل أزمة المياه مع تركيا، بوصفها المورِّد الأول للعراق، وإن كانت جناية واضحة، وإن كان الأتراك قد استثمروا أو استغلوا ضعف السياسة وهزال الوضع العراقي لتحقيق غايات سياسية واقتصادية وغيرها، لكن لن تجد الحكومة العراقية سبيلاً تسلكه إلا الإذعان، وهذه ضريبة يدفعها العاجز والمهزوم.
أمام هذا المأزق وجدت الحكومة العراقية سياستها بين فكي الكماشة (تركيا القوية وحاجة البلاد إلى الماء)، فهي ما زالت تصمت عن تحديد فترة بقاء المسلحين الأتراك داخل حدودها، أو رفضها تجديد فترة وجودهم غير القانوني، لذا فهم باقون إلى ما لا يعلمه إلا الله، مثلما لا تتحمل طويلاً صبر العراقيين على شحّ المياه وتعطّل موسم الزراعة الشتوية، الذي يتضاعف يوماً إثر آخر. فالشكوى من النقص لم تعد تقتصر على البصرة والبصريين، بل شملت محافظات الوسط والجنوب كله، لذا كانت مضطرة لقبول إملاءات تركيا وتحمل أعباء ما تضمنته بنود الاتفاقية.
وعلى وفق المعادلة الصعبة هذه، سيتوجب على المحاور العراقي المسؤول أن يكون أكثر فطنةً وذكاءً ومناورةً، وعلى أبناء البلاد ألا يتطيّروا من فكرة قيام الشركات التركية ببناء السدود وتسلم ملف إدارة المياه للسنوات الخمس القادمة، لأنَّ العراق بحاجة إلى هذه الإدارة قبل الإطلاقات المائية من تركيا، ولعل الإشارة إلى قضية هامة مثل منع الملوثات الخدمية والصناعية من تسربها إلى الأنهار واحدةٌ من أفضل ما تضمنته بنود الاتفاقية.
ليست الإطلاقات المائية القليلة هي ما يعاني منه العراق، إنما سياسة إدارة المياه، فالهدر المنزلي يفوق التصورات، لأنَّ العراقي اعتاد على الإسراف لا التقنين، وهو غير مقتنع بوجود أزمة مائية، وصورة بلاد الرافدين ما زالت عالقة في ذهنه بوصفها الوفرة والإتاحة. أمّا إفراطه في استخدام الماء للزراعة فحدّث ولا حرج، كذلك تكون الحكومة في قضية مثل تحويل تصاريف المياه الثقيلة والمجاري إلى النهرين دجلة والفرات، وكذلك إلى شط العرب، فهي الطامة الكبيرة التي تلقي بثقلها على البصرة، المدينة التي توطّن الملح في نهرها، وما زال ممسكاً بضفتي الشط، صاعداً أعاليها ومهدداً بالصعود في كل مدٍّ، مستغلاً قلة الإطلاقات من ناظم قلعة صالح، الذي يكاد ينضب هو الآخر.
نبيع النفط إلى تركيا ونشتري بثمنه السدود والإدارة المائية، ولا ضير من وجود الشركات التركية، شريطة أن لا تكون التعاملات هذه مجحفة وضارة بالاقتصاد، وليرتفع حجم التعاملات الاقتصادية إلى 30 مليار دولار، لكن الأهم من ذلك كله هو أنْ تتضمن الاتفاقية حجم وكمية الإطلاقات المائية السنوية المستدامة، بما يؤمّن حاجة العراق الفعلية والمستدامة أيضاً، مع الأخذ بنظر الاعتبار حاجة تركيا منها، ولكي يضمن العراق ديمومة بنود الاتفاقية عليه إيداع نسخة منها لدى الأمم المتحدة لتصبح ملزمة التطبيق، بوصفها وثيقة رسمية تحدد حاجة الشعبين العراقي والتركي من المياه.