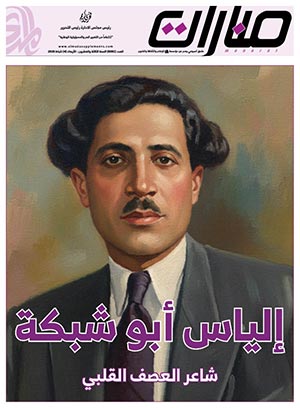علاء المفرجي
– 2 –
المكان في الافلام العربية كان له حضورا مكانيا ورمزيا واضحا، لكنه ايضا لم يكن هذا الحضور يتعلق بالمكان كجغرافية، أو ثقافة، او تأثير. فالقاهرة في أفلام يوسف شاهين وصلاح أبو سيف كانت تبدو ككائنٍ نابضٍ بالفرص، رغم الفقر والتناقضات. في "باب الحديد"، تتحول محطة القطار إلى كونٍ مصغّر من البشر والأصوات، حيث يتصارع الحب مع العزلة. أما في "القاهرة 30"، فالمدينة تبتلع أحلام الطبقة الوسطى، لكنها تظل ساحة محتملة للتغيير. كانت العدسة في ذلك الوقت تميل إلى التفاؤل: المدينة قاسية، نعم، لكنها تُحتمل لأن فيها وعدًا بالعبور نحو حياة أفضل.
ثم جاء زمن آخر - زمن الإسمنت والزحام والاغتراب. فتحولت المدينة في السينما الحديثة إلى متاهة وجودية. في "عمارة يعقوبيان"، تبدو القاهرة كوحشٍ ضخمٍ يبتلع ساكنيه؛ كل شقة حكاية، وكل نافذة سجن صغير. ووفي "اشتباك"، تختصر سيارة ترحيلات ضيقة مدينة بأكملها، حيث الجميع متجاورون ومختنقون في الوقت ذاته.
المخرج يوسف شاهين، وضف المدينة (مدينته) ليستعرض جانبا من سيرته الذاتية، ثلاثية أفلام يوسف شاهين التي تحمل اسم الإسكندرية هي في الواقع سلسلة من أربعة أفلام تتناول سيرته الذاتية وتربطها بمدينة الإسكندرية، وهي: "إسكندرية ليه؟" (1978)، "حدوتة مصرية" (1982)، "إسكندرية كمان وكمان" (1989)، و**"إسكندرية... نيويورك" (2004).
يصعب الفصل بين يوسف شاهين والإسكندرية الحديثة، ففي الحديث في مجالات عدَّة: التاريخ، والفن، والسيرة الذاتية. ومع مرور الزمن صارتهذه التفاصيل في عدد من أفلامه تُذكر كمراجع عن تاريخ المدينة وأحوالها.
أما في السينما العالمية، فيكفي أن نتأمل "سائق التكسي" لسكورسيزي أو "ضائع في الترجمة" أخراج صوفيا كوبولا، لنرى كيف تحوّلت المدن الكبرى إلى أماكن للضياع العاطفي والروحي، رغم ضجيجها المضيء. فالمدينة في السينما لم تعد فقط ما نراه، بل ما نشعر به داخلها. هي مرآة للإنسان المعاصر: يركض دائمًا، يتواصل بلا لقاء، يعيش وسط الجموع لكنه وحيد.
الكاميرا لم تعد تتجوّل بين الشوارع فقط، بل تتوغّل في الزوايا النفسية للمكان - في العزلة التي يسكنها الناس خلف النوافذ العالية والمقاهي السريعة والهواتف التي لا تصمت. في العمق إذن، كل فيلم عن المدينة هو فيلم عن الهوية.
هل ننتمي إلى المكان أم ننجو منه؟ هل ما زالت المدينة تصنع الحلم، أم صارت تستهلكنا باسم الحداثة؟ السينما وحدها قادرة على طرح هذه الأسئلة من دون أن تقدّم أجوبة. ووربما، لهذا السبب، نحب أن نشاهد المدن على الشاشة أكثر مما نعيشها في الواقع.
لأن السينما تمنحنا تلك المسافة الآمنة التي نفتقدها في الشارع الحقيقي - حيث يمكننا أن نرى الخراب ونحبّه، ونرى الزحام من بعيد دون أن نختنق.
في النهاية، حين تنطفئ الأنوار في القاعة، ويبدأ شريط المدينة في الدوران، ندرك أن السينما ليست فقط عن المكان، بل عن الإنسان الذي يحاول أن يجد نفسه فيه. فالمدينة، مهما تغيّر وجهها، ستظل أكبر مشهدٍ مفتوحٍ في التاريخ — مشهدًا لا ينتهي أبدًا.