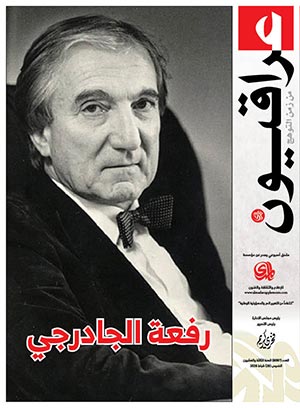حسن الجنابي
أصبحت الولايات المتحدة وحدها اللاعب المهيمن على الساحة الدولية منذ تسعينيات القرن الماضي. لكن العالم يشهد صعود قوى جديدة، أبرزها الصين، التي هي ليست مجرد اقتصاد صاعد، بل مشروع قوة عالمية متكاملة تمتد من الاقتصاد إلى التكنولوجيا، ومن النفوذ الإقليمي إلى الطموح الكوني.
ويبدو أن تغيّراً ملموساً يحصل في جوهر العلاقات الدولية مع تبلور تكتلات جديدة مثل «بريكس» و«منظمة شنغهاي للتعاون»، وهي كيانات تسعى إلى كسر احتكار الغرب لمفاتيح النظام الاقتصادي والمالي العالمي. ومع انضمام دول أخرى إلى هذا المسار، يبدو أن ملامح نظام دولي بديل تتشكل بهدوء، نظام يقوم على شراكات اقتصادية أكثر انفتاحًا، ولكن أيضًا على منافسة سياسية محتدمة.
فالصين تبني شبكة نفوذ تمتد عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا، مستندة إلى استثمارات ضخمة ومشروعات بنى تحتية هائلة. وهذه الاستراتيجية التي تبدو تنموية في ظاهرها تحمل أبعادًا جيوسياسية لا يمكن تجاهلها. فهي تمنح بكين حضورًا متزايدًا في مناطق كانت تُعدّ تقليديًا ضمن دائرة النفوذ الغربي، وتضعها في مواجهة غير مباشرة مع واشنطن وحلفائها.
الدبلوماسية هنا تتحول إلى ميدان تنافس ناعم، ولكنه لا يقل شراسة عن الصراعات العسكرية. فالحروب لا تُخاض اليوم بالسلاح وحده، بل بالعقود التجارية، والاستثمارات، والاتفاقات متعددة الأطراف، والعملة، والتكنولوجيا. وبذلك أصبحت الدبلوماسية الاقتصادية أداةً مركزية في إدارة الصراع العالمي الجديد.
وفي المقابل، تنظر القوى الغربية بقلق إلى هذا التحول، ولا يبدو ان موقفها موّحد بل ينتابه شيء من الارتياب، على الأقل أوربياً، فضلاً عن الصراعات في جنوب شرق آسيا المشوبة بظلال تاريخية ثقيلة بين الصين واليابان وكوريا. وترى تلك القوى أن «بريكس» ليس بالضرورة مجرد تكتل اقتصادي، بل نواة لمشروع سياسي يسعى إلى إعادة صياغة قواعد اللعبة الدولية، وقد لا يكون ممكناً إيقافه. ولهذا فهي تحاول احتواء الصعود الصيني عبر تحالفات جديدة في المحيطين الهادئ والهندي، الى جانب تعزيز دور حلف الناتو وتوسيعه شرقاً، لمحاصرة وتفكيك روسيا ان أمكن، ولمحاصرة الصين كذلك. وتوسع الناتو من وجهة نظر الكثيرين هو السبب الرئيسي للحرب الروسية الأوكرانية.
إن ما يجري اليوم هو صراع نفوذ يعكس تحولاً هيكلياً في توزيع القوة والثروة على مستوى العالم، تتراجع فيه أوروبا عن موقعها التقليدي في القيادة، وينشغل الغرب في انقساماته الداخلية ومعالجة العامل “الترامبي” الطارئ، في حين تتقدم آسيا بخطى واثقة نحو مركز المسرح الدولي. أما بالنسبة للعالم النامي فقد تكون هذه التغييرات فرصة للمناورة بين الأقطاب، بحثًا عن موقع أقل تبعية وأكثر استقلالًا. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر أمام الجميع هو ضمان ألا يتحول هذا التعدد القطبي الصاعد إلى فوضى جديدة، وأن لا تُغلّب المصالح الضيقة على التحديات الكونية المشتركة مثل التنمية والبيئة والعدالة الاقتصادية.
هكذا، ومع تقدم الصين وتوسّع بريكس، يتشكل مشهد دولي جديد يعيد تعريف موازين القوة، ويضع الدبلوماسية أمام امتحان صعب في إدارة التعدد دون السقوط في الفوضى، وفي كيفية بناء شراكات وتجنب الحروب. فالاستقرار العالمي لا يتعلق بالتوازنات العسكرية أو السياسية فقط، بل أصبح مشروطًا أيضًا بقدرة الدول على التعامل مع التكنولوجيا والاتصال والمعلومات.
وفي هذا الميدان الجديد، تبدو الدبلوماسية العراقية متأخرة عن الركب، لأنها محكومة بأنماط تفكير قديمة، في الوقت الذي تتحول فيه الدبلوماسية إلى فعلٍ رقمي مفتوح، تتفاعل فيه الحكومات والمؤسسات والرأي العام لحظة بلحظة.
ما زالت المؤسسات العراقية تتعامل بمنطق المراسلات الورقية والبيانات المتأخرة. حتى التواصل بين الدوائر الرسمية والسفارات ما زال يجري في كثير من الأحيان بوسائل غير مؤسسية، عبر مجموعات واتساب أو اتصالات شخصية، في غياب البنية الرقمية والاحتراف الإداري الذي يفترض أن يحكم العمل الدبلوماسي الحديث.
تتقدم الدول اليوم في بناء “دبلوماسية رقمية” حقيقية، تستثمر الفضاء الإلكتروني لشرح سياساتها، وتقديم صورتها، ومتابعة الأزمات، والتفاعل مع الجمهور الدولي مباشرة. بينما يعاني العراق من ضعف الرؤية الاستراتيجية، ومن غياب مركز دبلوماسي موحد قادر على استيعاب هذا التحول الجذري في مفهوم التمثيل الخارجي.
إن العراق، بما يمتلكه من تاريخ وموقع وجغرافيا سياسية حساسة، كان يمكن أن يستعيد عافيته بعد نكسة الدكتاتورية والحروب والاحتلال، ليكون لاعبًا مؤثرًا في الدبلوماسية الإقليمية والدولية. لكن ضعف الأداء المؤسسي، وتضارب الولاءات السياسية القائم على المحاصصة، والغياب المزمن للتخطيط، جعل صوته خافتًا، وحضوره في المنتديات الكبرى باهتًا. وبدل أن يكون صانعًا للحدث، أصبح متلقيًا له، يتفاعل بعد فوات الأوان.
ومع ذلك، فإن الفرصة قائمة لإعادة بناء الدبلوماسية العراقية على أسس حديثة. فهناك فرصة غير مسبوقة للحضور والتأثير عبر الأدوات الرقمية، والإعلام الدولي، والدبلوماسية العامة، دون الحاجة إلى موارد ضخمة. لكن ذلك يتطلب تغييرًا في العقليات قبل الأنظمة، وفي طريقة اختيار الكوادر قبل تحديث المنظومة.
إن استعادة العراق لمكانته الخارجية لن تتحقق بمجرد إصدار بيانات رسمية، أو تعيين تسعين سفيراً مرة واحدة دون تمحيص وخارج الأطر المعروفة، أو إرسال وفود شكلية، بل بإطلاق مشروع وطني للدبلوماسية الجديدة، يربط بين المعرفة والاتصال، وبين السياسة والإعلام، وبين التقنية والقرار. فالدبلوماسية الحديثة، في جوهرها، ليست مجرد وزارة خارجية، بل منظومة تفكير متقدمة تمثل الدولة في صورتها الأكثر حيوية وتطورًا.
وإلى أن يحدث ذلك، ستظل دبلوماسيتنا أسيرة الماضي، تبحث عن مكانها في عالم لم يعد ينتظر المتأخرين، فيصبح اللجوء “للخمط” وسيلة أخرى للمنافع الشخصية والطائفية ومنهجاً للمزيد من التراجع.