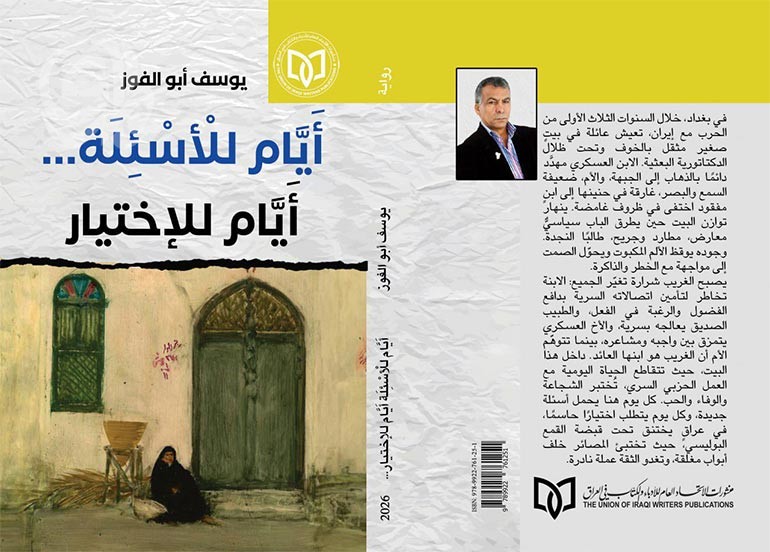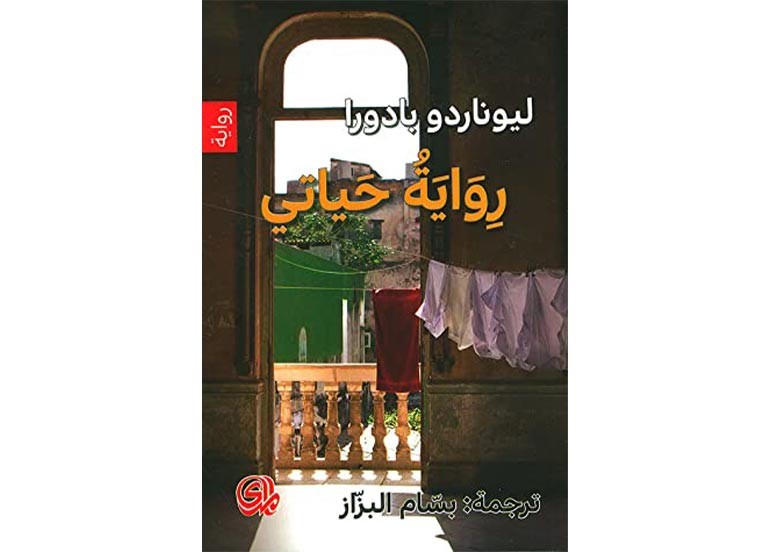عبد الكريم البليخ
كثيراً ما نتوقّف عند أخبارٍ تتحدّث عن كاتبٍ جديدٍ أو اسمٍ أدبيٍّ صاعد، يُقال عنه إنه من “فرسان القلم”، أو “أحصنة الإبداع”، ممن تمكّن من إصدار رواية، أو ديوان شعر، أو مجموعة قصصية، أو دراسة فكرية أو نقدية، في زمنٍ صار الأدب فيه ميداناً مفتوحاً للجميع. زمنٌ لم يَعُد فيه من الصعب أن تطبع كتاباً، بل أن تجد من يقرؤه، أو يتوقّف عنده بإمعانٍ وتأمل.
يظهر هذا الكاتب، في المشهد العام، مدفوعاً بحماسةٍ طازجةٍ، يُلفت أنظار الأصدقاء والمعارف، ويسعى لأن يُعرّفهم بإنتاجه، وأن يُكرّس لنفسه حضوراً في المشهد الثقافي. حتى هنا لا عيب في الأمر، فلكلّ مبدعٍ الحق في أن يُقدّم عمله إلى الناس، وأن يحتفي بجهده الإبداعي بعد رحلة الكتابة الطويلة. غير أن ما يثير التساؤل حقاً هو الطريقة التي تُمارس بها هذه الرغبة، حين يتحوّل الإعلان عن الكتاب إلى ما يُشبه الاستجداء الأدبيّ المغلّف بعبارات الودّ والتكريم.
في مشهدٍ بات مألوفاً ومكرّراً، يَهرع الكاتب إلى تنظيم حفل توقيعٍ في مقهى أو قاعة صغيرة، يُرسل الدعوات لأصدقائه ومعارفه، ويطلب حضورهم وشراء نسخةٍ من كتابه “دعماً” له، لا إعجاباً بالنصّ أو اهتماماً بالفكر. يضع طاولةً أنيقة، يبتسم للكاميرات، يُخرج قلمه ليوقّع الصفحات كأنّ التوقيع شهادة ميلادٍ جديدة له. غير أنّ خلف هذا البريق البسيط تختبئ رغبةٌ مؤلمة: استرداد ما خسره من مالٍ وجهدٍ في طباعة الكتاب، ومحاولة تعويض الفشل المسبق في الوصول إلى القرّاء الحقيقيين.
كثيرون من هؤلاء الكتّاب لا يملكون دار نشرٍ تتبنّى أعمالهم، ولا قاعدة قرّاءٍ تنتظر جديدهم. لذلك يصبح “التوقيع” وسيلةً لبيع عددٍ محدودٍ من النسخ عبر دائرة الأصدقاء والمجاملات. وهنا تتبدّى المفارقة المريرة: الكاتب الذي يُفترض أن يقدّم للعالم فكراً أو جمالاً، يتحوّل إلى بائعٍ يروّج سلعةً خاسرة، ويُمارس ما يشبه “التسوّل الراقي” باسم الثقافة.
من المؤلم أن تتحوّل لحظة الاحتفاء بالإبداع إلى طقسٍ اجتماعيٍّ شكليٍّ تحكمه الصورة أكثر من المضمون. فالكاميرات تلتقط الابتسامات، واللافتات تُمجّد “الكاتب الكبير”، والحديث يدور عن “تجربته الفريدة”، بينما الكتاب نفسه يظلّ مغلقاً، لا أحد يقرأه، ولا أحد يناقش فكرته أو لغته أو قيمته الجمالية. كأنّ الكتاب مجرّد ذريعةٍ للظهور، لا مشروع فكرٍ أو إبداعٍ حقيقي.
الكاتب الحقيقي لا يحتاج إلى جمهورٍ مُستدعى ليصفّق له، بل إلى قارئٍ صادقٍ يلتقيه في صمت الصفحة. لا يُقاس النجاح بعدد الحاضرين في الحفل، ولا بعدد الصور المنشورة على مواقع التواصل، بل بما يتركه النصّ من أثرٍ في وعي القارئ ووجدانه. فالنص الجيّد كالموسيقى: يسمعه القلب قبل الأذن، ولا يحتاج إلى مكبّرات صوتٍ ليصل.
إنّ حفلات توقيع الكتب في كثيرٍ من الأحيان لم تعد احتفاءً بالكتابة، بل بالكاتب نفسه. يُقدَّم الكاتب بوصفه نجماً لا مفكّراً، وتتحوّل الدعوة إلى حفل توقيع إلى ما يُشبه إعلاناً تسويقياً لا يَختلف كثيراً عن ترويج منتجٍ تجاريٍّ جديد. نقرأ في الدعوة كلماتٍ من قبيل: “الكاتب المتألّق”، “العمل المنتظر”، “الحدث الأدبي الكبير”، وكلّها عبارات تضخيمٍ تُخفي وراءها فقر المضمون وغواية الظهور.
وهنا تكمن خطورة التحوّل: من فعل الإبداع إلى فعل الترويج، من رسالة الأدب إلى سوق المظاهر، من الكاتب الباحث عن المعنى إلى “المؤثّر” الباحث عن المتابعين. فالكتابة في جوهرها فعل صدقٍ وتأملٍ وتعبير، لا وسيلة لكسب الإعجابات أو جمع الإشادات الزائفة.
قد يقول البعض إنّ الكاتب يحتاج إلى دعمٍ وتشجيعٍ ماديٍّ ومعنويٍّ ليستمرّ، وهذا صحيح، لكنّ الفرق شاسعٌ بين الدعم والاستعطاف. فالدعم يكون حين يُقدّر القارئ العمل لأنّه يستحق، أمّا الاستعطاف فحين يُطلب الدعم باسم الصداقة أو الواجب الاجتماعي. الكاتب الحقيقي لا يطلب من أحد شراء كتابه، بل يترك كتابه يُفرض بقيمته لا بعلاقاته. فالكتاب الجيّد يُشبه البذرة؛ قد لا تنبت سريعاً، لكنها إن كانت صالحة، فستنمو وحدها، وستثمر قرّاءً مخلصين مع الوقت.
ما يؤلم في هذا المشهد ليس الفعل بحد ذاته، بل ما يكشفه من أزمة أعمق: أزمة معنى الكتابة في زمنٍ استُبدلت فيه القيمة بالضوضاء، والجوهر بالشكل، والصدق بالاستعراض. صار البعض يكتب ليُقال إنه كاتب، لا لأنه يملك ما يقول. يكتب ليظهر في الصورة لا ليترك أثراً في الذاكرة. ويغدو النشر مجرّد خطوةٍ في رحلة “الشهرة السريعة”، لا في بناء مشروعٍ فكريٍّ أو إبداعيٍّ جاد.
في الماضي، كان الكاتب يُعرف بصمته قبل صوته، وبما يُبدع قبل ما يُعلن. كانت الكتب تصل إلى الناس بلا كاميرات ولا حفلات ولا هتاف. كانت الكلمة تنشر في الصحف والمجلات فتحدث ضجيجاً في العقول لا في القاعات. اليوم، صارت “الصورة التذكارية مع الكاتب” أهمّ من النص نفسه، وصار التوقيع غايةً لا تفصيلاً رمزياً، وصارت “لحظة الإهداء” بديلةً عن “لحظة القراءة”.
لكن، لا يُمكن أن نلقي اللوم كلّه على الكتّاب وحدهم. فالمسؤولية مشتركة. حين يغيب النقد الجادّ، ويتراجع دور المؤسسات الثقافية، وتضعف صلة القارئ بالكتاب، يملأ الفراغَ صوتُ الضجيج. ومع انحسار القراءة الجادّة، باتت المنصّات الإلكترونية ساحةً لتكريس التفاهة والسطحية، إذ يكفي أن تُرفق غلاف كتابٍ بصورة أنيقةٍ لتنال “الإعجابات”، ولو لم يقرأه أحد.
ولأنّ المجتمع بات يقدّر الظهور أكثر من القيمة، يجدُ الكاتب نفسه مضطراً إلى تقمّص صورة “النجم”، لا “المفكّر”. إنّه يكتب من أجل البقاء في المشهد، لا من أجل البقاء في الذاكرة. والوسط الثقافي نفسه، حين يكرّس أسماءً على حساب أخرى، لا بناءً على جودة النصوص بل على عدد المتابعين والمشاركات، إنما يسهم في إفساد الذائقة العامة وتشويه مفهوم الأدب.
ومع ذلك، يبقى الأمل قائماً. فثمة كتّاب يكتبون في صمتٍ، بعيداً عن الأضواء، لأنهم يؤمنون بأنّ الكتابة فعل خلودٍ لا إعلان، وأنّ النصّ الصادق لا يحتاج إلى منبرٍ ليُسمَع. هؤلاء يكتبون لأنّ في الكتابة خلاصهم الداخلي، لا رزقهم المادي. لا ينتظرون حفلاً أو توقيعاً أو عدسة كاميرا، لأنّهم يعلمون أنّ القارئ الحقيقي سيجد طريقه إلى النصّ الصادق ولو بعد حين.
إنّ توقيع الكتاب، حين يُفرغ من معناه، يصبح تسوّلاً أدبياً مؤلماً، لكنه أيضاً مرآةٌ لزمنٍ فقد توازنه بين القيمة والشهرة، بين الفكر والواجهة. ومع ذلك، سيبقى هناك دائماً من يكتب لأنّه لا يستطيع إلا أن يكتب، من يضع الكلمة في موضعها كحبّة نورٍ في العتمة، لا كسلعةٍ على طاولةٍ أنيقة. فالكلمة التي تولد من الصدق لا تحتاج إلى ضوءٍ خارجي لتُرى؛ إنّها تضيء ذاتها بذاتها.
سيبقى الكاتب الحقيقي مؤمناً بأنّ الأدب ليس حفلاً لتوزيع التواقيع، بل رحلة صادقة نحو الإنسان والمعنى، وأنّ الكتاب الذي يُكتب بصدقٍ سيصل، في النهاية، إلى قلبٍ يشبهه، ولو بعد سنواتٍ من الصمت.
وجهة نظر: توقيع الكتاب يستجدي مجداً زائفاً

نشر في: 16 نوفمبر, 2025: 12:02 ص