لطفية الدليمي
لا أرغب في زيارة بغداد. أقولها كمَنْ يطعن نفسه بعبارة يعرف أنها ستجعله ينزف طويلاً. صحّتي لا تعينني. لن أخاتل في هذا؛ لكنْ حتّى لو أعانتني صحّتي فلا أفكّرُ في الرجوع إلى الحضن الأوّل بعد أن غادرته عام 2006، ولم أحسب أن تكون تلك المغادرة نهائية. كيف أزورُ مدينة كانت يوماً توأم الروح، وصارت الآن مرآة لا أحتملُ النظر إليها؟ بغداد التي كنت أعرفها لم تعُدْ بغدادنا. اختفت بين طبقات الغبار والخراب، وذابت في ضجيج المولّدات ودخان العشوائيات. متى كانت بغداد تستمدُّ كهرباءها من مولّدات يستثمرُها طفيليون جشعون؟ كلُّ ما تبقّى من بغداد في قلبي: رائحة نهر، ظلُّ شجرة، ومقهى صغير كان يضحك فيه الزمن، ونبادله نحن الضحك. لم نتحسّبْ لما تخبّئه الأيّام.
أخاف أن أعود فأجدُ بغداد لا تتذكّرُني. أخاف أن أسير في شوارعها فلا أتعرف على مواضع خطواتي. لذلك أبقى بعيداً، أحتفظ ببغدادي القديمة في ذاكرتي كما يحتفظ عاشق بصورة حبيبته قبل أن تفترسها علّة قاتلة. كثيرون ينصحونني: إياكِ والذهاب لبغداد. لعلّك لن تحتملي غصّة المقتلة التي تذبح بغداد بخناجر من شتّى الأصناف والعائديات.
منذ عام 2003 لم يَعُد الإغتراب العراقي محض مناقلة في الجغرافيا؛ بل صار قدراً في الروح. قبل 2003 كان الإغتراب طلباً للقمة عيش ضاقت في العراق فراح العراقيون يبحثون عنها من غير ما رغبة أو يقين بإستمرارية الإغتراب. كانوا يمنّون النفس إنْ هي إلّا بضع سنوات عجاف وينتهي الأمرُ. الإحتلال الأمريكي لم يُسْقِطْ نظاماً فقط؛ بل أسقط الإحساس بالعالم. مِنْ غير تحسّبات مسبّقة، وعلى غير انتظار، استيقظنا عام 2003 على وطن بلا مركز، على زمن يتكرّرُ دون معنى. الناس يهربون؛ لكنهم لا يعرفون مِنْ ماذا، ولا إلى أين. كأنّ البلاد لفظت أبناءها، وكأنّ كلّ واحد منا صار يبحث عن ظلّه في مكان آخر.
الغربة الأولى هي المنفى خارج الجغرافية العراقية. حين غادرتُ العراق عام 2006 كنت أظنُّ أنّ الإغتراب هو تلك المسافة الفاصلة بين مطاريْن. أو مرآبيْن. اكتشفتُ لاحقاً أنّ المسافة الحقيقية هي بين الذاكرة والواقع.
في المنافي لا أحد يسألك من تكون؛ لكنّ كلّ شيء من حولك يذكّركَ بأنّك لست من هنا. لا انفجارات سيارات مفخخة، لا أخبار اغتيالات؛ لكنّ في قلبك انفجارات مؤجلة في الشتات، نحمل العراق معنا كعبءٍ مقدّس. في المقاهي البعيدة، نتحدّثُ عن شارع المتنبي كما يتحدّثُ المنفيُّ عن قصيدته الضائعة. نستعيد التفاصيل الصغيرة: طعم الشاي بالقداح، رائحة الكتب القديمة، ضحكة صديق اختفى في عتمة الخوف؛ لكنْ كلّما استعدنا هذه التفاصيل ازداد الألم وضوحاً وتجذّراً في أعمق طبقات الروح. الحنين ليس دفئاً كما يظنُّ الناس؛ بل سكين باردة لا تنفكُّ تذكّرك بأن ما تحِنّ إليه قد تلاشى في ضباب الفقدان.
الغربة الثانية هي المنفى داخل الوطن. الإغتراب الخارجي، مهما كان قاسياً، يظلُّ أهْوَنَ من الإغتراب الداخلي. أنْ تكون في بغداد و تشعر أنك مغيّبٌ عنها وهي غائبة عنك - تلك هي المأساة الكبرى. ألزهايمر بغدادي: هكذا يعجبني توصيفُ الحالة. مَنْ بقي هناك يعيش في وطن يتبدّل وجهه كل يوم: مشاهد تغريبية عن روح بغداد والبغداديين، أصوات طائفية ناشزة، جدران جديدة تُبنى بين الجيران. الناس صاروا غرباء في مدنهم، يخافون من نظرة، من سؤال، من اسم. صار الحبُّ فعلاً مشبوهاً، والإختلاف جريمة، والصمت وسيلة نجاة.
الإغتراب الداخلي هو أن تعيش بين أهلك وتشعر أنك طيفٌ شبحي عابر مثل هباءة غبارية زائلة . أن تسير في شارع الرشيد ولا ترى فيه شيئاً من ذاكرة الصور القديمة. أن تسمع الأذان ولا تعرف لأي صلاةٍ يدعوك لأنّ الله نفسه صار موضوعاً يتنازع عليه المختلفون. صار العراقي يخاف من العراقي، وصارت الهوية تهمة لا انتماء.
لكل عراقي، سواءٌ كان في المنفى أو في الداخل، جروحٌ لا تندمل.
أولها جرح اللاإنتماء: أن تشعر أنّك لا تنتمي إلى مكان محدد. تعيش في أوروبا أو أمريكا وتتحدّثُ عن العراق كأنّك تتحدث عن حكاية خرافية.
وحين تعود إلى العراق تشعرُ أنّك ضيفٌ في بيتك القديم ، وأنّ اللغة نفسها خانتك. وهل أعظمُ مُصاباً من إغترابك عن اللغة العربية التي نشأتَ في أحضانها الجميلة؟
ثم يأتي جرح الذاكرة: ذاك الطفل الذي كنّا نراه يركض في الأزقّة صار الآن رجلاً يبحث عن قبر أبيه. الذكريات تحوّلت إلى متاحف من الحنين، نفتحها لنستعيد الدفء فيخنقنا الألم. أهو قدرٌ مكتوبٌ في جبين العراقي: لا يستطيع أن يتذكّر دون أن يتألم، ولا أن ينسى دون أن يخون.
ثمّ جرحُ الهوية. من نحن اليوم؟عراقيون؟ أم أبناء الطائفة؟ أم أبناء الخوف؟ الهوية تمزّقت كعَلَمٍ قديم أكلته الريح.
صرنا نبحث عن تعريف جديد لأنفسنا؛ لكنّ كل التعاريف تأتي ناقصة، مشوهة، مثقلة بالدم والخسران.
ثمّ هناك جرح المعنى. حين يفقد الإنسان معنى وجوده يصبح كل شيء فاقداً للقيمة. في العراق اليوم، المعلم يُهان، والمثقف يُقصى، والقاتل يُحتفى به، والخونة يصرّحون بكراهيتهم للعراق ويرونه صناعة بريطانية. القيم تبدّلت، والكرامة صارت ترفاً، والمستقبل فكرة مضحكة.
نعيش في زمنٍ لم يَعُدْ فيه معنى للجهد ولا للإيمان، بل للبقاء البيولوجي فقط. (العاقل هو من يعبئ سلاله بالطيّبات) صارت هي الأمثولة السائدة.
في المنافي نكتشف أنّ الوطن ليس خريطة ولا علماً بل فكرة نحملها معنا كي لا نموت. العراق الآن يعيش في الذاكرة أكثر ممّا يفعلُ في الجغرافيا.
كلُّ مغترب عراقي يحمل نسخة صغيرة من وطنه في داخله:
بغداد التي يحبها ، البصرة التي لم تغرق بعد، الموصل التي ما زالت تنهض من الرماد؛ لكنّ هذه النسخ الماكثة في الذاكرة تتآكل مع الوقت، كصورٍ قديمة تبهت ألوانها بمفاعيل الزمن وضغط الوقائع المُرّة.
نجلس معاً، نحن أبناء الشتات، ونتحدّثُ عن العراق، نستعيد تفاصيله كي نؤكد أنّه كان حياً يوماً ما؛ لكنّنا في أعماقنا نعرف أننا نحاول فقط أن نُسكِت صوت الفقد، لا أن ننتصر عليه. ربما لا شفاء كاملاً من هذا الإغتراب؛
فالروح حين تنكسر لا تعود كما كانت؛ لكنْ حسبُنا أنّنا نحاول أن نحيا رغم الخراب، أن نكتب، أن نحبّ، أن نحلم. الكتابة بالنسبة لي في الأقلّ ليست هواية بل مقاومة ضد العدم. حين أكتب عن العراق فكأنّني أعيد بناء ما تهدّم بالكلمات. ربما لا تعيد الكلمة بيتاً مهدوماً؛ لكنها تُبقي الباب مُشرَعاً للعودة.
جيل جديد الآن يحاول أن يقول: نحن هنا. يرسم على الجدران، يصنع أفلاماً، يكتب شعراً بدمٍ طريّ. جيلٌ لم يعرف العراق الجميل كما عرفناه نحن؛ لكنه يعرف أنّ ما تبقّى منه يستحقُّ الدفاع عنه .
ربما في صوته يختبئ الشفاء الذي لم نقدر عليه نحن. طوبى لهؤلاء الأنقياء الذين يدافعون بالدم عن عراق لم يروه في عنفوانه وحداثته الريادية في المنطقة.
لا أرغب في زيارة بغداد. أخاف أن أراها ولا أرى نفسي فيها؛
لكنّني، رغم كل شيء، ما زلت أحملها في صدري كجرحٍ مضيء.
أكتب عنها لا لأنني أريد العودة؛ بل لأنّني لا أستطيع الرحيل عنها.
ربّما الإغتراب العراقي هو قَدَرُنا؛ لكنّنا نستطيع أن نحوّله إلى معنى. غايةُ ما نستطيعهُ هو أن نجعل من الحنين وطناً مؤقتاً، ومن الألم هوية لا تخجل من دموعها.
وَسْط كلّ هذا الخراب الذي تعيشه بغداد والعراق، ما زالت هناك جملة واحدة تضيء عتمتي: بغداد، مهما تكالبت عليها الأعصُرُ، ستظلُّ المكان الذي يوجعني لأنني أحبّه.





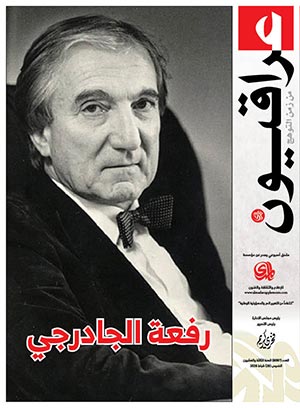





جميع التعليقات 2
قاسم طلاع
منذ 3 شهور
السيده لطيفه الدليمي المحترمة قرأت مقالك هذا.... ما هو رأيك إذا قلت لك ، بأنني خرجت(هربت) من العراق في بداية السبعينيات من القرن الماضي وعدت اليه في عام ٢٠١٧ ... خرجت وكنت شابا في الثانية والعشرين ربما أمثر أو أقل وعدت عجوزا في السبعين من العمر لزيارته
أبو أنكيدو
منذ 3 شهور
يا سيدتي العزيزة: بغداد ماتت مرتين: أولا بدخول المغول! وثانيا بتسلط أبن العوجة المعتوه والذي جلب لنا أولاد تكساس و طويرج😭🤣! بغداد أصبحت عجوزا شمطاء وقبيحة مشوهة بالمباني الزرق ورق الفاسدة 😔والأفضل أن نغني مع الرصافي: و حمامة غنت بدجلة.. طيري!تحياتي🌹