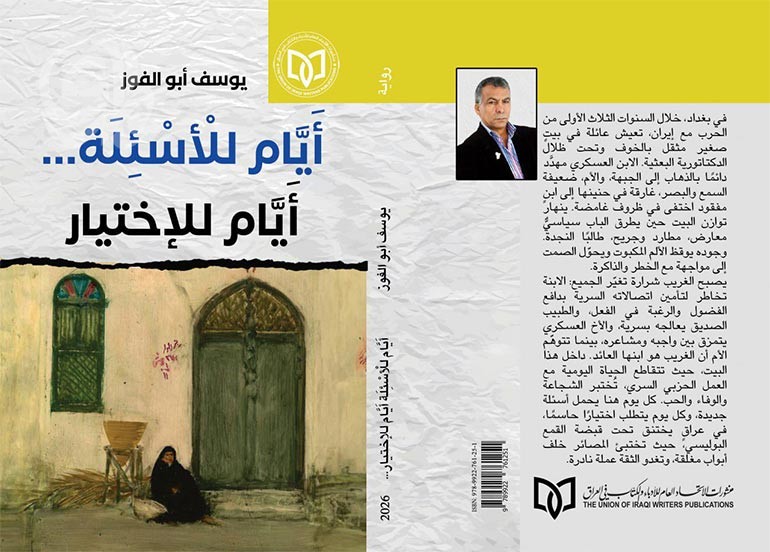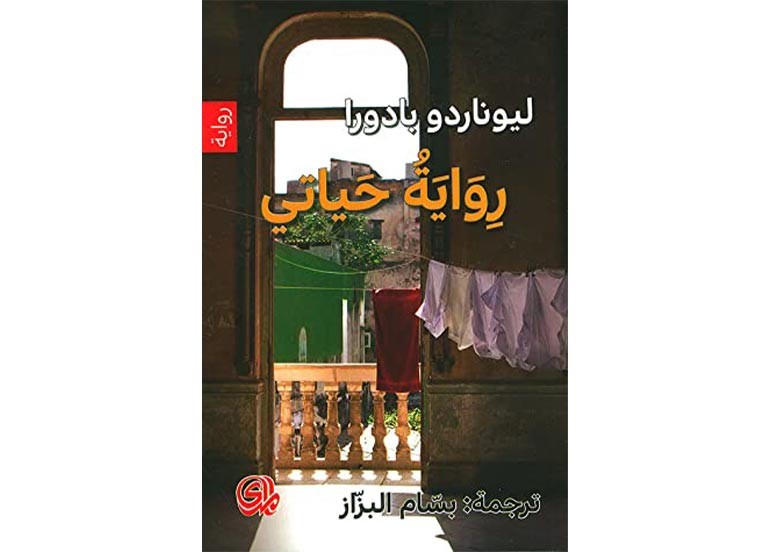علاء المفرجي
يرى باشلار أن المكان (خاصة المنزل والمساحات الصغيرة مثل العلية، القبو، الزوايا) ليس مجرد بنية مادية، بل هو "فضاء نفسي" يعني أن هذه الأماكن تسكنها الذكريات والأحلام. فهو يؤكد أن الأماكن التي سكنناها سابقًا تخزن داخلنا، من خلال الذكريات، وتعيد الظهور في خيالنا وأحلامنا. عبر "الاسترجاع الحلمي يمكننا استعادة مشاعر وأحاسيس الأماكن الماضية، حتى لو لم نعد نعيش فيها. هذا الاسترجاع ليس مجرد تذكار بارد، بل هو عملية إبداعية: نحن "نضيف إلى مخزون أحلامنا" من خلال استحضار هذه الذكريات.
يقول باشلار إن البيت (أو أي مكان مأهول حقًا) يوفر "ملجأ" للخيال. إنه مكان تقي فيه الخيال من ضغوط العالم الخارجي، ويسمح لنا بالحلم "بسلام". هذا النوع من المكان - المكان "المأهول" داخليًا مهم جدًا للفنان/المبدع، لأنه يتيح حرية تأملية وتجريبية.
ومن الناحية الإبداعية، هذا يعني أن الفنان يمكنه الاستفادة من هذه العلاقة الحميمة مع المكان لإنتاج صور، أفكار، وأعمال تُغذّى من ذاكرة وشعور المكان. المكان الإبداعي الحقيقي عند باشلار هو ليس فقط المكان المادي، بل "المكان الحي في الذهن": المكان الذي نألفه، نعيشه في خيالنا، ونحفظه في ذاكرتنا كجزء من ذواتنا.
فهل يمكن للمبدع أن يستدعي تلك الأماكن في فنه (لوحات، كتابة، تصميم، موسيقى …) لتكوين جو شعري، رمزي، عاطفي. سؤال كنا قد وجهته (المدى) لعدد من فنانينا بمختلف الأختصاصات .
الفنان يحيى الشيخ: «اللطلاطة» قرية تكرست للصابئة المندائيين وحدهم وخرجت منها بقوةً المستقبل.
ذات يوم وجدت نفسي طفلاً في على خاصرة دجلة جنوب العمارة، شمال قلعة صالح، قرية دخلت جغرافيا العراق لمئتي عام بقوة التاريخ، وخرجت منها بقوةً المستقبل. قرية تكرست للصابئة المندائيين وحدهم، عمرانها يتكون من اربعة وعشرين بيتاً طينياً بنيت على شارعين ترابيين بين النهر والمقبرة، بين برزخين متصالبين متلاحمين. اهلها كهنة شيوخ بلحى تبارك النهر كل صباح وتشطف وجهه، وصاغة مهاجرون تناثروا في البلدان بحثاً عن الرزق، وحدادون ذوو اكف عريضة خشنة متفحمة، نجارون تعلق بثيابهم نشارة خشب تفوح منه رائحة الراننج، وفقراء، وابناء متخلفون خَلقياً، وأرامل، ونساء حانيات على ارحامهن. كل هذا وسط طبيعة باذخة بخضرتها، ومائها، وحيواناتها الأليفة، والبرية، والخرافات. في الجهة الاخرى من النهر، وسط أشجار الغَرب، في الاكمات الكثيفة تعيش خنازير وحشية مهولة، ولصوص خطرين.
عشت في البراري، وكنت برياً بكل ما تمنحه البرية من صفات خام، ولم يكن باب البيت الواسع، مخلوع المفاصل، غير مدخل للنهر والحشيش والريح. كانت القبور المتاخمة للقرية تخفي أمواتاً يفوق عددهم عدد الأحياء، جدود واعمام وأقران، تآلفت معهم ولعبت بين قبورهم، فتحصنت طفولتي ضد الموت والخوف. في ذاك المكان نشأة وورثتُ الطبيعة البكر، التي ما فتئ ملمس ترابها وريحها بين اصابعي.
عرّفتني اختي ليلى، على الكتب في العاشرة من عمري، وكانت تقرأ لي عن موسيقيين ورسامين وفلاسفة، وكان جبران خليل جبران ربان السفينة التي ابحرت بي ولم ترس حتى اليوم. كتب مليئة بالحكايات الغريبة، والرسوم والاساطير وأنا بين دفتيها صبي مليء بالوحدة والضجر في مدينة حرمتني من بساتيني وأعشاشي وضفافي، فما أجمل ساعات القراءة، والرسم ونسيان الواجبات المدرسية!، حتى انتهى بي الحال عام 62 إلى اقل معدل لنجاح لا يجيز بدخول الجامعات العراقية. انذاك كانت ابواب اكاديمية الفنون الجميلة التي تأسست مستقلة عن الجامعة وخارج شروطها، مشرّعة لمن يجتاز امتحان الرسم، على غرار مدرسة الفنون الجميلة في باريس «بوزار»، فكانت ملاذي ومعبدي الاول الذي تكرست فيه نزعتي التجريبية، وعتبة مغامرات لم تنته حتى اليوم.
كما ولدت حراً في البراري بعيداً عن الطرق المعبدة، قيض لي أن اتعلم على أيدي اساتذة احرار نضجت تجربتهم وفاضت، تعبيريون وتجريديون: العراقي فائق حسن الذي أولاني عناية خاصة وأشرف على تدريبي، والبولوني رومان ارتموفسكي الذي زجني في أتون الكرافيك وفخرني كما يفخر الطين الخام، والمقدوني فيكتور لازسسكي، الذي ملكني شاقول القياس الجمالي على أسس معرفية مازلت أستعين به حتى اليوم . جازماً أقول إن هؤلاء نحتوا اعمدة الداخل، الذي اثثته بما سعيت إليه فيما بعد.
تقطعت حياتي وتوزعت سنواتي على الخارطة لثلاثين عاماً، وكانت صحراء نجد أول فرصة عمل تركتها بعد ستة أشهر بلا ندم، ثم البحرين التي سرقتُ بحرها وغادرت واللآلئ تملأ يدي، ثم لوبليانا شمال يوغسلافيا التي منحتني ما كان يعوزني من فن ومعرفة، ثم روسيا؛ امبراطورية الثقافة، التي عشقتها منذ صباي فنهلت من علمها ما استطعت، والشام التي اعادت لي طعم الشرق وتقشفه، ثم الصحراء العربية الكبرى؛ ليبيا، حيث عثرت على طلاسمي ولم يتبق لي غير الاستقرار والتفرغ لدرس وغربلة الحصاد. قال دوستفسكي ما يناسبني تماما «ظننتها سنيناً وتمضي، وإذا بها كانت حياتي».
الفنان التشكيلي صبيح كلش: صور حيوية لمناظر ومشاهد وأوجه تترقرق في الخيال كينابيع نورانية
في بواكير طفولتي، حين كانت الأيام ما تزال غضّة والرؤية تتشكل على مهل، انبثقت في ذهني صور حيوية لمناظر ومشاهد وأوجه تترقرق في الخيال كينابيع نورانية، دون أن أمتلك آنذاك أداةً للإمساك بها ، كنت أتابع بفضول فطري طيور الحقول، وبيوت القصب والطين، وأرسمها بين طيّات الذاكرة، بيد أنّ الألوان لم تكن قد استقرت بعد في يدي ، ثم جاءتني هدية صغيرة، علبة أقلام ملونة، أزالت عنّي حيرة التعبير وأخذت بيدي نحو العالم البصري ، أمسكُ بالأقلام فأحيلُ البيوت والأزهار والأشجار والطيور التي تجول في خاطري إلى خطوط وألوان فوق الورق، حتى بدت لي هذه المناظر واقعاً حياً نابضاً.
عندها، عملت بنصيحة مُحبٍّ: أن أرسم الأشجار والطيور في الحديقة المجاورة لمنزلنا، لأتوثّق أكثر من جمال الطبيعة وبلاغة تكوينها. ثم اندفعت أرسم وجوه الناس وملامحهم، متأثراً بأفلام كنت أراها وتترك في نفسي صدى، ولم يفتني التشجيع الذي تلقيته من الأهل والجيران والمحيطين بي، فازداد حماسي ورغبتي في تنمية موهبتي.
وفي المرحلة المتوسطة، وجدتُ في معلم التربية الفنية الراحل، الفنان شاكر حسن السعيد أباً روحياً ومرشداً حكيماً، إذ شجّعني على المضي قدماً، ومهّد لي الطريق نحو معهد الفنون الجميلة في بغداد، مؤسساً لبذور إبداعي التشكيلي.
وبعد التحاقي بمعهد الفنون الجميلة، توسع أفق معرفتي وعمق إحساسي بالتشكيل، فصرتُ عضواً فاعلاً في جمعية الفنانين التشكيليين ونقابة الفنانين العراقيين، وبدأتُ منذ عام 1970 أشارك في المعارض المحلية التي تقيمها الجمعية ووزارة الثقافة والمؤسسات الفنية ، وقد صقلت هذه المشاركات خبرتي وصقلت رؤيتي، فلم أنقطع عن حمل ريشتي ولا عن التجريب، حتى خلال فترة دراستي في كلية الفنون الجميلة ببغداد، حيث حازت أعمالي على استحسان النقاد والمهتمين بالشأن الفني والثقافي ، هذا التواصل المستمر مع المشهد الفني والبيئة الثقافية أثرى تجربتي وصقل موهبتي، حتى غدوت مؤهلاً لخوض تجارب أوسع، فسافرت لإكمال دراساتي العليا في مجال الفنون
الفوتوغرافي هادي النجار: صور حيوية لمناظر ومشاهد وأوجه تترقرق في الخيال كينابيع نورانية
المكان، الحيواة، الاحداث، النشأة والطفولة.. كل ذلك أسهم في ميلي الى الفوتوغراف، فقد ولدت في مدينة كربلاء المقدسة وفي وسط محلات كربلاء العتيقة وبوسط عائلة كادحة يعمل والدي نجارا وسط سوق منطقة باب السلالمة … لم يكن أي من افراد عائلتي او اقاربي يعمل في مجال التصوير الفوتوغرافي وكانت الشرارة عندما اهدت لي والدتي كا صور حيوية لمناظر ومشاهد وأوجه تترقرق في الخيال كينابيع نورانية ميرا صغيرة عند عودتها من رحلة الحج ولا ادري ما الذي دعا والدتي لاختيار هذه الهدية ربما كانت الكاميرا ذات قيمة كبيرة في حينها وكانت هي البداية وعلى ما اتذكر كان ذلك عام 1972 لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تعاملت مع الة التصوير حيث كانت العوائل تستأجر الة تصوير من محلات التصوير للقيام بتسجيل ذكرياتهم ولكن تلك الالة المهداة لي دفعتني الى المزيد من التعرف على اسرار الفوتوغراف واستهوتني كثيرا النتائج التي حصلت عليها ولم يكن من السهل الحصول على نتائج التصوير حيث عليك الانتظار لفترة طويلة والتردد على محل التصوير كثيرا ولعدة مرات لغرض الحصول على النتائج لذلك رغبت كثيرا بالقيام بعمليات الاظهار والتحميض للأفلام والطباعة بنفسي ولم يكن ذلك سهلا حيث كان يعتبر سرا من الاسرار التي لاتحصل عليها بسهولة ومع ذلك قمت بعمل غرفة مظلمة في سرداب البيت وهو افضل مكان للقيام بعمليات التحميض والطبع حيث سهولة الحصول على الظلام وكذلك العزلة عن بقية غرف البيت وبذلك تمكنت من القيام بكل عمليات الحصول على صورة وطبعا كانت كل الصور بالاسود والأبيض ولم يكن التصوير الملون متاحا في ذلك الوقت.
الفنان رياض عبد الكريم: البداية تحمل افكار فيها من الوعي والرؤية الفنية التي أتفاعل معها
النشأة الأولى، وعن الحيوات وأيضا المراجع والمصادر في تلك الفترة من حياتي جعلتني أميل الى الفن، بل وفتحت لي الافاق بذلك،
فالبداية تزامنت مع دخولي الدراسة المتوسطة، اذ ربما الاحداث والظروف السياسية التي عصفت بالبلد في ستينات القرن الماضي، وتواصل التظاهرات العنيفة اتي كانت تجوب المدينة ونجبر على الخروج فيها دون ان نعرف من هم منظميها، مما اثارت في نفسي عشرات الاسئلة التي لم اكن قادرا على اجابتها بسبب عدم اكتمال نضجي كوني كنت في عمر الثانية عشر من عمري الامر الذي حرك في دواخلي رغبة البحث عن الاجابات المغيبة والتي تتعلق بتفسيرات عن جدوى هذه التظاهرات ومعنى السياسية وماهي اهدافها والى اين تريد ان تصل، فلم يكن امامي للتعرف على كل ذلك الا من خلال الاكثار من أسئلتي لمن هم اكبر مني عمرا والتوجه لقراءة الكتب ومتابعة ما تنشره الصحف والمجلات، وفي العام 1966 انتقلت مع عائلتي الى بغداد بعد ان اكملت دراسة المتوسطة، واثناء دراستي الاعدادية توسع نطاق قراءاتي وتنوعت للتوغل في الفكر السياسي والادبي وعلم النفس والاجتماع والفلسفة ومتابعاتي للصحف والمجلات، ووجدت نفسي حينذاك منسجما ومتفاعلا مع تفاصيل العمل الصحفي ولحد ما منساقا اليه، لأنني ادركت ان مطالعاتي للصحف والمجلات تلامس قراءاتي للكتب او ربما جعلتني اتعرف اكثر على مضامين الكتب واسماء الكتاب وتوجهاتهم، وكانت لي نظرة خاصة على تصاميم المجلات تحولت بعد فترة الى اهتمام ورغبة واستشعار حس بداخلي يحفزني على ان اعيد تصميم بعض الصفحات، بعد ان اقصها من المجلة واعيد ترتيبها من جديد بلصقها على ورق بنفس مساحة المجلة، وكانت طريقة بدائية لكنها ترضي احساسي بأنني قريب من هذا المجال، الامر الذي دفعني لان ازيد من اقتنائي لبعض المجلات المحلية التي كنت اجدها ضعيفة جدا بالتصميم قياسا بالمجلات العربية منها المصرية مثل روز اليوسف، صباح الخير، المصور، اخر ساعة، واللبنانية مثل الصياد، الدستور، بيروت المساء، الشبكة، وانتقلت في مرحلة لاحقة للمجلات الاجنبية مثل نيوزويك، التايم، لايف، ناشيونال جيوغرافي، بيري ماتش، ايكونمست، واخرى غيرها، وكانت لهذا الاطلاع الاثر الكبير الذي منحني القدرة على التعرف على أساليب ومدارس التصميم الصحفي واضاف لي الكثير لما املكه من افكار كانت تتوهج في داخلي وهي بالرغم من انها كانت تشكل بداية متواضعة الا انني احسستها انها تحمل ثمة افكار فيها من الوعي والرؤية الفنية التي تنسجم مع الموضوعات وتتفاعل معها، اما البداية الثانية فهي دخولي قسم الصحافة في كلية الاداب جامعة بغداد، وفيه وجدت نفسي قد استكملت بداياتي وصارت مرتكزا لي لمواصلة الانطلاق مهما كانت التحديات وصولات الى مرتبات النجاح المتفوق.
الفوتوغرافي انور الدرويش: كان لمحلة القنطرة التي تؤطر ازقتها بقصص جداتنا وعبق المكان دفعتني للفوتوغراف
ولادتي في مدينة الموصل القديمة الساحل الايمن منطقة باب الجديد محلة القنطرة، ومنطقة باب الجديد قديمة عريقة انجبت العديد من الفنانين والمبدعين منهم الشاعر الكبير معد الجبوري والشاعر حيدر محمود عبد الرزاق والشاعر وليد الصراف والمسرحي الكبير بيات محمد حسين مرعي والموسيقار البارع خالد محمد علي والمطرب عامر يونس وآخرون لا يسعني الوقت لذكر اسمائهم ولقد كان لمحلة القنطرة التي تؤطر ازقتها وتحكي قصص جداتنا عن الزمان وعبق المكان بحياتها العفوية وبساطة العيش فيها الاثر الكبير في بناء شخصيتي الموصلية فالبيئة الموصلية عموما غزيرة بالموضوعات المختلفة والمشاهدات اليومية التي تساهم في خلق مناخ مناسب لتنمية المواهب – ولكوني نشأت ايضا من عائلة امتهنت الفوتوغراف
فعمي ابراهيم الدرويش فنان فوتوغرافي وثق اهم معالم مدينة الموصل في الخمسينات والستينات حتى مطلع السبعينان ومازالت صوره خالدة على مواقع التواصل الاجتماعي
ووالدي علي الدرويش، صاحب ستوديو فينوس ومصور مجلة الجامعة منذ العدد صفر حتى توقفت بسبب الحصار … بالتأكيد كان لوالدي الفضل الكبير لميلي الى هذا الفن وبناء شخصيتي الفوتوغرافية فمنذ طفولتي وانا في المرحلة الابتدائية كنت ارافقه الى الاستوديو في العطل الصيفية واتعلم منه ابجديات العمل في مهنة التصوير مثل غسل الافلام الاسود والابيض وتحميضها وطباعة الصور بالمحاليل اليدوية
الفنان التشكيلي عاصم عبد الأمير: أجواء المقاهي القريبة للمنزل في الدغارة كانت النماذج التدشينية التي بدأت بها
ثمة نزعة استعادية في رسومي بالإجمال وإن حدثت ازاحات بنيوية فلأنها تساير موقفي الثقافي والانساني إزاء ما يحدث في عالمنا المحيطي. بداياتي الفنية ترجع إلى مرحلة التأسيس الأولى حين كنت طفلاً ثم صبياً في ناحية الدغارة – الديوانية، تملكني هاجس المغايرة مع أقراني، إذ كنت أجيد الخط والرسم والغناء والتمثيل، ملكات كهذه تتزاحم كي تجد طريقها إلى الاظهار، لكن هاجس الرسم والكتابة والغناء لم يتراجع وإن غدا الرسم والكتابة في صميم شغفي، حيث ولدت في بيت من الطبقة الوسطى فيه مرسم ومكتبة، وكان أخي الكبير راسم ملهمي الأول، وهو المثقف والمترجم، كذلك أخي د. باسم الأعسم الناقد المسرحي المعروف.
كنت يومها أجاري رسوم من تقع عيناي عليها منها رسوم فائق، رمبرانت، ورسوم البورتريه في مانشيتات الأفلام العالمية والهندية ونماذج من الدراسات الواقعية للوجوه والحياة الجامدة والحيوانات المتوفرة في مصادر معدة لهذا الغرض.
منذ تلك السنوات، أدرت أنّ شيئاً ما سيحدث انقلاباً في شخصيتي المنجذبة لعالم الفن، بذلت جهدي برسم الكثير من الشخوص وأجواء المقاهي القريبة للمنزل مع السوق القديم في الدغارة، وبدت هذه النماذج التدشينية تعجب الأصدقاء، وعند اتمامي الدراسة المتوسطة اتجهت لمعهد الفنون – بغداد عام 1971، وقد أثنى الأساتذة على رسمي لنموذج جبسي يمثل فينوس وقبلت على الفور، لكن المانع كان نقص شهادة الجنسية التي لم تكن يومها بالسهولة المتوقعة فعدت أدراجي إلى ثانوية الدغارة، وقد اشتد عودي فيها بفعل أستاذة ملهمين لي منهم (باسم عبد الحميد حمودي، عقيل الأوسي، راسم الأعسم، رسول عبد الحسين). وأقمت معرضاً شخصياً على قاعة الاعلام في الديوانية عام 1972 ضمَّ العشرات من رسومي، وقد أثارت اهتماماً في الوسط الفني والثقافي، يومها كانت الدغارة تعج بالتيار اليساري والحوارات الثقافية، وهي المدينة التي يشطرها نهر الحلة إلى نصفين وعلى ضفتيه تلوح مشاهد النخيل والطبيعة بتحولاتها، حيث تشكلت طفولتي هناك، ومثلت تلك السنوات خزاناً رمزياً لصور شتى، هي الآن تمثل فصلاً من فصول مرجعياتي الجمالية والرمزية.
لقد زودتني تلك السنوات بمزيد من المشاهد التي لم تزل غير قابلة على المحو منها مشاهد الرعي ولعبة جر الحبل، وعازف الناي، والبيوت الآمنة المحاطة بالبساتين وحوارات الأصدقاء، ومشاهد التشابيه الحسينية، وحفلات الغناء، والعروض المسرحية، على قاعة مدرسة صلاح الدين، وما إلى ذلك.
بدت لي الدغارة فضاء لا نهائي مدني بطاقة إيجابية، يوم كان العراق، أمضى مدنية، وأبعد ما يكون من مظاهر النكوص الطائفي، الذي لم نكن نعرف عنه شيئاً. فإلى جوارنا كان لي صديق يهودي، وأقرب منه صديق صابئي، وتشكلت حينئذ خطواتي في عالم الرسم والكتابة بشكل متوازٍ، وبت أتجرأ بنشر أولى مقالاتي في صحيفة الراصد.
مع اتمامي للدراسة الاعدادية جذبتني أكاديمية الفنون الجميلة، حيث قبلت فيها عام 1974 وكانت مرحلة تمثل انقلاباً في سياق رؤيتي الفنية والشخصية والثقافية على السواء، لاسيما وأن أساطين الفن العراقي كانوا هناك ونهلت منهم الكثير، وقد حولوا الأكاديمية إلى ورشة إبداع في الرسم والنحت والسيراميك والسينما والمسرح. تتلمذت يومها على أساتيذ الرسم منهم (فائق حسن، خالد الجادر، حافظ الدروبي، فرج عبو، محمد غني حكمت، صالح القره غولي، اسماعيل الترك... الخ)، أربع سنوات من تراكم الخبرات والوعي المضاف ومشاهدات لا تحصى للمعارض والمسارح والسينما كفيلة بأن تبقي الشغف الفني في أقصى مدياته، يومها كان أستاذي فائق حسن يشجعني على إكمال دراستي العليا، وقد فعلت وقبلت على الفور، وأذكر حادثة لا تنسى، حين انقلبت المنشأة بركابها أثناء عودتي من بغداد وكسر عظم الترقوة، وامتحان الاختبار في العليا ليس ببعيد، جلبت رسومي الكثيرة، وبالكاد كنت أرتبها كي تخضع للتقييم، وعند دخول أستاذي فائق قال بصوته الجهوري: « هاي شجاي اسوي.. شيل الأعمال. مقبول «. ثم كانت رحلة الماجستير التي لا تنسى أيضاً. ازددت فيها ثراءً معرفياً وتطبيقياً حيث كتبت المزيد من المقالات في الصحف والمجالات العراقية، منها الأقلام، الطليعة الأدبية، آفاق عربية، الجمهورية، القادسية، أسفار... الخ. وأسهمت بتأسيس جماعة الأربعة مع (فاخر محمد، حسن عبود، والراحل محمد صبري) التي أقامت معرضها الأول على قاعة (كولبنكيان عام 1981) وقد وجد الجمهور فيه جيلاً جديد لديه ما يقوله.
مرَّ المعرض بسلام وكتب من كتب، وتجاهله آخرون، لكن الأربعة لم تكن حدثاً عابراً في ركب الفن العراقي، لهذا استمرت لتسعة معارض متتالية في بغداد، وابو ظبي. كنا جماعة وجدت نفسها على حين غرة في أتون حرب لا معنى لها أحرقت الأخضر واليابس ودفعتنا في هوة سحيقة قوامها الرعب والدم والخوف.
هل المكان بنية مادية؟ الفنان يستعيد مشاعر وأحاسيس الأماكن الماضية حتى لو غادرها

نشر في: 18 نوفمبر, 2025: 12:01 ص