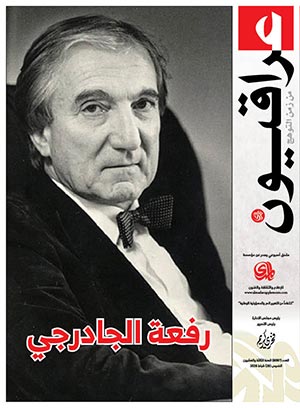طالب عبد العزيز
كثيراً ما سُئلتُ عن طقوسي في الكتابة؛ وكنتُ أجيبُ بأنني أفعل كذا وكذا، وفي كلِّ مرةٍ تختلف أجوبتي، لأنني سريعاً ما أنسى ماذا كتبتُ، وبمَ أجبتُ! لكنني، في حقيقة الأمر، لا أملك طقساً معيناً للكتابة، ثم، لماذا نسمّيه طقساً في الأصل؟ الكتابة مثل أيّ سلوك يومي، متغيرة بحسب ترتيب ساعات اليوم الذي نعيشه، كلُّ ساعة مختلفة عن الأخرى، وما نحنُ إلا نسيج الساعات تلك، لذلك أجدني أكتب السطر والسطرين بحسب مزاج اللحظة التي أنا فيها، فأنا أقرأ كثيراً، نعم كثيراً، وأشاهد أفلاماً كثيرةً في تقليد شبه يومي، وحياتي متقلبة، وبائسة أحياناً، لكنني قادرٌ على إدارتها بالطريقة هذه أو تلك، حتى ليبدو لي أنَّ الشعرَ معينٌ كيميائي، أو مرشدٌ عبقري؛ يضعُ خطواتي في المكان الصحيح دائماً، وإن بدا فيها ما يشبه الفوضى، أو هي الفوضى بعينها، لكنها التي أريدها.
هو محمود البريكان الذي يقول: "في سكون الليل إذْ ينتصتُ/ يمكنُ للإنسان أنْ يعترفَ/ بذلك الرعب الذي ليس له ألوان"، وهو الذي يقول: "تأرجحُ المشانقِ في فتنة الشفق." هل في ما يكتب الآخرون شيءٌ من التناسق أدقَّ من هذه التشكيلة المخيفة والمرعبة، التي تجمع بين الجمال والقبح، بين الطمأنينة والرعب! لكنْ حقاً: كيف يكون لون الرعب؟ ومن بيننا بمستطاعه أن يستخلص لوناً له؟
لا اسمَ لك؛ أنت قبّعةٌ فقدتْ رأسها/ والرسمةُ التي ظهرتَ فيها لا تدلُّ عليك/ كان السرورُ جدولاً، ها أنت تردِمُهُ بتجهمك/ لا ينبغي أنْ تبتدئ؛ أنتَ خاتمة/ تكتبُ قبحكَ بتردادها اليومي عربةُ النفايات/ إنْ أردتني لغدك كن طائرَ البلشون الذي يرافق آلةَ الحراثة. الخديعةُ تبهرُ الأحمقَ، مثلما تبهرُ قطعةُ اللحم المسمومةِ الكلبَ. كان جويس يقول: علينا أنْ نتفق بأنَّ اليهوديَّ اليونانيَّ هو اليونانيُّ اليهوديُّ، لكنَّ أثينا ليست أورشليم.
الطريق إلى هناك ما تزال تراباً، والبنفسجُ حتى أمسِ بقبضة النسيم، يأتي من البحر الذي كان بحراً. أريدُ أنْ أردَّ البذورَ إلى ما كانت عليه قبل الخريف، فالكثير من الأمل يجعلُ الطريقَ أطولَ، والأعمدةَ أكثر قرباً والتصاقاً، أنا هنا لكي يظلَّ النهرُ بموجٍ أزرقَ ناعماً، دائماً، وفي أيِّ لغةٍ؛ ثمة كلمةٌ لم تستوفِ حقّها بعد. أخبرني إذا جئتَ، فأنا أتضورُ عشقاً، ليست الدموعُ ما تجعلني كاذباً، هناك روائحُ صادقة لا تمتُّ للورود بصلة، كذلك تكون نزلةُ البرد، وكَنبتةٍ مُدرَّبةٍ أخذتُ عنكَ ابتسامةَ الصباح الكاذبة.
قرأتُ مرةً في ما قرأتُ؛ أنَّ امرأةً عمياء لم تفطنْ أنَّ قلمها نفدَ من الحبر، وحدثَ أنَّها كتبتْ مقدمةَ روايتها؛ لكنَّ أحداً لم يخبرها بأنَّ الصفحةَ كانت فارغةً. سأتذكرُ بأنني كتبتُ إحدى قصائدي ليلاً في حافلة أطفأ السائق أنوارَها، على ورقة كنتُ أخرجها كلما عنَّ شيءٌ لي، فأنا أكتبُ ولا أرى، أخرج الورقةَ وأدسها.. حتى إذا صرتُ إلى البيت وأردتُ لها أن تكون لم تكن. لا أعرف لماذا أجدني ملزماً هنا بما كتبه هيدجر عن الإله، وهو ينفي عنه صفة الإمبراطور كما تقترحه الميثولوجيا، حيث يقول: "هو صوتٌ صارخٌ في البريّة، صوتٌ لا يمكنه أن يبوح حتى نصغيَ له" أو "على الملكوت الآتي أنْ يُمكننَا من أنْ نسكنهُ شعرياً." لم يكن هيدجر، بحسب ريتشارد كيرني، وبترجمة مازن محمد، معنياً بوجود الإله أو عدمه، إنّما بحضوره وغيابه".
في مجلس عزاء حفيدي مصطفى كنتُ أنظرُ بعينيَ ابني أحمد (والده) وهو يبكي، لا بعين الأب المفجوع بولده، إنّما بعين الابن الذي يؤنّبه أبوه (أنا) على فعلٍ شائن. ياه، ما أقسى أنْ يبكي ابنُك لفقدِ ابنه. أرأيتم طفلاً يبكي مفجوعاً بفقد دميته؟ كان أحمدُ كذلك والله. لسببين لا أكثر؛ أكادُ أجزمُ بأنَّ الإنسانَ أضعفُ مخلوقٍ على وجه الأرض! الأولُ لأنَّه لا يعي ضعفه؛ والثاني لأنَّه الكائن الوحيد الذي لنْ يرى نفسه ميتاً! من يريد أن يتعرف على حقيقة ضعفه تلك، فليدخلْ مغسلاً، وليُقَلِّبْ بناظره مع الميتِ المسجّى هناك؛ أيَّ ميت، كبيراً بأوسمةٍ ونياشين، أو معظمّاً، غنياً بأموالٍ وضياع، وجيهاً مفوّهاً أو شجاعاً مفتولَ العضل، أو مجرماً لم تطله يدُ السلطات… هناك؛ في الموقع ذاك حسب؛ تتجلى حقيقة الإنسان.
في مُدلَّهمٍ من الأرض أعرفه، بسافل عبادان؛ حيث لا قريةَ تلوح، وحيثُ الماءُ عربيّاً ومحلّى بقصبٍ وأسماكٍ يأتي من الكارون، لكنْ، لا حجرَ يؤنسُ الحجرَ هناك. أيّها الحجرُ الغريبُ، مثلك أنا أبحث في الهواء عمّن يُشبهني، وفي الظلام عن يدٍ تمتد لي. مثلك أنا في ما أفترضه متنزهاً، أجلسُ وحيداً، هاتفي لا يرنُّ، وحذائي يبلى، ولا تبصرُ عيني إلّا ما كان ريحاً ونجوى. كتبتُ ما لا أعدّدهُ أمكنةً وأسماءَ وأزمنةً، تعني الناس كلّهم إلّا أنا، فقد كنتُ وحيداً كنتُ وأعزلَ من ذلك.