" القسم الاول "
بغداد/ المدى
قدّم رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون فخري كريم رؤية نقدية لمسار العراق السياسي بعد إسقاط صدام حسين، متناولًا الأخطاء التي رافقت مرحلة التحول الديمقراطي، ومبينًا أن الاعتراض على الانتخابات لا يعني رفض الديمقراطية، بل الاعتراض على النظام السياسي «المشوّه» الذي نشأ بفعل طريقة إسقاط النظام وتحويل المعارضة العراقية من قوى وطنية إلى تشكيلات مذهبية وعشائرية.
وجاءت هذه الأفكار في حوار تلفزيوني بُثّ على جزئين أجرته معه قناة «شمس» الفضائية، ننشر في هذا العدد القسم الأول منه، على أن يُنشر القسم الثاني في الأعداد القادمة.
الديمقراطية وُئدت منذ لحظة إسقاط صدام
استُهل اللقاء باستغراب وجهه المحاور إلى فخري كريم حول اعتراض الاخير على الانتخابات الأخيرة، واوضح كريم أن الديمقراطية تبقى «حقًا لا يمكن لأحد الاعتراض عليه»، مؤكدًا أن العراقيين كانوا يأملون أن يقود سقوط صدام حسين إلى «نظام ديمقراطي ينهي عقودًا من الاستبداد والإقصاء»، لكن هذا الأمل اصطدم بعقبات عميقة قادت إلى الوضع السياسي الراهن.
وأوضح أن أبرز تلك العقبات كانت «طريقة إسقاط صدام حسين»، مبيناً أن المعارضة كانت تسعى لإسقاط النظام بأدوات عراقية وبمساندة المجتمع الدولي، إلا أن تلك المحاولة لم تنجح بسبب القمع والاستبداد الذي مورس بحق القوى المعارضة. وأضاف أن النقاش حول إمكان إسقاط النظام بوسائل داخلية «حديث طويل» يعود إلى بدايات العمل المعارض.
وأشار كريم إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا، ومعهما دول إقليمية، لعبت دورًا مباشرًا في تعطيل إرادة المعارضة الوطنية، وقال: «الولايات المتحدة جرّدت المعارضة من أدواتها الأساسية، وحولتها إلى أحزاب مذهبية وعشائرية ومدينية وحتى محلية، وهو ما نعاني منه اليوم».
وأضاف أن أجهزة الاستخبارات السورية والإيرانية والسعودية، وبإشراف المخابرات المركزية الأميركية، كانت تتدخل في إدارة المعارضة، وهو ما أدى إلى تشويه بنيتها الوطنية الأصلية وإضعاف قدرتها على إنتاج مشروع ديمقراطي حقيقي بعد سقوط النظام، مؤكداً أنه يقول ذلك «بكل صراحة».
الاحتلال كرّس فراغ السياسة
قاطع المحاورُ حديثَ فخري كريم معتذراً، ليطرح نقطة وصفها بالمهمة، مشيراً إلى أن حديث كريم يبدو وكأن الولايات المتحدة هي التي «اخترعت» التيارات الدينية والقيادات التي وصلت لاحقاً إلى الحكم. أجاب فخري كريم، موضحًا أن ما يجري اليوم ليس صناعة أميركية خالصة، بل نتاج عقود من الدكتاتورية التي أفرغت الحياة السياسية من قواها الديمقراطية. وأكد أن الولايات المتحدة، بعد 2003، عمّقت هذا الفراغ عبر استبعاد الأحزاب الوطنية وإعادة تشكيل المشهد عبر «شخصيات لا تمتلك أي صلة حقيقية بالواقع العراقي».
وتابع قائلاً: ان واشنطن استفادت من واقع أنتجته عقود من القمع. وقال إن النظام السابق قضى على الحياة السياسية عبر السجون والتعذيب والملاحقات، ما أدّى إلى «تجريد المجتمع من قواه الفاعلة القادرة على التعبير عن إرادته».
وأضاف أن المعارضة التي تشكّلت في الخارج - بوجوهها القومية والديمقراطية والدينية - تعرضت أيضًا للتفكيك، مشيرًا إلى أن مسؤولين أميركيين وإقليميين «أكدوا صراحة أن أي تغيير في العراق يجب ألّا تقوده الأحزاب، وأن يُعبَّر عنه بشخصيات محددة، ما أدى إلى تراجع دور القوى الوطنية».
وأوضح كريم أن الولايات المتحدة اشترطت أن يكون «المؤتمر الوطني العراقي» هو الواجهة السياسية بعد إسقاط النظام، قائلاً إنه كان «مرتبطًا مباشرة بالمخابرات الأميركية تمويلًا وإدارة».
وتابع أن الخلافات المبكرة بين القوى الأساسية - الحزبين الكرديين الرئيسيين، المجلس الأعلى، وإياد علاوي وأحمد الجلبي - منعت تشكيل حكومة وطنية موحّدة بعد سقوط النظام، ما دفع الولايات المتحدة إلى «مكافأة» هذا الإخفاق بتحويل «التحرير» إلى «احتلال» رسمي.
وأشار كريم إلى أن بول بريمر، الحاكم المدني للعراق، بدأ بتشكيل مجلس الحكم عبر اختيار شخصيات «لا تملك معرفة حقيقية بالعراق»، مستدلاً على ذلك بقصة رواها عن زيارة بريمر إلى كردستان للقاء مسعود بارزاني، حيث سأل بريمر أحد مرافقيه: «هذا مَن؟»، في إشارة إلى جهله بشخصيات سياسية محورية.
وأكد أن بعض الشخصيات التي اعتمد عليها بريمر «كانت محترمة على المستوى الشخصي لكنها بلا تأثير سياسي»، بينما ظلّ اللاعبون الفعليون محصورين بالقادة الأربعة: مسعود بارزاني، جلال طالباني، إياد علاوي، وعبد العزيز الحكيم.
بول بريمر كرّس انهيار الدولة
كرر فخري كريم للمحاور، تأكيده كريم أنه «لا يعترض على الانتخابات»، بل يعتبرها المسار الطبيعي لأي انتقال ديمقراطي، لكنّ العراق كان دولة منهارة بالكامل بعد عقود من الاستبداد، ما تطلب مرحلة انتقالية حقيقية لم تتحقق. وقال إن العراقيين لم يعرفوا سوى صورة صدام حسين وحزب البعث طوال «خمسة عقود مظلمة»، ما جعل المجتمع بحاجة إلى وقت طويل لإعادة بناء حياته السياسية.
وأشار إلى أن العدالة الانتقالية كانت غائبة تمامًا، إذ لم يُسنّ أي قانون لمعالجة إرث النظام السابق، واستُعيض عنها ببرنامج «اجتثاث البعث» الذي أدّى إلى نتائج خطيرة. وأضاف أن المحاكمات تجاهلت القضايا الكبرى التي كان يجب أن يحاكم عليها صدام حسين، ومنها عمليات الإبادة في كردستان وتصفيات قيادات البعث نفسها، ما أدى إلى «تمييع الجرائم التاريخية».
وحمّل كريم بريمر جزءًا كبيرًا من المسؤولية، خصوصًا في قراره حلّ الجيش، واصفًا ذلك بأنه «يشبه تنفيذ إعدام بميت»، معتبرًا أن الجيش كان شبه مفكك أصلًا، وكان ينبغي إعادة ضبّاطه وجنوده وإعادة تشكيله بصورة سليمة، بدل بناء قوات جديدة من «فضلات مؤسسات منهارة».
وأوضح أن الظروف السياسية والاجتماعية لم تكن ناضجة لإجراء انتخابات حقيقية، خاصة أن المنطقة بأكملها كانت تعيش حالة «هلع استراتيجي» بعد تهديد الولايات المتحدة بنقل «الديمقراطية» إلى سوريا ودول أخرى، ما دفع العديد من الأنظمة إلى «صب النار على العراقيين».
وانتقد كريم الحملات العربية الإعلامية التي استهدفت الشيعة، ووصفتهم بأنهم «غير وطنيين» و«فرس» و«روافض»، معتبرًا أن ذلك ساهم في خلق شعور عميق بالاستهداف، حتى لدى الشيعة غير المتدينين واليساريين، ما أدى إلى استقطاب طائفي خطير.
وأشار إلى أن إيران بدورها عمّقت هذا الاستقطاب عبر تصوير سقوط صدام بوصفه «مكسبًا إيرانيًا»، وهو الخطأ نفسه الذي حدث في انتفاضة آذار عام ١٩٩١، حين رُفعت شعارات أعطت انطباعًا خاطئًا بوجود دعم إيراني مباشر، مما دفع الولايات المتحدة وحلفاءها إلى التردد في دعم إسقاط النظام آنذاك.
أوضح كريم أن اعتراضه على الانتخابات لا يرتبط برفض فكرة الاقتراع، بل بكون «الصيغة والتركيبة والقرارات» التي تأسس عليها النظام السياسي منذ 2003 قادت إلى انسداد تاريخي. وقال إن بريمر «تصرف كما لو أنه يدير بلدًا أوروبيًا خرج من الحرب العالمية الثانية»، فأنشأ مؤسسات بنمط غربي لا يمكن إسقاطه على عراق تهيمن عليه آثار الدكتاتوريات.
وأشار إلى أن بريمر حاول بناء مؤسسات شبيهة بالنموذج البريطاني، مثل هيئة الإعلام والاتصالات «بصيغة البي بي سي»، رغم أن البيئة العراقية لم تكن مهيأة لذلك. وبيّن أن المقارنة بين العراق وألمانيا «مضللة»، فالأخيرة كانت بلدًا صناعيًا متقدمًا يمتلك مؤسسات راسخة قبل هتلر، بينما العراق خرج من نصف قرن من الخراب السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ورأى كريم أن المشكلة الأعمق لا تكمن في تفاصيل العملية الانتخابية، بل في «عدم فصل الدين عن الدولة» في المنطقة. وأضاف: «هذا ليس موقفًا أيديولوجيًا بقدر ما هو حقيقة تاريخية. الدول التي تقدمت فصلت الدين عن الدولة، وألمانيا مثال واضح. هناك يحتضنون كل الأديان والمعتقدات، شرط أن لا تتدخل في شؤون الحكم».
وأكد أن محاولات تشويه مفهوم العلمانية استمرت لعقود طويلة، وأن ربطها بعداء الدين «هو تضليل»، مشيرًا إلى أن العلمانية لا تعني معاداة الإسلام، بل حماية الدين من توظيف السياسة وحماية الدولة من احتكار المقدس.
وختم كريم هذا المحور قائلا بأن تجاوز هذا الإرث يحتاج «إرادة تطور موضوعي وذاتي»، وأن الحديث عن ديمقراطية حقيقية في ظل هذه البنية «مجرد وهم».
دعم المواقف العادلة لا يعني خلط الدين بالسياسة
اشار فخري كريم إلى أن المرجعية الدينية العليا ممثلة بالسيد السيستاني كانت أوضح من الجميع عندما حذّرت مبكرًا من تدخل رجال الدين في السياسة، ثم انسحبت إلى الدور «الإرشادي» بعد اكتمال مؤسسات الدولة.
وبين أن «السيد السيستاني منذ الأيام الأولى بعد سقوط النظام حذّر رجال الدين من التدخل في السياسة، ونبّه إلى ضرورة عدم دخول المعممين في العمل الحزبي». وأشار إلى أنه في لقاء سابق مع المرجع الأعلى، شكا له آثار الفساد والاستحواذ على السلطة، فردّ السيستاني بالقول إن المرجعية تدخّلت سابقًا لأن البلاد لم تكن تملك دستورًا ولا حكومة ولا رئيسًا، أما الآن «فثمة برلمان ودستور وحكومة ورئاسة جمهورية، والمرجعية عادت إلى مهمتها الإرشادية».
واضاف كريم أن هذا الموقف كان ثابتًا عبر السنوات، مشيرًا إلى أن خطب الجمعة التي تُلقى عبر وكلاء المرجعية في كربلاء تناولت كل مظاهر الخلل والفساد، حتى بلغ الأمر مرحلة توقّف المرجعية عن استقبال السياسيين بسبب فقدان الأمل بإصلاحهم.
وتابع قائلا: «قلتُ ذات مرة إن محمد رضا السيستاني لو أصبح رئيسًا للوزراء ربما نضمن صوتًا عاقلاً يعبّر عن كيفية تصرف الشيعة والدولة عمومًا، لكن المرجعية كانت وما زالت ترفض هذا المنطق، لأنها ترى الدين خارج السياسة».
وسأل المحاور عن كيفية لجوء بعض المثقفين والشيوعيين إلى مرجعيات دينية لتثبيت آرائهم، متسائلًا عن التناقض الظاهري بين الفكر الشيوعي والمواقف المؤيدة لرجال دين يحملون مشروعًا عقائديًا أو سلاحًا، واستشهد بمواقف شيوعيين لبنانيين عبّروا عن ارتياحهم للسيد حسن نصر الله.
أجاب فخري كريم بأن الشيوعي «يَحترم الرأي الآخر ويحترم كل العقائد والأديان»، معتبرًا أن الإيمان علاقة شخصية بين الإنسان وربه، بينما الدولة يجب أن تكون «حاضنة للجميع». وأوضح أن المؤسسات الدينية—كما عبّر عنها السيد السيستاني—مهمتها الإرشاد والتعليم والمتابعة الأخلاقية، لا التدخل في إدارة الدولة.
وقال كريم إنه لا يلغي الآخر، لكنه يرفض «التركيبة المشوّهة» التي حاول البعض عبرها إيجاد خلط قسري بين الإسلام والاشتراكية أو بين القومية والاشتراكية، في إشارة إلى محاولات فكرية قام بها عدد من المفكرين الشيوعيين العرب واللبنانيين.
وأشار إلى أن تقييم المواقف الدينية يجب أن يكون قائمًا على أثرها الاجتماعي والوطني، مضيفًا: «حين تتخذ شخصية دينية موقفًا لصالح الناس والعدالة والتسامح، فمن الطبيعي دعم هذا الموقف». وروى لأول مرة حادثة مرتبطة بنقاش مع القائد الإيراني الراحل قاسم سليماني، قال فيها إنه تحدّث عن السيد حسن نصر الله باعتباره «قائد المقاومة الوطنية في لبنان ضد الاحتلال الإسرائيلي»، وأن صوره كانت تُرفع في العواصم العربية في تلك الفترة.
لكن كريم أوضح أن هذا الدور تبدّل عندما «دخل حسن نصر الله إلى بيروت الغربية وتحوّل إلى طرف طائفي»، معتبرًا أن ذلك أنهى صورة القائد الوطني الجامع، مضيفًا أن دعم مقاومته ضد الاحتلال «موقف لا يختلف عليه اثنان»، لكنه شيء مختلف تمامًا عن دعمه حين يتحول إلى جزء من صراع داخلي.
أريد محاسبتهم الآن، لا في القيامة
طرح المحاور سؤالًا حول التناقض الظاهر بين الفكر الشيوعي - بوصفه تيارًا علمانيًا - وبين استشهاد بعض الشيوعيين واليساريين بشخصيات دينية أو مرجعيات عقائدية، مستفسرًا عن كيفية التوفيق بين عقيدة سياسية حديثة وجذور دينية قديمة، ولاسيما في مجتمعات عربية انتصرت فيها التيارات الدينية انتخابيًا كما حدث مع الإخوان المسلمين في مصر.
فخري كريم رفض هذا الافتراض باعتباره تبسيطًا مخلًّا. وقال إن الشيوعي «يحترم العقائد ويحترم إيمان الناس»، ولا يرى في الدين خصمًا، بل يعتبر أن الإيمان علاقة شخصية بين الفرد وربه، بينما الدولة يجب أن تبقى «حاضنة للجميع». وأوضح أن المرجعيات الدينية، كما صاغها السيد السيستاني، ليست سلطة سياسية، بل مؤسسات إرشاد وأخلاق ومعرفة، وليس من دورها أن تحكم أو أن تُنتج سلطات.
وتوقف كريم عند مقولة ماركس الشهيرة «الدين أفيون الشعوب»، التي تُستخدم عادةً لاتهام الشيوعيين بالعداء للإسلام، مؤكّدًا أنها انتُزعت من سياقها التاريخي. فقد قالها ماركس وهو يراقب الكنيسة الكاثوليكية في زمن كانت تبيع فيه «صكوك الغفران»، ولم تكن المقولة موجّهة إلى الإسلام أو إلى الدين بمعناه الروحي، بل إلى استغلال المؤسسة الدينية لمعاناة الفقراء.
وانتقل كريم إلى التاريخ الإسلامي ليؤكد أن الإسلام الأول، في قيمه الجوهرية، حمل مشروعًا أقرب إلى العدالة الاجتماعية التي يناضل من أجلها اليساريون. واستشهد بأبي ذر الغفاري، الذي دفع حياته ثمنًا لمواجهته السلطة الأموية بسبب مواقفه من الفقر والغنى الفاحش، ووصفه بأنه «من أوائل رموز اليسار في الإسلام». وذكر عمار بن ياسر، والإمام علي، والإمام الحسين، بوصفهم شخصيات حملت قيم المساواة ونبذ الظلم، وواجهت انحراف السلطة.
وأوضح كريم أن ثقافته الأولى كانت دينية بحتة، إذ حفظ القرآن بتلاوة عبد الباسط عبد الصمد، وتعلّم من «نهج البلاغة» ما يعتبره «مدرسة أخلاق سياسية»، مشيرًا إلى أن معظم القادة الذين يتزينون بصور التراث الديني «لم يقرأوا من هذه الكتب إلا عناوينها». وروى حادثة الإمام علي الشهيرة حين وقف أمام القاضي في دعوى مع رجل يهودي، فحكم القاضي لخصمه لأنه لم يُقِم الدليل، معتبرًا أن هذا الموقف «جوهر العدالة الحديثة، قبل أن تُصاغ قوانين العدالة نفسها».
وأكد كريم أن استشهاد اليساريين بشخصيات دينية أو أخلاقية لا يعني خلط الدين بالسياسة، ولا تبريرًا لحكم ديني، بل هو استحضار للجانب الإنساني التقدمي الموجود في التراث. وقال: «حين تتخذ شخصية دينية موقفًا لصالح الناس والعدالة، فمن الطبيعي تأييد هذا الموقف. دعم القيم لا يعني دعم مشروع السلطة الدينية».
وختم كريم بالقول إن «القيم التي يدافع عنها اليساريون موجودة في جذور الإسلام الأولى، وفي تراث إنساني ضخم، ومن واجب المثقف أن يستعيد هذا المعنى بعيدًا عن توظيف الدين سياسيًا». وأضاف بابتسامة ساخرة: «رجال الدين أنفسهم اليوم، على وسائل التواصل، يصفون الطبقة الحاكمة بأنها لصوص سيحاسَبون في الآخرة… وأنا أريد محاسبتهم الآن، لا في القيامة».
أراجع أخطائي بجرأة…
انتقل الحوار مع فخري كريم إلى مساحة شديدة الخصوصية، حين سُئل عن المراجعات الذاتية التي ظهرت في مقالاته خلال السنوات الأخيرة، وعن ما إذا كانت تعبيرًا عن ندم أم مجرد تقييم نقدي لتجارب سياسية مرَّ بها.
استهل كريم حديثه بالإشارة إلى الوصف الذي أطلقه عليه مسعود بارزاني في مذكراته حين نعته بـ«صديق الشعب الكردي»، موضحًا أن هذا التوصيف لم يكن مبنيًا على انتماء قومي، بل على موقفه الفكري والسياسي المؤيد لحقوق الشعب الكردي. وأضاف: « أنا لست قوميًا، وهذه حقيقة أقولها بصراحة « .
ثم ذهب مباشرة إلى النقطة الحساسة: " نعم، ارتكبت أخطاء غير قليلة. والندم لا يعيد التاريخ، لكنه يمنع تكرار الكارثة» .
وشرح أن أول الأخطاء الكبرى جاءت بعد سقوط النظام مباشرة، حين وجد نفسه - مع قوى سياسية أخرى - أمام واقع مُجهد، ووسط فراغ سياسي هائل، وضغوط إقليمية ودولية لا تُحتمل. وقال إنه لم يكن يومًا مع الحرب أو الاحتلال، ولم يستقبل القوات الأميركية «على الدبابات» كما حاولت بعض الأقلام المهاجمة أن تروّج. وأضاف بأن حملة التشويه التي يشنها «ذباب الطبقة الحاكمة» لا تستند إلى شيء إذا ما قورنت بمقالاته القديمة التي انتقد فيها بريمر والاحتلال بشكل مباشر وواضح.
وتوقف عند تجربته داخل رئاسة الجمهورية، موضحًا أن دخوله هذا الموقع لم يُغيّر قناعاته ولا سلوكه. فقد رفض الراتب والمخصصات حين صدر مرسوم تعيينه ممثلًا شخصيًا وكبير المستشارين للرئيس الراحل جلال طالباني. ويروي أنّه بعدما قرأ المرسوم قال لطالباني: «أعتذر… عدّلوها إلى: يُعامل بصفته ممثله». وحين سأله طالباني عن سبب رفضه، أجاب: «أولًا لن أتقاضى راتبًا، وثانيًا احترامًا لموقعك، وثالثًا لن أقوم بعمل يتقاطع مع مبادئي».
ثم انتقل إلى ما وصفه بـ«الخطأ الأكثر تأثيرًا» في مسار العراق السياسي: موقفه من إياد علاوي بعد انتخابات 2010. قال إنه وقف بوضوح مع فكرة «الكتلة الأكبر» وفق تفسير المحكمة الاتحادية، وهو ما أدى عمليًا إلى دعم المالكي في تشكيل الحكومة، في وقت كانت المنطقة كلها تغلي بملفات تدخل إيراني وسوري وتركي، وكان هو نفسه يتنقّل بين بغداد وطهران ودمشق وكردستان حاملًا ملف التفاوض السياسي بصفته ممثلًا للرئاسة.
وأقرّ كريم بأن بعض التقارير التي وصلتهم حينها - حول نشاط البعث، وخلايا مرتبطة بدول إقليمية - كان لها أثر كبير في رسم موقفه، لكنه اليوم يرى الصورة من زاوية مختلفة تمامًا. قال: «انتقدت نفسي لهذا الموقف، وأنا سعيد أنني امتلكت الشجاعة لفعل ذلك. هذا النقد ليس ترفًا، بل ضرورة».
ويعيد التأكيد بأن مراجعاته لا تنطلق من شعور مرير بالعجز، بل من قناعة بأن الاعتراف بالخطأ هو المدخل الوحيد لمنع تكراره على مستوى الدولة والمجتمع والنخب السياسية على حد سواء. ويضيف بأن تجربته بين العراق وسوريا ولبنان كشفت له عمق التشوهات في البيئة السياسية العربية، وأنه لم يعد يرى فائدة في تبرير الماضي أو الهروب منه: «ما جرى جرى. المهم أن نقول الحقيقة، وأن نفهم أين أخطأنا وكيف» .
لماذا رفض منصب رئيس الجمهورية؟
حين سُئل فخري كريم عن واحدة من أكثر المحطات إثارة للجدل في مسيرته - ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية من قبل مسعود بارزاني، ثم رفضه القاطع لهذا الترشيح - بدا أن السؤال يلامس جرحًا مفتوحًا بين المثقف والجمهور: لماذا يكثر النقد من الخارج، لكن حين يُطلب من المثقف أن يتحمّل المسؤولية داخل السلطة يتراجع خطوة إلى الوراء؟
ابتسم كريم ابتسامة تحمل نصًّا كاملًا من المراجعات، ثم قال بوضوح: «يا عزيزي، هذا خيار شخصي. ليس كل من ينتقد السلطة يريد أن يصبح جزءًا منها». أوضح أن منصب رئيس الجمهورية في العراق ليس منصبًا تنفيذيًا يمكّن صاحبه من إجراء تغيير فعلي، بل منصب رمزي محكوم بمعادلة سياسية شديدة التعقيد، «وما لم أستطع أن أقدّمه للناس خارج القصر، لن أستطيع تقديمه من الداخل»، كما قال.
ثم استعاد ما قاله في مقابلة أخرى: " تريدني أن أجلس في موقع يجلس فيه اللصوص؟» موضحًا أن قبوله بالمنصب في بيئة سياسية مغلقة، وفاسدة، ومشوهة، لم يكن ليضيف إلا إحراجًا له ولتاريخه الشخصي. «هذه ليست تضحية بالمنصب.. بل تضحية بقيمي»، قالها بنبرة واثقة.
وأضاف أن المشكلة ليست في رفضه للمنصب، بل في «البيئة السياسية الطاردة» التي تُبعد حتى عشرات الشخصيات الإسلامية النظيفة داخل الأحزاب نفسها - خاصة حزب الدعوة وغيره - من الذين جلسوا اليوم في بيوتهم لأنهم لا يشبهون المنظومة السائدة.
ويشدّد على أن من الخطأ تعميم الفساد على الإسلاميين جميعًا: «هناك معمّمون كبار، أصحاب عمائم سوداء، يقولون ما لا أجرؤ أنا على قوله؛ يحاربون الفساد، يواجهون السارقين، يدافعون عن قيمهم الأصيلة». ويشير إلى أن هؤلاء يستلهمون نماذجهم من عليّ، والحسين، وأبي ذر، وعمار بن ياسر، «بينما بعض مَن في السلطة اليوم لا يشبهون أيًّا من هؤلاء ولو بالحبر الذي كُتبت فيه سيرهم».
ويضيف بمرارة لا تخلو من احترام: «هؤلاء المعمّمون الحقيقيون، الذين يشتمون الفساد علنًا، كثير منهم يعيش في بيوت متواضعة، ورواتب بالكاد تكفيهم. ليسوا في القصور، وليسوا من الأغنياء الجدد» .





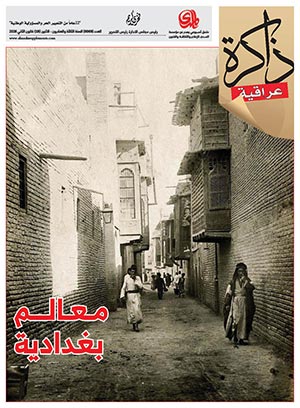
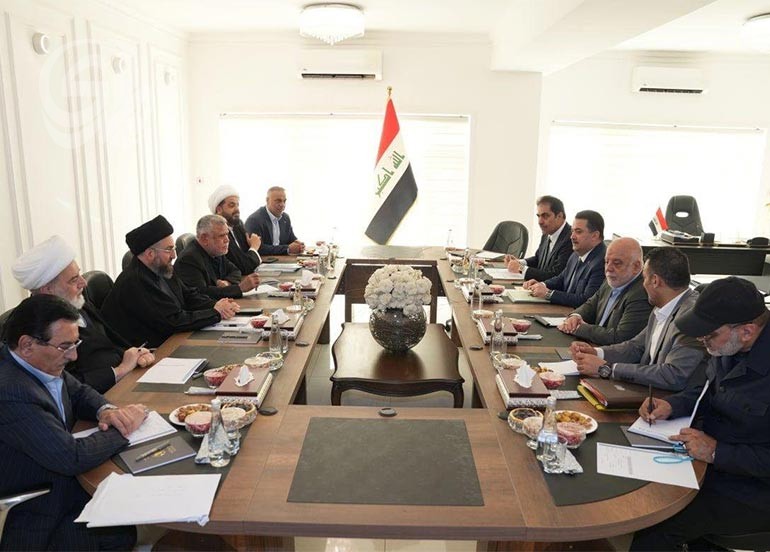




جميع التعليقات 1
كريم الدهلكي
منذ 2 شهور
تحليل صائب ودراسة دقيقة لانسان اختبر السياسة العراقية منذ اكثر من خمس عقود وهو يعيش كنفها بسلبياتها وايجابيتها فتقيمه لها يكون بدقة ومتابعه حصيفة