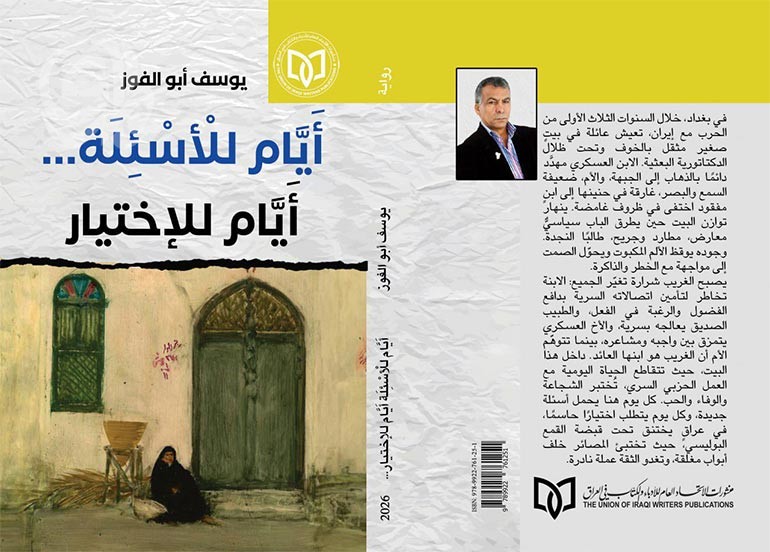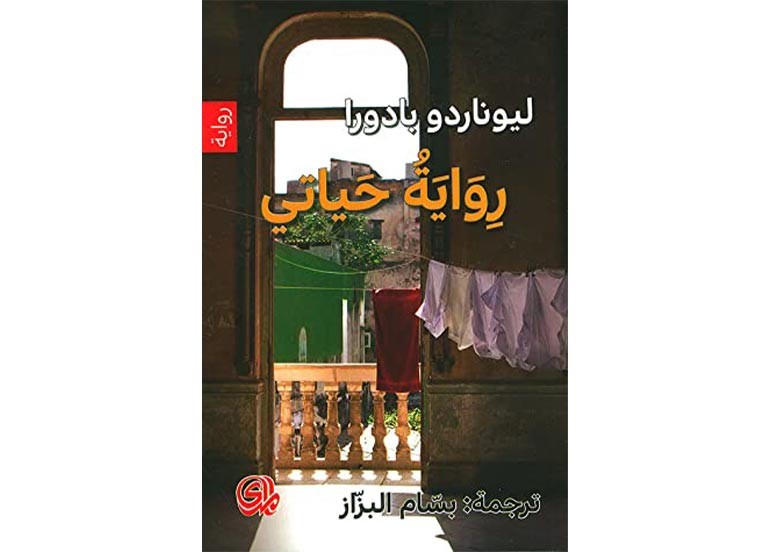أحمد القاسمي
في مقابلة صحفية أُجرِيَت معه بعد سقوط نظام البعث سُئل الملحّن العراقي كوكب حمزة في عن رأيه بالموسيقى العراقية في عقد الثمانينات، فأجاب أن أغنية "زعلان الأسمر" لعارف محسن هي رمز لأغاني ذلك العقد، وذلك في إشارة لرداءة الموسيقى العراقية في حقبة الحرب والدكتاتورية الخانقة لكل إبداع أو حرية تعبير. لكن الفنّ، كما هو دأبه، يجد طرائق للتملّص من الرقابة، كثيرا أو قليلا. وهذا ما جرى في مسرحية "المحطّة".
المسرح في العراق أقدّم بكثير كفنّ تعبيري من السينما وأكثر تأثيرا منها ومن المسلسلات التلفزيونية، من ناحية المستوى الفني والأداء والتأثير الثقافي. لكن هذا المقال ليس نقدا فنيا لتلك المسرحية، فأنا لم أشاهدها إلا بعد عرضها في التلفزيون العراقي في السنوات اللاحقة. إنّه قراءة اجتماعية وسياسية لها، بعدما شاهدتها مجدّدا في موقع يوتيوب. هذه المسرحية تستحقّ العودة للحديث عنها، فهي عمل فنّي تمكّن، رغم رقابة الدكتاتورية الخانقة والحرب، في أن يحجز مكانة مميزة له في تاريخ المسرح العراقي. عُرِضَت مسرحية "المحطّة" لأوّل مرّة في عام 1984 وكانت من إخراج فتحي زين العابدين وتأليف صباح عطوان، وكان ممثلوها من الفرقة القومية للتمثيل.
تدور أحداثها في محطّة قطار في ليلة شتائية باردة وممطرة في بلدة نائية في محافظة ذي قار اسمها البطحاء. المسافرون ينتظرون داخلها قطارا ينبغي أن يوصلهم إلى بغداد، لكنه لن يصل قبل ثلاث ساعات، بسبب تأخّره. يدخل محطّة القطار أولا العجوز الطيب زاير ـ طالب الفراتي ـ الذي يريد الذهاب إلى بغداد لعرض تقاريره الطبية المُقلِقة على طبيب مختّص هناك، لعدم وجود مستشفى مختصّ في الناصرية، كما نعرف لاحقا. يجد في المحطّة رجلا مجنونا بملابس مهلهلة ـ الممثل عدنان الحداد ـ نعرف لاحقا أنّه جُنّ بسبب الحبّ. ثم يدخل شاب ـ عبد الجبار كاظم ـ وهو مثقف متكبّر دائم الانتقاد للتقاليد ولأي تفسيرات لا تنسجم مع مقولات العلم ولديه إلمام بتاريخ البطحاء، كمدينة أثرية عريقة، وكان في طريقه لزيارة عائلته في بغداد. ينضم إلى منتظري القطار رجل مخمور ـ عماد بدن ـ يبدو أنه نزل بالخطأ من قطار آخر ظنّا منه أنه وصل إلى بغداد. ثم تدخل امرأة قروية حامل مطارَدة بسبب هروبها من المنزل. المرأة في حالة صحّية سيّئة وتستنجد بالموجودين في المحطة لإخفائها كي لا يُمسك بها أبوها وأخوها القرويان المتعصبان اللذان كانا يبحثان عنها في أرجاء المنطقة. تصل أيضا طبيبة ـ ليلى محمد ـ تعمل في البطحاء، وكانت، كما يبدو، في طريقها أيضا إلى بغداد لقضاء إجازتها من العمل. الطبيبة واثقة من نفسها ولا تعوزها لا أخلاق مهنة الطبّ ولا الصرامة في التعامل مع الآخرين لدفعهم لفعل ما تراه صحيحا. ينجح المنتظرون في المحطة بإخفاء المرأة المطاردة عن أبيها وأخيها اللذين يدخلان المحطة عدة مرات بعجالة بحثا عنها. يحاول المسافرون إيصالها إلى المستشفى، بناءً على تقييم الطبيبة لحالتها الصحّية، فيتّصلون بالإسعاف. أحداث المسرحية صارت منذ دخول المرأة المريضة تدور حول واجبهم الأخلاقي في إنقاذ حياتها بإخفائها عن والدها وأيضا بإيصالها إلى المستشفى وما يتبع ذلك من أسئلة أخلاقية وقانونية. حاول المثقّف المتكبّر التنصّل من مساعدتها، بينما بذل العجوز زاير جهده للاهتمام بها، وكذلك بإيهام والدها أنها ليست في المحطة. قبيل نهاية المسرحية يصل سائق الإسعاف. وعندما نعتقد أنّ تلك هي النهاية السعيدة للمسرحية الكوميدية، نفاجأ بأن سيّارة الإسعاف قد علقت في الوحل. وهنا يقرّر زاير حمل المرأة على ظهره لإيصالها إليها، رغم تحذير الطبيبة له من العواقب، وكانت اطّلعت على تقاريره الطبيبة. وهنا ينبهر المثقّف المتكبّر بسلوك زاير ويقرّر أن يلحق به لمساعدته في حمل المرأة إلى سيّارة الإسعاف العالقة، وانتظار سائقها الذي كان ذهب لجلب جرّار زراعي لإخراجها.
شخصيات المسرحية إذن إمّا من تلك البلدة القروية المهملة أو من بغداد. كلهم تقريبا مضطّرون لانتظار القطار في تلك الليلة. يحدث بينهم التواصل بسرعة وبشكل قسري تقريبا. بداية بين رجل مجنون في المحطّة وبين العجوز زاير، ثم بين زاير وبين المثقّف المغرور، وبعدها مع الرجل المخمور الذي فرض نفسه عليهم بكلامه غير المترابط والمضحك. ومع التواصل تدبّ الخلافات فيما بينهم، فهم عيّنات لفئات مجتمعية مختلفة ولا أحد فيهم يشبه الآخر. بيد أنّ الخلافات بينهم تظلّ في الحدّ المقبول، كما يخلق شجارهم تعاونا وتعاطفا مشتركا. لا نجد فيهم شخصا شريرا فعلا، سوى والد السيدة القروية الهاربة، والذي يبدو أنه منقاد تماما للتقاليد القروية، وهو جانب لا نجده لدى القروي زاير. أما أخوها فيظهر لنا كقروي ساذج لا أكثر. وهذا نموذج قروي ثالث موجود، أو على الأقل، كان موجودا في الريف آنذاك.
ولأنّ الرقابة في عقد الثمانينات في العراق تمنع عرض أي انتقاد ولو تلميحا، فكلّ ما كان بوسع مخرج المسرحية فعله، كي ينجز عملا فنيا يُوصل رسالته، هو أن يترك للمشاهد إعادة تأويل ما يراه، تحت قشرة الكوميديا وظروف الطقس والانتظار. هذا لا يعني طبعا أن المسرحية لم تكن كوميدية، بل أنها كذلك حقّا، ولكنها ليست كوميديا رخيصة وتختلف عن مسرحيات تهريجية كان وجودها شائعا في تلك الحقبة.
نستطيع التعمّق في تأويل المسرحية، بفضل بنائها الفني المتماسك وأداء كلّ ممثليها المتقن والاحترافي، للتعرّف على الشخصيات التي تجسدها والتي كان مشاهدوها آنذاك يعرفون أشخاصا يشبهونها خارج المسرح.
الأجواء الكئيبة، رغم ضحك الجمهور شبه المتواصل، لا تقتصر فقط على الطقس السيّء أو محطّة القطارات الخالية من تدفئة أو الطريق الطيني الموحل والكلاب السائبة خارجها، فخلف ستار الكوميديا تظهر ملامح للحزن والوحشة والمشاكل الاجتماعية وإيحاءات بوجود قهر سياسي. المسرحية فيها نقد مباشر للأوضاع المزرية للمناطق الريفية، وذلك رغم أن عدد سكان العراق القليل، والثروة النفطية آنذاك كانت ستتيح ببساطة وضعا أفضل بكثير. لكنها ثروة كان أغلبها مخصصا للمجهود الحربي ـ بحسب التعبير الرسمي آنذاك. يبرّر المثقّف المتكبّر محاولاته للتهرّب من مساعدة المرأة المريضة بخشيته من أهلها، لكنه يستخدم أيضا تعبيرا غامضا هو "المسؤولية"، ومشاهدو تلك الحقبة يدركون المعنى الأمني السلطوي الكامن خلف تلك الكلمة المبهمة والمخيفة. الخشية من مساعدة آخرين في أوضاع طارئة كانت سلوكا مألوفا آنذاك، وكان تبريره يتمّ بتلك الكلمة المخيفة: المسؤولية.
الموسيقى قبيل افتتاح ستار المسرح هي عزف بوق منفرد يشبه الإيقاع العسكري وليس فيها أثر لمرح أو طرب، ولا تنسجم مع كون المسرحية كوميدية. كان اختيار المخرج الموفّق لها بمثابة مدخل لأجوائها وأحداثها وشخصياتها التراجيدية.
لا شكّ أنّ المحطة الخالية من الجنود أو أي إشارة مباشرة للحرب في محطّة قطارات كانت قد لفتت أنظار مشاهدي المسرحية، سواء أثناء عرضها في المسرح أو في التلفزيون. لكن رغم غياب الجنود، بقي ظلُّ الحرب ممدوداً فوق مشاهدها. فالمجنون مثلا يستخدم في حديثه مع زاير تعابير كانت متداولة أثناء الحرب ضد إيران: "هذه سيجارة مفرد، فأعطني ثانية كي تصبح "صَلي"، فيرد زاير عليه "سأعطيك سيجارة ثالثة كي تصبح "راجمة". معطف المجنون ذو اللون الخاكي يشبه المعطف العسكري الذي كان ارتداؤه آنذاك مشهدا شائعا في المدن أيضا، للعسكريين والمدنيين أيضا. ورغم أن موظف المحطة ـ عدنان شلاش ـ في المسرحية يخبرنا أن المجنون قد فقد عقله بسبب الحب، إلا أن تلك برأيي مجرد تورية، فلا شك أنّ المجنون ذكّر المشاهدين بالجنود الذين فقدوا عقولهم بسبب صدمات تعرضوا لها أثناء الحرب، وأصبحوا، إلى جانب معاقي الحرب، جزءا من المشهد العام في الشوارع.
المقارنة التي أجراها الكهل بين ابنه وبين الشاب المثقف المغرور يمكن تأويلها كإشارة غامضة لكون الابن في الجيش. فقد تحدّث عنه وكأنّه غير موجود في البطحاء، ولم يبرّر عدم مرافقته له في سفرته إلى بغداد، رغم خطورة وضعه الصحّي. نرى أيضا ان سائق الإسعاف الذي دخل في جدال مع الطبيبة، سرعان ما تراجع مذعورا بعدما عرف أنها تعمل في نفس المستشفى. يبدو أنه قد خشي من فقدانه لوظيفته الحكومية بسببها، ثم ما سيتبع ذلك من سوقه إلى الجيش. وكان سوق الموظفين المدنيين، وهو ما حدث فعلا مرارا مع تزايد الحاجة للجنود، أسوأ ما يمكن أن يحدث لموظف مدني في تلك الحقبة، لكن سائق الإسعاف برّر خوفه بالإشارة إلى مسؤوليته عن إعالة أسرته الكبيرة العدد.
اسم المسرحية "المحطّة" قد يبدو مجرد اختصار لـ "محطّة القطار"، لكنّ اختزالا آخر في المسرحية يوحي بأن ذلك كان مقصودا. فسائق الإسعاف يقول لهم، عندما يصل، إنه يريد نقل المرأة إلى المركز، دون أن يوضح أنه يقصد المركز الصحي. وكلمة "مركز" في العراق، على الأقل في تلك الحقبة، كانت تعني عادة مركز الشرطة. وهنا يمكن القول إن هذا العنوان المختزل مقصود، فقد يكون كناية أخرى، أي أنّ تلك المحطّة الكئيبة والانتظار داخلها رمز لحال العراقيين أثناء تلك الحرب.