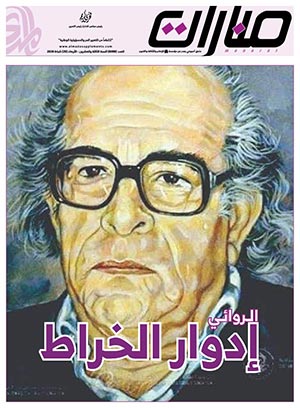حسن الجنابي
(1 من 2 )
بدأت مسيرة التحديث التنموي في العراق فعلياً خلال العقد الأخير من العهد الملكي، حيث برز الملك الشاب فيصل الثاني، مقارنةً بمن سبقه أو عاصره، بحضورٍ ملحوظ في مناسبات وضع حجر الأساس للمشاريع التنموية وافتتاح ما أُنجز منها، في مسعى لإضفاء بعدٍ عملي على مشروع الدولة الحديثة. غير أن هذا الانشغال بالمظاهر التنموية ترافق مع تجاهل الإرث السياسي الثقيل للفترة التي حكم فيها الوصي على العرش الأمير عبد الإله، منذ وفاة الملك غازي عام 1939 وحتى تسلّم فيصل الثاني سلطاته الدستورية عام 1953.
فقد اتسمت تلك المرحلة بقدرٍ كبير من القمع السياسي، ولجأ خلالها الوصي، وبالتعاون مع نوري السعيد، إلى تنفيذ أحكام إعدام علنية، وعمل على ترسيخ تحالفٍ عضوي مع الغرب، والارتهان لإرادته السياسية، مقابل مكاسب محدودة تمثلت بزيادات طفيفة في العوائد النفطية أو تنازلات سياسية جزئية من الجانب البريطاني، وهي سياسات كان من الصعب تسويقها شعبيا حينذاك.
في تلك الأجواء، أخذت الحركات المناوئة للسياسات الطبقية التي انتهجتها الحكومات الملكية المتعاقبة بالنمو والتبلور، في ظل التكليف شبه الدائم لنوري السعيد برئاسة الوزراء، إذ تولى رئاسة الحكومة 14 مرة!
ومع تراكم إرث القمع، تصاعدت الاحتجاجات الشعبية التي عبّرت عن وعيٍ وطني آخذ في الاتساع، وحماسةٍ ثورية تسيّد فيها الاتجاه اليساري المشهد السياسي، ممثلاً بالدور المتعاظم للحزب الشيوعي العراقي، إلى جانب نشاط أحزاب وطنية أخرى، في سياق دولي اتسم ببروز قوة المعسكر الاشتراكي عقب الانتصار على النازية والفاشية في الحرب العالمية لثانية.
لم تشفع للملك الشاب فيصل الثاني مسيرة التحديث التي قادها، ولا المشاريع التي أُنجزت في عهده، في تقليص حجم المخاطر التي كانت تهدد العرش. كما لم تُفلح رغبته في توسيع التعاون مع الدول العربية في امتصاص السخط الشعبي الذي شكّل لاحقاً زخماً معارضاً ومسيّساً أطاح بالمملكة.
لقد مثّل الإقطاعيون إحدى الركائز الاجتماعية والاقتصادية الداعمة للعهد الملكي، وتميّزت ممارساتهم بقسوةٍ مفرطة تجاه الفلاحين، من خلال الاستحواذ على معظم الأراضي واستغلال اليد العاملة الريفية وإبقائها على حافة الفقر والجوع. وهذا أفضى إلى تصاعد موجات النقمة والتمرد، التي قمعت بمساندة الأجهزة الحكومية، ما أسهم في تعميق الغضب الشعبي ودفع عشرات الآلاف من الأسر الريفية إلى النزوح نحو أطراف المدن المحرومة من أبسط مقومات الحياة الكريمة.
أما الشركات النفطية الاحتكارية، فقد مثّلت الأداة الأبرز للهيمنة البريطانية على الموارد النفطية العراقية، وعلى جزء مهم من القرار السياسي الخارجي للدولة. وتمتعت تلك الشركات بامتيازات واسعة ذات طابع استعماري في مجالات الاستكشاف والاستخراج والتسويق.
في الرابع عشر من تموز عام 1958، أقدم تنظيم "الضباط الأحرار" في الجيش العراقي على الإطاحة بالنظام الملكي وإعلان الجمهورية. وفي خضم الفوضى والانفلات اللذين أعقبا الحركة، ارتُكبت جريمة تصفية أفراد العائلة المالكة بهمجية صارخة، ودون مسوّغات أخلاقية أو سياسية أو أمنية.
وفّرت الأحزاب السياسية المنضوية ضمن إطار "جبهة الاتحاد الوطني"، التي تشكّلت 1956، الغطاء السياسي لذلك التحرك العسكري، الأمر الذي أسهم في أن يحظى بشعبية واسعة، أفضت بالنتيجة إلى التغاضي عن جريمة تصفية العائلة المالكة.
تبنّت القوى المؤيدة للثورة شعارات وبرامج وقوانين كانت تلاقي تعاطفاً شعبياً واسعاً، رغم أن شروط تنفيذها لم تكن بالضرورة قد نضجت بما يضمن استقرار العراق إقليمياً ودولياً، ومنها قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958، الهادف إلى تفكيك بنية الإقطاع وتحديد الحد الأعلى للملكية الزراعية، وقانون رقم 80 لسنة 1961 المتعلق بسحب امتيازات الشركات النفطية الاحتكارية في الأراضي غير المستثمرة وغيرها. أسهمت تلك الإجراءات -بلا شك- في تعزيز المشاعر الوطنية، وأحدثت قطيعة مع التوجهات التقليدية التي حكمت علاقة العراق ببريطانيا خلال العقود الأربعة التي سبقتها. وخلق استهداف الجمهورية للإقطاعيين وللاحتكارات النفطية زخماً جماهيرياً مؤيداً، وارتبط بتوجهات جديدة في السياسة الخارجية، تمثلت بالسعي إلى التحرر من النفوذ البريطاني والانحياز إلى قضايا التحرر الوطني في فلسطين والجزائر وغيرها.
أما الزعيم عبد الكريم قاسم نفسه فقد انصبّ تركيزه الى حدٍّ كبير على الشأن الداخلي، وجمع بيده عدة مناصب أمنية حساسة، من بينها منصب القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع. ويبدو أن الدافع الكامن وراء ذلك كان الخشية من تنامي نفوذ الضباط الآخرين وطموحاتهم السياسية، في ظل تجربة حديثة أظهرت سهولة الوثوب إلى السلطة عبر الانقلاب العسكري.
وسرعان ما دبّت الخلافات بين الضباط الأحرار أنفسهم، بفعل تضارب المصالح والنزعات الشخصية وغياب البرنامج السياسي الموحد لمرحلة ما بعد التغيير. تطورت تلك الخلافات إلى صدامات خطيرة، كان أبرزها تمرد العقيد عبد الوهاب الشواف في الموصل عام 1959، وما أعقبه من محاولات انقلابية واغتيالات، انتهت بسلسلة من الانقلابات الدموية، في مقدمتها انقلاب شباط 1963، ثم عودة حزب البعث إلى الحكم في تموز 1968، وما رافق ذلك من قبضة حديدية ومجازر واسعة، استمرت حتى إسقاط النظام بغزو عام 2003.
وبهذا المعنى، أدت تجربة الجمهورية الأولى إلى مأزق بنيوي تمثّل في عنف السياسة، وتسييس المؤسسة العسكرية، وتآكل فرص بناء دولة مستقرة، وهو ما مهّد لانحسار الدور الدبلوماسي العراقي.
- يتبع -