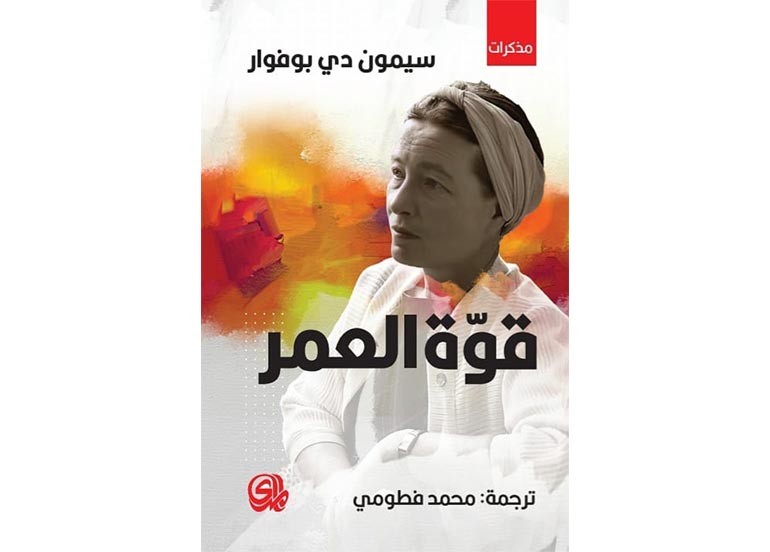عبد الكريم البليخ
سؤالٌ يبدو بسيطاً في ظاهره، عابراً كغيره من الأسئلة اليومية، لكنه ما إن يُطرح بصدق حتى ينفتح على طبقات عميقة من الحيرة والتأمل. لماذا نكتب؟ أهو اندفاع داخلي لا يُقاوَم، حاجة نفسية تشبه التنفّس، ومحاولة لفهم الذات والعالم من حولنا؟ أم أننا نكتب بدافع الظهور، بحثاً عن الاعتراف، ورغبةً في أن نُرى ونُصفَّق لأنفسنا عبر عيون الآخرين، فنلوذ أحياناً بغموضٍ مصطنع، يوهمنا ـ ويوهم غيرنا ـ بأننا بلغنا مرتبة البراعة والفرادة؟
الكتابة، في جوهرها الأصيل، ليست استعراضاً للقوة اللغوية، ولا ميداناً للمبارزة الفكرية، ولا حلبة لإثبات التفوق أو ممارسة الوصاية على القارئ. إنها فعلٌ إنساني قبل أن تكون صنعة، وحالة وعي قبل أن تكون مهارة. هي جسرٌ دقيق، هشّ أحياناً، بين وعي الكاتب ووجدان المتلقي. وحين نكتب، فإننا ـ أو هكذا ينبغي ـ نبحث عن قارئ حقيقي، قارئ لا يطلب بهرجة لفظية، بل كلمة صادقة، تستقر في عقله، وتلامس قلبه، وتوقظ ضميره. نبحث عن قارئ يريد أن يُفهم، لا أن يُرهَق، وأن يشعر بأن ما يقرأه كُتب له، لا عليه.
غير أن واقع الكتابة اليوم يكشف عن وجهٍ آخر لا يمكن تجاهله؛ كتابةٌ تُغري بالغموض، وتتعمّد التعقيد، وتراكم الجمل فوق الجمل، لا لتفتح أفقاً، بل لتغلقه. كتابة تتعامل مع القارئ بوصفه خصماً ينبغي إخضاعه، أو تلميذاً يجب إبهاره، لا شريكاً في التجربة. في هذا النوع من النصوص، تتحوّل اللغة من أداة كشف إلى أداة حَجب، ومن نافذة تطل على المعنى إلى جدارٍ سميك يعزل القارئ عنه. ويغدو النص ساحة استعراضٍ فارغ، غايته الوحيدة أن يُقال: "هذا كاتب متمرّس"، حتى لو خرج القارئ مثقلاً بالتيه، خالي الوفاض، فاقداً الرغبة في المتابعة.
الكتابة الحقيقية، في رأيي، لا تخجل من الوضوح. بل إن الوضوح، حين يكون عميقاً وغير سطحي، هو أرقى مراتب البلاغة. النص الذي يُقرأ بسلاسة، ويفهمه المتعلم والبسيط على السواء، ليس نصاً ساذجاً ولا فقيراً، بل نصٌ واثق من نفسه، مطمئن إلى فكرته، غير محتاج إلى أقنعة لغوية ولا إلى زخرفة زائدة. الكاتب الواثق لا يختبئ خلف الكلمات، بل يقف عارياً أمام قارئه، متكئاً على صدق الفكرة وقوة المعنى.
إن القارئ ذكي بطبيعته، حتى وإن لم يكن مثقفاً بالمعنى الأكاديمي. وهو يشعر، متى كان النص صادقاً، ومتى كان متكلفاً. يستمر في القراءة حين يحس أن الكلمات تقوده إلى صور أوضح، وأسئلة أصدق، ومناطق تمس أوجاعه وتجربته الإنسانية. فالنص الذي لا يلامس شيئاً من قلق الإنسان، أو خوفه، أو أمله، أو خيبته، يظل نصاً بارداً مهما بلغ من الفصاحة.
نكتب لكي نفهم ونُفهِم، لا لكي نمارس "الأستذة" الزائفة، ولا لكي نُثبت أننا نعرف أكثر من غيرنا. نكتب لأن في داخلنا شيئاً يريد أن يُقال، وربما يختنق إن لم يُقال. نكتب لأن الكتابة، في أصلها، شكل من أشكال المسؤولية الأخلاقية تجاه الذات وتجاه الآخر. وكلما ابتعدت الكتابة عن هذا الوعي، تحوّلت إلى تمرين لغوي أجوف، لا يترك أثراً إلا في غرور صاحبه.
واللغة العربية، على وجه الخصوص، بريئة من تهمة التعقيد التي يلصقها بها البعض. فهي من أغنى لغات العالم، وأوسعها قدرة على التعبير، وأكثرها مرونة في حمل المعنى، من البسيط اليومي إلى الفلسفي العميق. لكنها لا تمنح جمالها لمن يسيء استخدامها أو يتعامل معها بوصفها أداة استعراض. إنما تكافئ من يقترب منها بصدق، ويستخرج من معجمها ما يخدم الفكرة، لا ما يثقلها.
وحين ندعو إلى الوضوح، فإننا لا ندعو إلى التبسيط المُخل، ولا إلى الابتذال، بل إلى وضوحٍ نابع من عمق الرؤية. فالغموض الحقيقي ليس في تعقيد اللغة، بل في ارتباك الفكرة. وكل فكرة واضحة في ذهن صاحبها قادرة، مهما كانت عميقة، على أن تجد طريقها إلى القارئ.
لذلك، نحن مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة النظر في علاقتنا بالكتابة. أن نسأل أنفسنا بصدق: لماذا نكتب؟ ولمن نكتب؟ وماذا نريد أن نترك خلفنا؟ لنجعل الكتابة مساحة لقاء، لا ساحة استعراض، وجسراً للحوار، لا متراساً للتعالي. ولنتذكر أن الاستعراض الكاذب، مهما حقق من ضجيج مؤقت، يرفضه القارئ، كما يرفضه ـ في أعماقه ـ الكاتب نفسه، حين يصغي بصدقٍ إلى صوته الداخلي، ويواجه ذاته بلا أقنعة.
وجهة نظر : لماذا نكتب ونستعرض؟

نشر في: 14 يناير, 2026: 12:03 ص