جورج منصور
إن سؤال الثقافة في العراق لا ينتمي إلى فضاء التنظير المجرد ولا إلى رفاه النقاشات المغلقة، ولا يقتصر على همّ جمالي أو نخبوية معزولة، بل يتخذ بعداً وجودياً ومصيرياً، يتشابك مع السياسة والهوية والسلطة والخوف، ويمتد أثره إلى مستقبل الدولة والمجتمع في آن واحد.
فالثقافة، في معناها العميق، ليست إنتاج نصوص ولا إقامة مهرجانات ولا تراكم ألقاب أكاديمية. إنها فعل مساءلة دائم، واشتباك مع السائد، ومحاولة مستمرة لإعادة تعريف الإنسان والعالم. وهي لذلك، بطبيعتها، في حالة توتر دائم مع كل سلطة مغلقة، سياسية كانت أم دينية أم اجتماعية.
وحين نسأل: هل يمكن للثقافة أن تنهض والمثقف أن يُبدع ويتألق في ظل الطائفية وتكالب الأحزاب؟ فإننا في الحقيقة نسأل: هل مازال للعقل مكانة في بلد تحكمه الانتماءات الضيقة وتُدار شؤونه بمنطق الغلبة لا الكفاءة؟ِِ
من هنا ينبثق الإشكال العراقي: فالنظام الطائفي لا يرى في الثقافة أداة معرفة، بل عامل إرباك. إنه يحتاج إلى جمهور مطمئن إلى رواية واحدة، لا إلى مواطنين يطرحون الأسئلة. ولهذا لا تُقمع الثقافة صراحة دائماً، بل يُفرغ حضورها من محتواه، ويُعاد تدويرها بوصفها نشاطاً احتفالياً بلا أثر.
الطائفية ليست مجرد انقسام اجتماعي، بل هي منظومة تفكير تعيد تعريف الفرد بوصفه عضوًا في جماعة مغلقة، لا بوصفه مواطناً حراً. وفي ظل هذه المنظومة: يُختزل المثقف إلى "ممثل طائفي" شاء أم أبى، ويُنظر إلى الرأي بوصفه موقفاً هوياتياً لا اجتهاداً فكرياً، ويُفسر النقد باعتباره عداءً للجماعة لا محاولة إصلاح.
بهذا المعنى، تُلغى المساحة المشتركة التي تُعد شرطاً أساسياً لنهضة أي ثقافة وطنية. فالثقافة لا تزدهر في الجزر المنعزلة، بل في الحوار والتفاعل والتعدد، وكلها قيم تناقض جوهر الطائفية.
أمام هذا الواقع، وجد المثقف العراقي نفسه أمام خيارات قاسية، كلها ناقصة: الصمت بوصفه وسيلة بقاء، والتكيف بوصفه تنازلاً تدريجياً، والعزلة داخل الوطن، أو الهجرة إلى الخارج، حيث تتوافر حرية التعبير لكن يغيب التأثير المباشر.
ليس من المبالغة القول إن تاريخ الدولة العراقية الحديثة كُتب، في أحد وجوهه، على حساب مثقفيها. فقد وُضع المثقف العراقي، منذ منتصف القرن العشرين، باستمرار أمام معادلات قاسية لا تترك له سوى هامش ضيق للاختيار: إما الصمت أو القمع، إما التكيف القسري أو المنفى. وما بين ما قبل 2003 وما بعده، تغيّرت الأشكال وبقي الجوهر واحداً: سلطة معادية للعقل النقدي، ولو اختلفت لغتها وشعاراتها.
ولهذا لا تبدو ظاهرة بروز المثقفين العراقيين في الخارج مصادفة، بل نتيجة طبيعية لبيئة داخلية طاردة للعقل النقدي. أما من بقي في الداخل محافظاً على استقلاله، فقد دفع ثمناً مضاعفاً من التهميش والتشويه وربما التهديد.
قبل 2003، عاش المثقف العراقي في ظل دولة شمولية لا ترى في الثقافة سوى أداة تعبئة أو تهديداً محتملاً. كان المطلوب منه أن يتحول إلى بوق أيديولوجي، يجمّل خطاب السلطة ويمنحها شرعية رمزية. من قبل بذلك، حصل على امتيازات محدودة ومراقَبة؛ ومن رفض، واجه السجن أو الإقصاء أو التهجير أو الموت.
لم يكن المنفى خياراً رومانسياً، بل ضرورة وجودية. آلاف الكتاب والأكاديميين والفنانين غادروا العراق، لا بحثاً عن رفاه، بل هرباً من آلة أمنية لا تتسامح مع الاختلاف. أما من بقي، فقد اضطر إلى ممارسة نوع من "الرقابة الذاتية"، يكتب ما لا يقول، ويقول ما لا يؤمن به، في محاولة للبقاء.
على الرغم من هذا المشهد القاتم، فإن الحديث عن موت الإبداع في العراق يظل حكماً جائراً. فالإبداع لا يموت بسهولة، لكنه قد يُدفع إلى الظل. وما نراه اليوم هو انتقال الثقافة من المركز إلى الهامش، ومن المنابر الرسمية إلى المساحات البديلة.
ثمة نصوص تُكتب ولا تُروّج، وأعمال فنية تُنجز بلا دعم، وأصوات شابة تحاول كسر القوالب الطائفية واللغات الجاهزة. هذا الإبداع لا يملك سلطة الانتشار، لكنه يملك صدق التجربة، وغالباً ما يشكل نواة تحولات لاحقة.
الطائفية لا تُعلن الحرب على الثقافة، لكنها تفرغها من معناها. فهي لا تحاصر الكتاب مباشرة، ولا تحرق الكتب علناً، لكنها تُعيد تشكيل الوعي الجمعي بطريقة تجعل السؤال الحر فعلاً مشبوهاً، والنقد خيانة، والاختلاف تهديداً للتماسك الموهوم.
في مناخ طائفي، يُطلب من المثقف أن يُعرّف نفسه أولاً من خلال انتمائه لا من خلال فكره، وأن يُحسب على "هذه الجماعة" أو "تلك"، لا على ضمير المجتمع. وهنا تفقد الثقافة وظيفتها الأساسية: تفكيك المسلمات، وفتح أفق التفكير، وكسر السائد.
بعد عام 2003، لم تكتف الأحزاب العراقية بإدارة السلطة السياسية، بل تمددت إلى المجال الثقافي والإعلامي، وحاولت إعادة إنتاجه على صورتها. فغدت المؤسسات الثقافية ودور النشر والمنابر الإعلامية وحتى الفعاليات الفنية، خاضعة لمنطق المحاصصة والولاء.
وفي ذات العام، حيث كنتُ مديراً عاماً لتلفزيون شبكة الإعلام العراقي، (التي سميناها "العراقية" لاحقاً)، أنبرى خطيب مسجد في بغداد ليعلن رأيه دون خوف أو مواربة، ويقول: "كيف يمكن لإعلامي ليس من دين الغالبية ويحمل الجنسية الكندية أن يكون رئيساً للتلفزيون العراقي».
ومن هنا، لم يعد الدعم الثقافي يُمنح على أساس الجودة أو الإضافة الفكرية، بل على أساس القرب من هذا الحزب أو ذاك. وتحول المثقف من ناقد للسلطة إلى موظف لديها، أو عدوّ يجب تحييده. وأمام هذا الواقع، وجد المثقف نفسه محاصراً بين خيارات كلها مُرَّة: إما الصمت والانكفاء، أو التكيّف والتنازل، أو العزلة داخل وطنه، أو "المنفى الداخلي"، أو الهجرة الجغرافية. وهذا ما يفسر بروز كثير من المثقفين العراقيين في الخارج أكثر مما يُسمح لهم بالبروز في الداخل.
رغم كل هذا، فإن القول بموت الثقافة أو أنعدام الإبداع سيكون حكماً متسرعاً. فالتاريخ يعلمنا أن الإبداع كثيراً ما يولد في أحلك الظروف، وأن أعظم الأعمال الفكرية والأدبية خرجت من رحم القمع والتهميش.
لكن الفارق أن الإبداع في هذه السياقات لا يكون احتفالياً أو مدعوماً، بل فعل مقاومة لا ترفاً، وشهادة أخلاقية لا وظيفة، وصوتاً فردياً في مواجهة جوقة عالية.
في العراق اليوم، ثمة كتاب وفنانون وشعراء: يكتبون خارج القوالب الطائفية، ويرفضون الاصطفاف، ويؤمنون بأن الثقافة موقف قبل أن تكون مهنة. غير أن أغلب هؤلاء يعملون في الهامش، بلا منصات، وبلا حماية، وبلا اعتراف رسمي.
إن نهضة الثقافة لا تُصنع بقرار حكومي ولا بمهرجان موسمي، إنها عملية تراكمية طويلة تبدأ حين يتحرر المثقف من الخوف، ويستعيد المجتمع احترامه للعقل والمعرفة، وتكف الدولة عن معاداة السؤال الحر، وتُنفصل الثقافة عن دكاكين السياسة. وهذا المسار غالباً ما يبدأ من قلة عنيدة، لا من أغلبية صاخبة.
الثقافة في العراق اليوم لا تعيش زمن النهضة، بل زمن الاختبار: اختبار الضمير، والاستقلال، والقدرة على الصمود. وفي مثل هذه الأزمنة، لا يُقاس المثقف بعدد الجوائز ولا بحجم الحضور الإعلامي، بل بقدرته على قول الحقيقة، ولو وحيداً. فهؤلاء وحدهم، لا سواهم، هم بذرة أي نهضة ثقافية قادمة، مهما تأخرت.
نعم، يمكن للمثقف أن يُبدع في ظل الطائفية وتكالب الأحزاب، لكن ذلك الإبداع سيكون مكلفاً، هشاً، ومحاصراً. ومع ذلك، فإن كل نص حر، وكل موقف مستقل، وكل رفض للانخراط في القطيع، هو لبنة صغيرة في بناء مستقبل مختلف.
فالثقافة لا تنهزم حين تُقمع، بل حين تستسلم. والمثقف الحقيقي لا يُقاس بمدى قربه من السلطة، بل بمدى اقترابه من ضمير المجتمع، حتى لو بقي وحيداً.
قدر المثقف العراقي، حتى الآن، أن يعيش دائماً "ضد التيار": ضد الدكتاتورية بالأمس، وضد الطائفية اليوم. وبين هذا وذاك، ظل المنفى حاضراً بوصفه حلاً فردياً لمأزق جماعي. لكن المجتمعات لا تُنقذ بالهجرة، بل بإعادة الاعتبار للعقل والمعرفة. ويبقى السؤال مفتوحاً: هل يأتي يوم يصبح فيه العراق وطناً صالحاً لمثقفيه، لا طارداً لهم؟





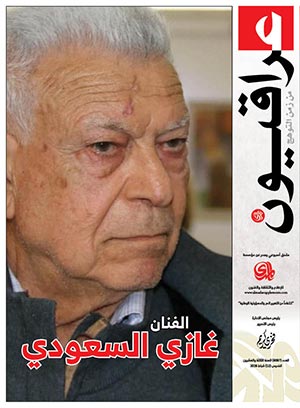





جميع التعليقات 2
أوشانا نيسان
منذ 3 أسابيع
مقال راءع نجحت حقا في القاء الضوء علىأسباب السكوت. تراجع او حتى هجرة المثقف العراقي في زمن النظم الشمولية اي حنى عام 2003. فالثقافة عموما غابت او غيبت في العراق، لانها لا تنمو ولا تتورق من دون مناخ فكري حررّ..والدليل على صحة قولكم هو وجود المثقف في الغربة
صباح محسن جاسم
منذ 3 أسابيع
" ويبقى السؤال مفتوحاً: هل يأتي يوم يصبح فيه العراق وطناً صالحاً لمثقفيه، لا طارداً لهم؟" هو ذا السؤال المعروف جوابه مسبقا .. rhetorical question