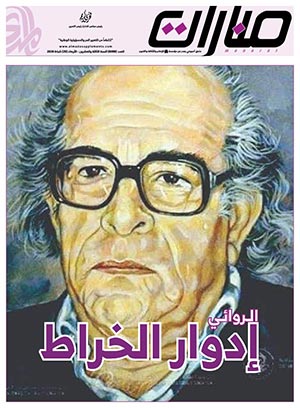سعد سلوم
كان التساؤل الجدلي حول مدى صلاحية «النموذج العراقي» كمخرج للأزمة السورية محورا لمقالين سابقين، رصدتُ فيهما الانقسام الفكري السوري بين مدرسة تحذيرية تخشى تفتيت الهوية عبر المحاصصة، ومدرسة واقعية تراه ضابطاً للجغرافيا من التحلل، وأخرى مثالية تتشبث بالمواطنة المطلقة. ومن خلال تشريح التجربة العراقية، خلصتُ إلى ضرورة إيجاد طريق ثالث يتجاوز عيوب المركزية الصلبة وفوضى المكونات، وهو ما أسميته «شراكة المواطنة المطمئنة»، ذاك المسار الذي يرفض المحاصصة الجامدة ويستبدلها بـ «وضوح بناء» في النصوص الدستورية، يضمن الأعتراف بالتنوع كحق أصيل لا كامتياز سلطوي، ويُفعل لامركزية وقائية تفك الاشتباك حول المركز، مع حصر التمثيل المكوناتي في غرفة برلمانية ثانية (مجلس شيوخ) تضمن الأمان التوافقي دون تعطيل فاعلية الدولة أو ارتهان سيادتها. البحث عن الطريق الثالث ليس نقاشاً فكريا مستحدثا أملته ظروف سوريا ما بعد حرب عام 2011، بل هو استعادة واعية لإرث دستوري سوري تم تهميشه لعقود لصالح النماذج المركزية الصاهرة. وهنا تبرز القيمة الاستثنائية لأطروحة الدكتور (حلمي اللحام) التي نال عنها شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون عام 1941 عن النظام الدستوري في سوريا تكمن الإثارة في هذه الأطروحة المنسية أنها كُتبت في لحظة فارقة من تاريخ سوريا تحت الانتداب الفرنسي، حيث قدّم اللحام تشريحا قانونيا جادل فيه بأن الهيكل الإداري لدمشق لا يمكن أن ينجح إلا إذا تحول من «مركزية استعمارية» إلى «لامركزية ميثاقية». لقد كانت الأطروحة تمثل أول «نبوءة قانونية» حذرت مبكرا من أن إنكار التنوع السوري سيؤدي حتما إلى انفجار الهويات الفرعية، حيث ذهب اللحام إلى أبعد من مجرد التنظيم الإداري، مطالبا بما يمكن تسميته «دسترة التوافق» قبل عقود من ظهور نظريات الديمقراطية التوافقية الحديثة.
لقد كان اللحام سبّاقا في نقده للمركزية العمياء، داعيا الى فكرة قريبة من ما أسميناه «الوضوح البناء» عبر دسترة الخصوصيات المكوناتية (من أكراد ودروز وعلويين وسريان وسائر أطياف المجتمع) كـ «صمام أمان» يمنع النزعات الانفصالية. و بذلك تتطابق فكرة اللامركزية كعقد وطني تماماً مع جوهر شراكة المواطنة المطمئنة، في إيمان عميق بأن المكون الذي يشعر بالأمان الدستوري داخل حدود الدولة لن يبحث عن حماية خارجها، مما يثبت أن أزمة المشرق لم تكن يوما نقصاً في الأفكار، بل في غياب الإرادة السياسية لتبني «الوضوح القانوني» بديلاً عن الهيمنة والإنكار. تقاطعت رؤية اللحام مع القراءة التي قدمها المؤرخ ألبرت حوراني في كتابه الكلاسيكي: سوريا ولبنان: مقالة سياسية، الصادر عام 1946. إذ رصد حوراني في كتابه هشاشة الدولة المركزية الموروثة عن الانتداب محللا كيف أن بنية الدولة الجديدة في المشرق لم تكن تعكس نسيج المجتمع الحقيقي، محذراً من أن تجاهل الخصوصيات المكوناتية باسم القومية الشاملة لن يفضي إلا إلى استياء دائم في الأطراف. لقد جادل حوراني، وهو صاحب المؤلفات الأشهر التي أرّخت لليقظة العربية، بأن الاستقرار المستدام لا يُبنى بالوعود العاطفية أو الخطابات القومية الحماسية، بل يرتكز على قدرة الأغلبية على تقديم ضمانات ملموسة للمكونات عبر مؤسسات صلبة، وهو ما يمثل الجوهر السياسي لما أسميناه «شراكة المواطنة المطمئنة». وبين رؤيتي اللحام القانونية ورؤية حوراني السوسيولوجية يقدم برهان غليون في كتابه المرجعي (نظام الطائفية: من الدولة إلى القبيلة) 1990 تشريحاً بنيويا لأزمة الدولة في المشرق. تكتسب أطروحته أهمية استثنائية لكونها النسخة المتطورة لرؤيته التي بدأها في كتابه الأسبق (المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات) 1979، وبينما ركز في السبعينيات على نقد الفشل في دمج الأقليات، جاء في التسعينيات ليعلن أن الطائفية ليست تخلفاً اجتماعيا أو حقائق لاهوتية موروثة، بل هي نظام سياسي حديث وصناعة أنتجتها الدولة الوطنية الفاشلة لتعويض غياب شرعيتها الديمقراطية. هذا التشخيص يتقاطع بشكل عضوي مع نقدنا لظاهرة «مقاولي الهويات» وما أسميناه «البزنس الطائفي»، حيث تتحول الهوية من ثراء ثقافي إلى رأسمال سياسي تستخدمه النخب للاستحواذ السلطوي. يثبت غليون أن الطائفية تتحول من «هوية» إلى «أداة سياسية» للاستحواذ السلطوي عندما يغيب الوضوح القانوني.
إن استعادة غليون اليوم، تمنح دعوة «الوضوح البناء» أصالة فكرية، مؤكدة على أن المواطنة لا تتحقق بإنكار الخصوصيات (كما حاول الفكر القومي القديم)، بل بالاعتراف بها ضمن عقد اجتماعي يمنع تحولها إلى قبائل سياسية تتصارع على الدولة. تؤكد رؤية غليون أن المواطنة المتساوية لا تتحقق بإنكار الخصوصيات، بل بالاعتراف بها كجزء من عقد مواطنة شفاف يمنع تحول الهويات إلى «خنادق مواجهة» أو «قبائل سياسية» تتصارع على الغنيمة. وبذلك، تتبلور شراكة المواطنة المطمئنة كخيار عملي يحول المكونات من أدوات للاستقطاب السياسي إلى ركائز متينة لدولة القانون، محققةً بذلك التوازن المنشود بين الأمان القانوني الذي نادى به اللحام، والوضوح السوسيولوجي الذي أرساه غليون في سياق البحث عن الطريق الثالث، تبرز رؤية الراحل ميشيل كيلو كركيزة لا غنى عنها لفهم مآلات الدولة السورية، ففي كتابه (من الأمة إلى الطائفة: سورية في حكم البعث والعسكر) الصادر عام 2021، وضع إصبعه على الجرح النازف المتمثل في انفصام الدولة بين ادعاء الوحدة المجرّدة وممارسة الإقصاء الممنهج للأطراف.
لقد كان تحذير كيلو حاسماً حين اعتبر أن الاستقرار المفروض بالقوة باسم المركزية الصلبة هو أقصر طريق للتفتت، وهي النتيجة المأساوية التي نعيش ارتداداتها اليوم. ومن هنا، تكتسب فكرة اللامركزية الوقائية شرعية تاريخية وميدانية من قراءة كيلو لظاهرة ترييف المدن وتهميش الأطراف (كدير الزور والحسكة)، إذ يرى أن اغتراب هذه المناطق عن المركز لم يكن قدراً، بل نتيجة لغياب العقد الاجتماعي الشفاف. وبناءً عليه، لا تكتمل شراكة المواطنة المطمئنة إلا بتحويل هذه الأطراف المغتربة إلى مركزيات محلية فاعلة عبر وضوح دستوري يضمن أن تكون شريكة في السيادة لا مجرد ملحقات إدارية. إن هذا الانتقال من الاستقرار القسري إلى الاستقرار المتوافق عليه هو الرد العملي على مخاوف التفتت، والنقطة الجوهرية التي يلتقي فيها كيلو مع اللحام وحوراني وغليون؛ حيث المخرج ليس في إنكار التنوع ولا في القبول بمحاصصة مشوهة، بل في الانتقال الشجاع نحو دولة لجميع المواطنين تقوم على الوضوح البناء والاعتراف المتبادل. إنَّ أولى خطوات الانتقال من سلبيات النموذج العراقي إلى نموذج سوري مستدام تبدأ بكسر الازدواجية القاتلة التي رصدها ميشيل كيلو، فبينما سقط العراق في فخ «الغموض» الذي سمح للمكونات بابتلاع الدولة، عانت سوريا لعقود من «زيف الوحدة» الذي أخفى خلفه عصبوية ضيقة استنزفت مفهوم المواطنة.
ومن هنا، تبرز ضرورة تبني «الوضوح البناء» كحجر زاوية في العقد الاجتماعي الجديد، وهو ما يعني الاعتراف الصريح والناجز بالتنوع المكوناتي في الدستور (كما أراد اللحام) لا بهدف تقسيم الدولة كغنائم بين الطوائف، بل لنزع صفة «المؤامرة» عن الخصوصيات الثقافية والدينية. إنَّ هذا الوضوح كفيل بتحويل الطائفية من «أداة نخب» وصناعة سياسية (بتوصيف برهان غليون) إلى مجموعة من «الحقوق الثقافية المضمونة دستوريا». إنَّ دسترة التنوع وفق هذا المنظور هي الضمانة الوحيدة لمنع تحول التعددية إلى «لغم موقوت» ينفجر عند كل أزمة سياسية، وهي الكفيلة بنقل المكونات من حالة «الاستنفار الوجودي» إلى حالة «الاستقرار القانوني»، حيث يصبح الانتماء للمكون مدخلاً لإثراء الهوية الوطنية الشاملة لا بديلاً عنها. لقد أثبتت التجربة السورية، كما ناقشتُ في المقالين السابقين، أنَّ الصراع المحموم على «المركز» هو المحرك الأساسي لعدم الاستقرار. وهنا تبرز عبقرية حلمي اللحام المبكرة في طرح «اللامركزية الوظيفية» كحل بنيوي. إنَّ مناطق كدير الزور والحسكة والرقة، التي وصفها ميشيل كيلو بأنها «أطراف مغتربة» تعاني تهميشا تنمويا وإداريا، لن تشعر بالانتماء الحقيقي للدولة ما لم تكن شريكة فاعلة في القرار المحلي. ليست اللامركزية الوقائية التي نقترحها خطوة نحو الانفصال كما يروج دعاة المركزية الصلبة، بل هي أداة طمأنة استراتيجية. فعندما يمتلك المكون المحلي سلطة إدارة شؤونه اليومية وتنمية موارده، يتقلص لديه حافز الاستقواء بالخارج أو الصدام مع المركز، وبذلك تتحول اللامركزية من هواجس التقسيم إلى صمام أمان لوحدة التراب الوطني. ولتجنب الشلل المؤسساتي الذي أصاب النموذج العراقي نتيجة «الفيتو الطائفي» المعطل للحكومات، نقترح في الحالة السورية فصل الهوية عن السيادة عبر مأسسة التوافق في غرفة تشريعية ثانية. في هذا النموذج، تظل الحكومة ومؤسسات الجيش والقضاء قائمة حصراً على الكفاءة الفردية المطلقة (المواطنة)، بينما يُنقل تمثيل المكونات إلى مجلس شيوخ.
هذا المجلس لا يتدخل في تفاصيل الإدارة اليومية للدولة، بل يمارس دور «حارس الهوية»، حيث يملك حق النقض فقط في القضايا التي تمس الوجود الثقافي أو الديني للمكونات. إنَّ هذا البناء يحقق «الأمان القانوني» الذي نشهده في طروحات اللحام، ويضمن بقاء الدولة كمؤسسة فاعلة، مانعاً تحول التوافقية إلى أداة للتعطيل السياسي أو المحاصصة الوظيفية الفاسدة. تكشف مراجعة أطروحات اللحام، وحوراني، وغليون، وكيلو، لنا بوضوح أنَّ العقل السياسي السوري كان دائما، وعبر العقود الماضية، يبحث عن توليفة تجمع بين وحدة الدولة وحقوق الجماعات. إنَّ الاستفادة من النموذج العراقي في الحالة السورية لا تعني بحال من الأحوال استنساخ «المحاصصة» المشوهة، بل تعني الانتقال الشجاع من منطق الإنكار الذي يؤدي للانفجار إلى منطق الاعتراف الذي يؤدي للاستقرار. ونعتقد بإن فكرة «شراكة المواطنة المطمئنة» هي الحل السوري الذي يزاوج بين مثالية المواطنة وواقعية التنوع. إنها الرؤية التي تحول سوريا من ساحة لتصادم الهويات المرتهنة للخارج، إلى وطن يتسع للجميع بقوة القانون والوضوح الدستوري، لا بقوة الإنكار أو القمع المركزي.