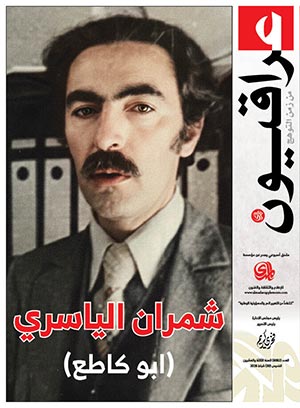سعد سلوم
(1-2)
تتشكل «المسألة السورية» في منظور النخب السياسية العراقية كجزء من جغرافيا قلقة، حولت الحدود إلى عقد تاريخية متشابكة. فبينما يواجه العراق هواجس المياه مع تركيا، وعقدة الإفتقار الى نافذة بحرية مع الكويت، والتوجس من طموح إيران التوسعي، تبرز سوريا كضلع رابع يربط أمن بغداد بدمشق برباط لا ينفك، يعكس «صراع سرديات» بين نموذجين: دمشق التي تعتمد على إرثها الأموي، والذكاء السياسي، وفن المناورة. وبغداد التي تتبنى التقاليد العباسية المرتكزة على قوة الجيش والمال والمركزية الصارمة. وهذا يفسر لماذا لم يقد التشابه الأيديولوجي (فترة حكم البعث للبلدين) إلى الوحدة، بل إلى تنافس لى حق التفسير ومركزية القيادة.
اجتازت العلاقات العراقية السورية محطات قاسية، من “الارتياب الأخوي” عام 1920 الذي فصل بين حلمي العاصمتين بعد فشل حكومة فيصل الأول في دمشق التي أجهز عليها الفرنسيون، إلى “الإعصار الناصري” الذي دفع دمشق للهروب نحو الوحدة مع القاهرة عام 1958 وغلق البوابة الشرقية أمام طموحات بغداد الهاشمية. ومع وصول البعث للسلطة في البلدين 1963 تحول الجاران إلى “إخوة أعداء” يتنافسون على قيادة المشرق.
اليوم، وفي مطلع عام 2026، تجاوزت سوريا تصنيف “المنافس التقليدي” لتصبح قضية أمن وجودي بامتياز. إذ بات صانع القرار في بغداد يوقن أن أي خلل يصيب الهيكل السياسي في دمشق سيمتد أثره فورا ليزعزع أحياء الموصل وشوارع العاصمة، مما يجعل استقرار الجار الغربي ضرورة حيوية تتقدم على كل الحساسيات التاريخية.
قطع تصور النخب السياسية العراقية رحلة من التحولات، بدأت برؤية دمشق كمشروع للتوسع في العهد الملكي، ثم انتقلت لتصبح مصدر قلق حين ارتمت في أحضان القاهرة لصد طموحات بغداد الهاشمية، وهو ما حوّل الجغرافيا السورية آنذاك إلى منصة لنفوذ إقليمي يحاصر العراق أما اليوم، فقد استقرت في الوجدان السياسي كـ “صمام أمان” لا غنى عنه، فالحقيقة الجيوسياسية الراهنة تؤكد أن سلامة البيت العراقي باتت مرهونة، أكثر من أي وقت مضى، بتماسك البنيان السوري.
وفق الرؤية أعلاه، يواجه العراق اليوم معضلة أمنية رباعية الأبعاد، فبينما تركت الحرب مع إيران (1980-1988) أثراً لا يمحى من التوجس تجاه الجار القوي في الشرق، يبرز مع الكويت في الجنوب خوف مزمن من فقدان النافذة البحرية الصغيرة على العالم عبر الكويت، في حين تظهر تركيا في الشمال كضلع يتحكم في رئة العراق المائية بمفاتيح تضع بغداد في قلق دائم من العطش أو خسارة السيادة الحدودية.
يكتمل الضلع الرابع لهذه المعضلة بما يمكن أن نطلق عليه : المسألة السورية. وهي تمثل صدعا من نوع خاص يختلف نوعياً عن بقية الأضلاع، فهي ليست مجرد نزاع مادي حول مياه أو حدود، بل هي ارتباط أمني عضوي ووثيق يربط استقرار بغداد بدمشق في حالة من التوجس المتبادل بين نظامين يتشابهان في اللغة والانتماء القومي والتنافس الحزبي التاريخي، مما حوّل دمشق في نظر بغداد إلى ساحة حيوية تعكس أزمات العراق وتطلعاته، ومنافساً قوياً على الريادة يمتلك القدرة على نقل التوترات أو إيواء القوى المعارضة. وبناء عليه، تبرز سوريا كضلع مكمل ومصيري في قلق العراق الوجودي، فإذا كانت تركيا تمسك بمفاتيح “الماء”، فإن سوريا تمسك بمفاتيح “البقاء».
إن حالة الحذر المزمنة بين بغداد ودمشق هي ثمرة اختلاف تاريخي عميق في فهم القوة وكيفية ممارستها. او صراع سرديات بين دمشق الأموية وبغداد العباسية. وما يزال صراع السرديات مستمرا كخيط ناظم يربط التاريخ بالواقع الحالي، حيث انتقل جوهر التنافس من النزاع على الحدود إلى الصراع على الهوية وقصة الحق والشرعية. ففي الوقت الذي تحاول فيه دمشق إحياء السردية الأموية كرمز لسيادتها وريادتها التاريخية للمشرق، تنظر بغداد إلى هذه المحاولات بعين الريبة، وترى فيها تحديا لشرعيتها التي صاغتها تحولات ما بعد 2003. وهكذا، لم تعد القوة تُقاس بالأدوات العسكرية فحسب، بل تحولت إلى مواجهة مفتوحة بين رؤيتين متناقضتين للتاريخ والمستقبل.
ولأجل تفكيك هذه العلاقة الملتبسة، يغوص المقال في كواليس العقل السياسي العراقي ليرصد تحولاتها عبر محطات زمنية مفصلية، بدأت بتنافس الشرعيات في العهد الملكي، مرورا بقطيعة “الإخوة الأعداء”، وصولاً إلى زلزال عام 2003 الذي حوّل سوريا من ملاذ آمن للمعارضة إلى بوابة قلقة تهدد كيان الدولة الناشئة.
وصولا إلى اللحظة الراهنة، سنحلل الانقسام العميق للنخبة العراقية أمام ملامح “سوريا الجديدة” عام 2026، حيث تتصارع رؤيتان: مدرسة الواقعية البراغماتية التي ترى في استقرار الجار ضرورة للبقاء، ومدرسة التوجس العقائدي التي تخشى من ارتدادات العدوى الطائفية. إنها رحلة في وعي صانع القرار الذي بات يوقن أن أمن بغداد يولد من استقرار دمشق.
مثل عام 1920 نقطة الفراق الجوهرية بين مسارين للوحدة العربية، فمع سقوط مملكة فيصل الأول في دمشق، عادت النخب الهاشمية والضباط العراقيون إلى بغداد محملين بمرارة الهزيمة وطموح التعويض، لينشأ صراع عميق بين مدرستين: “المدرسة الرافدينية” التي تبنت نموذج “بروسيا العرب” أو (دولة القوة) التي ترتكز على موارد ضخمة (جيش ونفط) وتريد فرض إرادتها. و”المدرسة الشامية” التي جسدت نموذج “أثينا العرب” أو (دولة الدور) التي لا تكمن قوتها في مواردها، بل في الدور الذي تلعبه والملفات التي تمسك بها. وهكذا تحولت العلاقة إلى ارتياب متبادل بين بغداد التي تؤمن بأن “القوة تصنع الحق”، ودمشق التي رأت في “الحق التاريخي والرمزي” درعاً يحمي الدولة من الذوبان في نفوذ الجار القوي.
بناءً على هذا التباين، لم يولد مشروع “الهلال الخصيب” الذي طرحه نوري السعيد كخطة للتكامل العربي المنشود، بل قرأته دمشق بوصفه أداة لتوسيع النفوذ الملكي العراقي بعباءة بريطانية، ومحاولة لابتلاع جمهوريتهم الناشئة. ومن هنا تكرست الثنائية التي حكمت العلاقة لعقود: عراقٌ يرى في سوريا بوابةً لشرعيته الكبرى وامتداداً حيويا لا يكتمل ملكه بدونه، وسوريا ترى في العراق تهديداً لسيادتها النوعية ومحورا يريد فرض الوصاية عليها. لقد كانت تلك الحقبة هي المختبر الأول الذي أنتج نمط “التوجس المتبادل”، لتبدأ منذ ذلك الحين قصة بلدين لا يملكان رفاهية الانفصال الجغرافي، ولا يطيقان ألم الاقتراب السياسي.
أما المحطة الثانية، فقد تبلورت مع الإعصار الناصري، فبحلول منتصف الخمسينيات، دخل المتغير الناصري كإعصار أعاد ترتيب موازين القوى، حيث وجدت دمشق نفسها بين خيارين: التبعية لحلف بغداد الهاشمي أو التحالف مع قاهرة جمال عبد الناصر. وهنا تجلت عبقرية المناورة السورية باختيار الوحدة مع مصر عام 1958، وفضلت دمشق أن تكون “قلب العروبة” في جسد مصري بعيد، على أن تكون “محافظة ملحقة” بعرش بغداد المجاور.
في المقابل، رأت بغداد في هذه الوحدة خسارة استراتيجية، فبدلا من احتواء سوريا، وجد العراق نفسه محاصرا بالنفوذ المصري على حدوده الغربية. هذا التحول سلب بغداد بساط الريادة المشرقية لصالح القاهرة، وحوّل سوريا في العقل الأمني العراقي من جغرافيا يُطمح لضمها إلى مصدر تهديد وجودي، مما مهد الطريق لانقسامات أيديولوجية عميقة.
بعد انكسار تجربة الوحدة عام 1961، استقر في وجدان دمشق وعيٌ مرير بأن مشاريع الوحدة (مهما كان مصدرها) تحمل في طياتها بذور التهميش السيادي. ترسخت لدى النخبة السورية حساسية سيادية مفرطة، بينما تضاعفت في بغداد نبرة الريبة تجاه تقلبات المزاج الشامي. وهكذا، أضاع الجاران فرصة التكامل التدريجي، لتدفع سوريا كلفة سيادتها مرتين، ويخرج العراق بإحباط عميق حوّل شريكه الغربي في نظره إلى لاعب غير موثوق.
مع حلول المحطة الثالثة، دخل الجاران عصر الإخوة الأعداء الذي استُهل عام 1963 بنقطة انكسار مذهلة، فبينما بدا أن حكم حزب البعث لعاصمتين متجاورتين هو ابتسامة “القدر الجيوسياسي” لمشروع الوحدة، كشف الواقع عن صراع حول مركزية القيادة: هل المرجعية لدمشق بوصفها “أثينا الرمز”، أم لبغداد بوصفها “بروسيا القوة”؟. هذا التنازع لم يُجهض مشاريع الوحدة فحسب، بل انتهى بزلزال عام 1966 الذي شطر الحزب إلى مسارين متوازيين، لتبدأ ملحمة صراع الإخوة الأعداء.
ومع صعود حافظ الأسد وصدام حسين، تحول التشابه الأيديولوجي الى أداة لخلق تنافس محموم على الأصل ومن يملك “حق التفسير. وهكذا، وبدلا من أن يؤدي التماثل الحزبي إلى اللقاء، تحولت العلاقة إلى حرب باردة مصغرة بين عراق يفيض بالنفط والمركزية العسكرية يطلب الولاء، وسوريا تستثمر في موقعها كـ “بيضة قبان”، مما حول المشرق العربي إلى ساحة مواجهة تُدار بالدسائس والأجهزة الاستخباراتية.
بلغ الصدام طريقا مسدودا في الثمانينيات، حين اختارت دمشق الوقوف مع إيران ضد بغداد. لم يكن هذا الموقف مجرد تصفية حسابات شخصية، بل كان تخطيطا سوريا يخشى ولادة عراق قوي لدرجة مخيفة يبتلع بانتصاره استقلال القرار في دمشق. رفض الأسد آنذاك أن يعيش تحت ظل جار مهيمن، مقدما حماية استقلال بلاده على التضامن القومي.
في تلك الحقبة، تحولت دمشق إلى ملجأ للمعارضين العراقيين، وفي مقاهيها تشكل وعي النخب التي حكمت بغداد لاحقاً بعد 2003. و نشأت آنذاك علاقة قائمة حذرة بين معارضة عراقية وجدت الأمان في دمشق، وسلطة سورية رأت في هؤلاء الضيوف أوراقا رابحة للمستقبل.
كشفت هذه التجربة أن الرغبة في الزعامة الفردية حين تسيطر على الحكام، تحول الأفكار الوحدوية من جسر يجمع الشعوب إلى سلاح يبرر العداء. ومع مطلع الألفية، اتسعت الفجوة لتتحول من خلاف على حدود إلى صراع عميق على من يملك القوة ومن يفرض إرادته. وهو الإرث الثقيل الذي ظل عالقا بين البلدين حتى الغزو الأميركي لبغداد عام 2003، ليبدأ فصل جديد لم تعد فيه سوريا مجرد منافس، بل أصبحت بوابة لضمان البقاء.