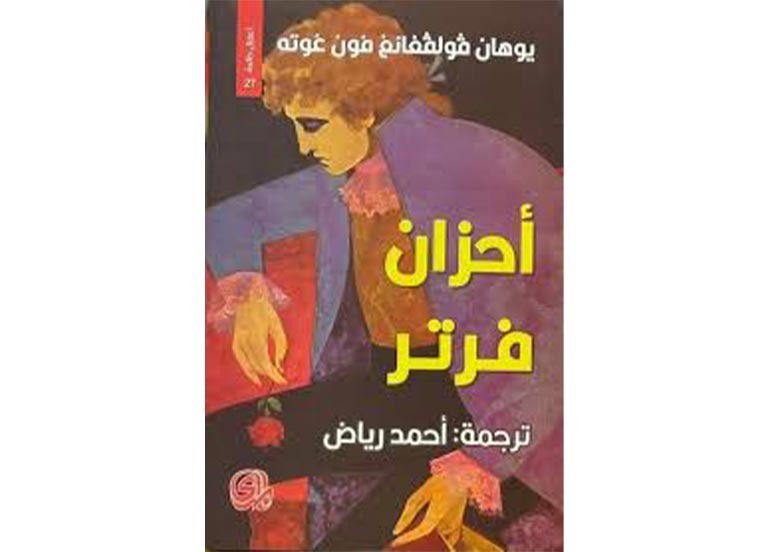د. غادة العاملي
بعد جولة في دار الذهبي، وبعد أن أخذ منا التعب والذهول من فرط الإعجاب، جلسنا في كابينة صغيرة تقدم وجبات سريعة ساندويتشات البرغر والشاورما والبطاطا المقلية. في شارع بغداد داخل البيت العراقي للابداع، كنت برفقة هشام الذهبي، وعدد من الأصدقاء: د. عبد العزيز البدري، د. حسين السعدون، المخرجة السويسرية العراقية عائدة، الدكتور الصيدلي عمار القادم من روسيا، والشاب سجاد صاحب دار جيم. أدار الجلسة الشاب صلاح احد أبناء الدار، وقدم لنا الطعام مشاكس الدار "تفاحه" ، وهو من مشاهير التيك توك.
الباب مفتوحا، يدخل منه الأولاد مستفسرين أو محيين، يحومون حول والدهم وضيوفه بفضول المحب.كانت الإشارات بطرف العين كافية للفهم ، إيماءة بسيطة من الذهبي تختزل جملا كاملة، يفهمها الأبناء فورا. يحفظ أسماءهم، مراحلهم الدراسية، مواهبهم، ما يدرسون، ماذا يأكلون، وماذا يحبون. تذوقنا ما أنتجته أيديهم من طعام يفاخرون به ويقدمونه للزائرين ضمن مشروع الدار، ثم نهضنا نتجول في أروقة المكان.
على مساحة اكثر من ١٠٠٠ متر توزعت الصالات، غرف استراحة ومعيشة غرف مشاهدة تلفزيون، مكتبات، عيادات أسنان، ورش خياطة، ملاعب، ألعاب، ساحات كرة، جدران تحمل نتاجاتهم الفنية، غرف حاسوب وتكنولوجيا حديثة، غرف اجتماعات أنيقة. وسلسلة مطاعم، المكان أشبه بمغارة علي بابا، كل ما تسأل عنه تجده أمامك.
صادفني اثناء الجولة طفل بعمر يقارب الثامنة. كان مبتسما، وملامح وجهه تحمل فخرا واعتزازا وطمأنينة . لفت انتباهي جمال بلوزته البيضاء الأنيقة. ودون بقية الأطفال، رفع يده ليصافحني. رفعت يدي، ولاحظت بطئا في حركته لم أفهم سببه إلا حين شد قليلا على يدي وغمزني بعينه بفخر.
كان فخورا بيده الاصطناعية.
ثم انتبهت… لم تكن يدا واحدة.
كلتا يديه كانتا اصطناعيتين، مبتورتين من الكتفين.
كان عائدا لتوه من رحلة علاج وتدريب خارج العراق.
بريق عينيه كان يتحدث عن فرحه بعودة يديه، وبعودته إلى لمس الحياة من جديد.
لا يوجد بينهم مكسورا، ولا مهموما، ولا وجها بلا جمال.
دخلت صفوفهم، فوجدت هندسة دقيقة للإدارة، وهندسة واعية للوعي، وهندسة إنسانية ذكية تجعلك جزءا من الكل أينما كنت.هناك زهد نادر… وتعالٍ هادئ ولده الشبع والاكتفاء.
ما يفعله هشام الذهبي يبدو نقيضا لكثير من الفلسفات والتنظيرات الهشة والمراوغة .
قرر هذا الرجل أن يبني مدينته الذهبية بعيدا عن أفلاطون وجمهوريته الفاضلة. هو لا يبدأ من الدولة، ولا من المثال، بل يبدأ من الطفل بوصفه غاية لا وسيلة. تجسد هذا الحلم على الأرض بتجربة لم تسبقها تجربة، ولن تسمى بعدها تجربة أخرى.
تجربة تقوم على الإيمان بالفرد بوصفه مؤسسة أخلاقية، أُسسها صدق المشاعر ولا غاية أخرى.
تقرأ في هذه الدار آلاف القصص. في كل واحدة منها دراما كاملة، عملا فنيا يسرد ضيم هذا البلد وقهر أبنائه.
إنها قصة العراق الخفي، المسكوت عنه، قصة ألف ليلة وليلة… ولكن لهذا الزمان.
بعد الاحتلال، وتحديدا عام 2004، بدأ مشروع الذهبي في رعاية الأطفال المشردين في بيته الصغير بمدينة الصدر.
لا دولة، لا مؤسسة دولية، لا شعارات.
فرد واحد آمن بالإنسان، فآمن بنفسه، واستطاع أن يجسد مفاهيم حقوق الإنسان ممارسة يومية لا خطابا.
علاقته بأطفاله قائمة على المعرفة، والرعاية، والاحتواء.
الطفل هنا هو صاحب المكان، وصاحب القيمة، وصاحب السلطة المعنوية الكاملة.
مكان مفتوح، مرئي، يمكن دخوله والخروج منه بسلام.
مكان قائم على الانتماء لا العزلة، وعلى الثقة لا الخوف.
أطفال أسوياء، وشباب منفتحون على الحياة.
وفي الجهة الأخرى من العالم، يتجلى نموذج مغاير تماما.
العالم الغربي، الذي لا يتردد في اتهام الشرق بالإرهاب والتخلف، سمح لجيفري إبستين أن يبني منظومة كاملة لاستغلال الأطفال، داخل فضاءات مغلقة ومعزولة، تقوم على الإخفاء والتواطؤ، وتحكمها السلطة والجاه والمال وشهرة الأفراد.
هناك، لم يكن الاستغلال فعلا فرديا معزولا، بل نتاج فكر مشوه يرى الطفل جسدا قابلا للاستخدام، وترى الإنسان وسيلة لا غاية.
علاقة قائمة على السرية، والابتزاز، وكسر الإرادة، وتحطيم الأطفال وذويهم نفسيا وإنسانيا.
حمت هذه المنظومة دول، وإعلاما عالميا، وشخصيات سياسية واجتماعية نافذة، وقضاء حاول تجميل الصورة بعد إغلاق الملفات الأولى عام 2005.
وبصمت النخب الفكرية أو مشاركتها في التغطية، تحولت الجريمة من فعل مدان إلى منظومة حصينة، غير قابلة للكسر. أنتجت ضحاياها أطفال محطمون، بذاكرة جريحة، وعدالة لزجة..
الغرب الذي يتهم الشرق بالتخلف، أنتج إبستين وحماه. والعراق الحالم لا المنكسر رغم الفوضى انتج عراقياً من زمن الحلم "هشام الذهبي" ليعمل بصمت ورجاء