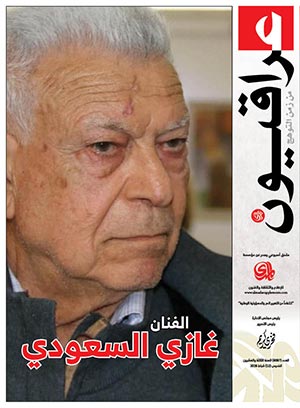شاكر الأنباري كانت أول رواية نشرتها هي الكلمات الساحرات، وذلك عام 1994، وكنت أعيش وقتها في الدانمارك، أي بعد اثنتي عشرة سنة من خروجي من العراق. زمن الأحداث هو السبعينيات، والمكان هو قرية فراتية تعيش إيقاعها الخاص، الشبيه، من جانب ما، بمعظم القرى العراقية، أو الريف عموما. بعد هذه الرواية أصدرت سبع روايات أخرى هي ألواح،
وموطن الأسرار، وكتاب ياسمين، وليالي الكاكا، والراقصة، والبلاد السعيدة، وأخيرا نجمة البتاوين. وطبعا لم أكتب الرواية فجأة بل سبق ذلك خمس مجموعات قصصية، أوصلتني، خطوة خطوة، إلى عالم الرواية. وجدت أن الجملة القصيرة، والحدث الصغير أو الآني، والشخصية الواحدة أو الشخصيات المعدودة، واللمحات الفكرية والسياسية والجمالية للقصة، كل ذلك وغيره لم يعد كافيا لاستيعاب تجربتي الثقافية، والشخصية، وفهمي المشهد العراقي والإنساني بشكل عام. فالرواية كما هو معروف عالم فني يستلهم الواقع، يخلقه، يصوغه، ويعيد تشكيله، وهذه العملية تحتاج إلى جهد ذهني كبير، وحساسية فنية عالية، سواء في اللغة أو أساليب كتابة الرواية. وصياغة عالم فني، أو خلقه، يحتاج هو الآخر إلى معرفة موسوعية، أو على الأقل تتطلب ذلك. هذا ما دفعني إلى وضع بوصلة لنفسي في محاولة لاكتشاف حقول معرفية كثيرة، سواء باللغة العربية أو الانكليزية أو الدانماركية، كالفضاء ومصطلحاته، والفلسفة، والأساطير، وكتب السير، مرورا بالتراث العربي. وكذلك المفاهيم الحضارية لثقافات أخرى، واهتمام بالموسيقى، والفنون البصرية. كل حقل من تلك الحقول كان يضيف لي كلمات، ومصطلحات، وأفكاراً، ومعارف، اعتقدت دائما إن وجودها وإدراكها وامتلاك بعض منها، يعمق من النص الروائي، طالما هو نص يبني، ويشكّل، ويعيد صياغة حياة أخرى هي حياة الرواية. مرة من المرات قرأت كتابا يخص العشائر العراقية، وآخر عن الأمثال الشعبية، والحكايات العامية، في محاولة لفهم الروح العراقية وبعدها التاريخي، وكل هذا يغني عالم ما وراء النص ويعطيه حيوية ذهنية وجمالية ولغوية. كانت أجوائي الروائية بشكل عام هي أجواء عراقية، نكهتها، روائحها، مكانها، وهمومها. بعد الخروج من العراق، تحت ضغط الأوضاع السياسية والحروب والتابوات الاجتماعية، تحتم على الجميع إعادة النظر بذلك التاريخ القريب كله، التأمل فيه، وقراءته، وتكوين وجهة نظر معينة عنه. بمعنى ما تكوين رؤية عن البلد الذي خرجت منه، بعيدا عن الرقابة البوليسية والممنوعات الدينية والاجتماعية التي سادت في عقدي السبعينيات والثمانينات، باعتبارهما العقدين اللذين عاصرتهما، واعيا، قبل الخروج. من هنا فالكتابة، روائيا، عن تلك الأزمان هو نوع من إعادة التقييم، وإعطاء موقف عن كل شيء، عبر شخصيات عاشت في تلك الظروف، حروب، قمع سياسي، وتابوات اجتماعية، وهجرات، ومغامرات ثورية، وعلاقات مع نساء، أي كل ما عاشه الفرد العراقي البسيط في الحقبة الأخيرة. كرست جزءا طويلا من روايتي ليالي الكاكا عن حياة الثوار في جبال كردستان، والطبيعة المكانية هناك، وأحلام القرويين البسطاء في حياة كريمة آمنة. ومن خلال رؤيتي الحدث العراقي تبينت إن الدراما العراقية تأخذ أشكالا ومسارات لا حصر لها، وهي أجواء قد تكون متشابهة لدى الجميع، وان اختلفت في التفاصيل. وهي دراما لا تنفصل مشاهدها وحكاياتها، تتلازم عبر شخصيات وذكريات وأحلام، لا تنفصل سواء كان الفرد مستقرا في مكانه أو خرج إلى المنفى ليعيش مستوى آخر من التجربة ، تجربة الاغتراب والهروب من بلد إلى آخر والحنين إلى الماضي، الذي هو حنين إلى المكان، والطقوس، والأشخاص، والأطعمة، والحكايات، والآلام في الوقت ذاته. لذلك كانت رواياتي تقدم جوا روائيا أكثر ما تقدم شخصيات نموذجية في رواية، فأنت حين تكتب عن بغداد التسعينيات لا يمكن لك تجاوز آثار الحروب والحصار والكبت السياسي والمعاناة الجنسية ودمار الأمكنة. أصبح ذلك بصمة لمعظم الروايات العراقية سواء التي كتبت في الداخل أو الخارج. ولأن رواياتي تقدم أجواء لأحداث وشخصيات وأمكنة ملتصقة بالتحولات العراقية في العقود الأخيرة، لذلك عادة ما قدمت فيها أمكنة مختلفة تخص أكثر من بلد، كالشام والدانمارك وإيران والعراق وغيرها، كون السيرة العراقية، الدراما متلازمة الفصول منذ مطلع عقد الثمانينيات من القرن العشرين، تنتشر على مساحات واسعة. مساحة تبتدئ في العراق ولا تنتهي في دول الجوار وأوربا وأميركا واستراليا وأميركا اللاتينية. والشخصيات مسكونة ببيئات مختلفة، وتلح عليها أزمان مختلفة أيضا، حتى تصل الحالة أن تتشابه بعض الشخصيات لتغدو تكرارا لماض ومكان سابق، وهذا ما طرحته في روايتي ليالي الكاكا، حيث شخصية نوري تتكرر في حدثين، لكن نوري الأول يختلف عن نوري الثاني، وان كانا يحملان الاسم ذاته. هذه المفارقة، وغيرها، أصبحت محسوسة في تاريخ الهجرات العراقية، وفي الزمن العراقي المتقلب، المتداخل، الدائر على نفسه أحيانا كشرنقة مغلقة. معظم الشخصيات التي كتبتها في رواياتي كانت تحلم بالماضي، وتنتظر أن تعود إلى عراق أكثر جمالا وعدلا، لذلك كان كل فرد يمتلك داخليا عراقه الخاص، بيئته الأولى، يحن إليها كل يوم، ويعود إليها في أحلامه، وتلح عليه لدرجة أنها تلوث حاضره ذاته. وهي تجربة مر بها معظم العراقيين الذين غادروا العراق
التجربة الروائية لا تكتمل مثل الحياة ذاتها

نشر في: 9 أكتوبر, 2011: 07:55 م