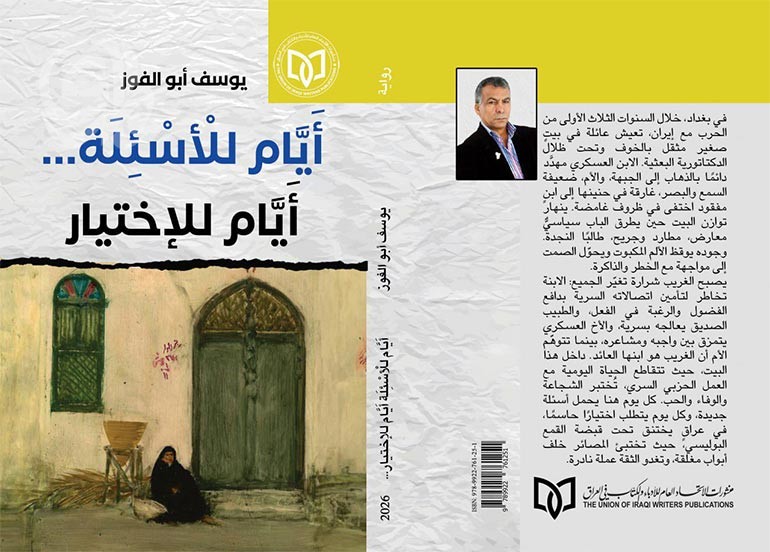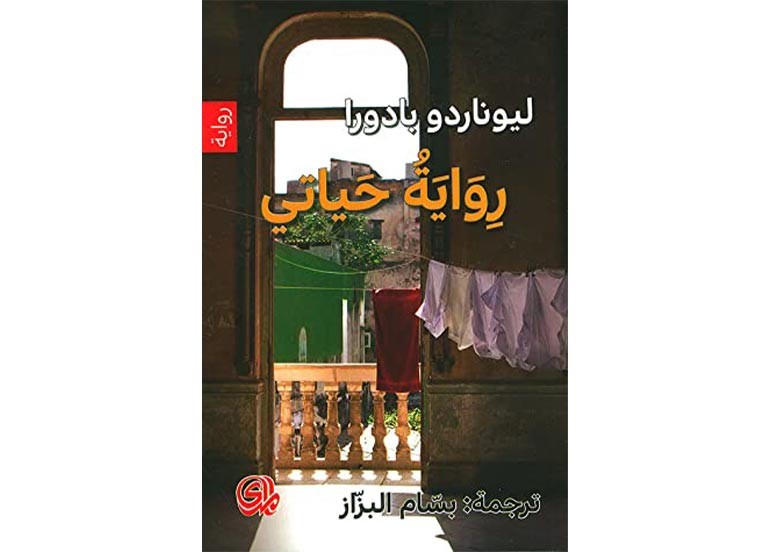ييُسرِفُ بعض الأخيار من ذوي العلم بذمّ الدنيا وكراهتها والقرف مما فيها. وقد تعدّدت أوصاف الكراهات وتعدّدت الأمثلة حتى صارت درساً يُحَبّذُ حفظُه والعمل به. ولسنا ضد ذلك أصلاً، ولكننا نعترض على حَرْف الفَحْوى. فأحد الزهاد يصف الدنيا بأنها "حيوان متعفن
ييُسرِفُ بعض الأخيار من ذوي العلم بذمّ الدنيا وكراهتها والقرف مما فيها. وقد تعدّدت أوصاف الكراهات وتعدّدت الأمثلة حتى صارت درساً يُحَبّذُ حفظُه والعمل به.
ولسنا ضد ذلك أصلاً، ولكننا نعترض على حَرْف الفَحْوى. فأحد الزهاد يصف الدنيا بأنها "حيوان متعفن وأن إبليس جاثم عليها" ويخضعون الحديث الشريف لتفكيرهم: "لو كانت الدنيا تعْدِل جنح بعوضه، ما سقى كافراً منها شربةَ ماء." . وأنا أعلم أن وراء ذلك حسن القصد. وراءه الرغبة بالقرب من الله منزهين عن عيوب العيش. لكن هذا القصد وهذه الرغبة يغطونهما بما يضيع القصد فيوحي بغيره.
يا سادتي، الدنيا ليست شريرة، بل انشغالنا بها رياءً وسرقةً وكذباً وخداعاً..، هو الشر وهو المُدان وهو موضع الشكوى والذم. فلا خلاف ولا ينقص إيماننا إذا قلنا نحب الله ونفضل العيش في الدنيا. هذا القول ليس مغايراً للقول" إعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً".
القول الأخيرهو الكلام المتوازن والطبيعي والذي وراءه "صلاح الحال" بتعبير المتصوفة. وإلا لماذا كلّ هذا العدد الكبير من الوصايا ومن الكتب المقدسة وكلّها توصي بحبّ الإنسان ورعايته وحماية الحيوان والشجر والتعاون على المحن والشدائد؟ أليس كلّ ذلك من أجل أن يعيش الإنسان آمناً كريماً؟ أم لا يقع ذلك ضمن حب الدنيا وناسها وحيوانها والنبات؟ ولعلّ قول "يحيى بن معاذ" "كيف لا أحب دنيا قُدِّر لي فيها قوتٌ أكتسبُ به حياةً وأُدركُ طاعةً أنال بها الآخرة؟" ، قول حصيف وواضح ..
باختصار ، وكما أفهم "دنيوّياً" من هذا القول وسواه في هذا الشأن: أُصلِحُ دنيا الحاضر لأصنَعَ، أو لأكسب، مستقبلاً طيباً. وتلك هي الحسنةُ المُجزية عن الصلاح والإصلاح.
لا أرى صواباً أن يكون فحوى الوصايا، غير ما أُطلقت من أجله العبارة، سواء كانت حديثاً شريفاً أو موعظة، وأن نضع للعبارات مضامين غير التي أريد بها. أيضاً، وهذا ما يكشف الخلل، ألا تكون موجهة حصْراً للآخرين .. فيكون على الناس الزهد بالدنيا ومالها وطيباتها، وهم لهم تجارتهم وأملاكهم وما يردهم، أو ينالونه، من هدايا وعطايا وهبات، بل رواتب ومعاشات، لا يتورّعون عن طلب زيادتها.
هنا، وبمثل هذي الحال، يتحول الواعظ الى داعيةٍ لا يخشى الله بعباده. بينما هو يخاف السلطان و يستثيبه. مقابل ذلك هو يتحدث باسمهِ، أو باسم السلطة، لكي يحبّذ الفقرَ والعِوَز والحاجة، ولكي يصبر الناس على سوء الحال ولا يطمعون بمزيد بوصف ذلك إفراطاً في النعمة! الإسلام لم يقل ذلك، سلوا أبا ذر! الإسلام قال بوضوح: واسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه" و "ليس للإنسان إلاّ ما سعى وان سعيَهُ لسوف يُرى.
إذن السعي في الدنيا له نتائج طيبة ترونها بأعينكم والسعي للآخرة بالسلوك النظيف والالتزام بالفضيلة ومساعدة الناس والتعاون على رفع الضيم...الخ، كلها عبادات. والسعي للآخرة سوف يُرى أيضاً.
نحن نعلم، أن مؤمنين، بعضهم من أئمة المسلمين، كانوا يعملون في التجارة والزرع وما أضر أي من العملين بإيمانهم، بل زادهم إيماناً.
أعتقد بأننا يمكن أن نستفيد من هذا القول:
"إذا وقع المال بأيدي الأمناء
كان سبب شرفهم وإخلاصهم
ولا معنى للمال، إنما كسب لهم الشرفَ عند الله فِعْلُهم بالمال.
لا ذنب للمال، الذنب لك. الذنوب تُكتَسَبُ بالجوارح وليس للضيعة والحانوت جوارح.
وفعلك يوزَنُ يوم القيامة، لا مالُك..".
كما ليس من المستحسن أن يكونوا عالة على غيرهم. "الداراني" المتصوف، ينصح الآخرين بأن لا يكونوا عبئاً على الآخرين: ليست العبادة أن تصفَّ قدميك وغيرك يقوت لك ولكن إحرز رغيفَكَ ثم تَعّبدْ ..
ومن محصلة المواقف الاجتماعية التي أفرزتها ظاهرة الزهد في العصر الأول للإسلام، ثم ظاهرة التصوف التي رسَمتْ أخلاقاً وسلوكاً خاصين بها، يمكن أن نجد:
أولا: رفضاً للسوء والشر وعيوب الحياة الاجتماعية الأخرى.
ثانيا: أنهم وقفوا ضد ذلك بالعزلة عنها، بالخلوة والانصراف الى الله أو المحبوب أو المعشوق أو الجمال، البعيد عنهم، وهو الأزلي الذي لا يفنى ولا يصلون إليه إلاّ بالسعي الشاق أو المجاهدة. معنى هذا أنهم بانتظار رؤية الجمال أو إشراقة "الحق" وهو تعبير إيجابيّ في الجانب الأساس منه لكنه سلبيّ في التخلي والعزلة عن الناس والدنيا. هم يعيشون في مجتمع ويخاطبونه ويفيدون منه ولهم فيه موالون أو مريدون أو اتباع. ونفع هذا المجتمع وإصلاحه بعض من واجباتهم الشرعية والاجتماعية. بتعبير آخر: ان الحضور في النضال والإصلاح سلوك ايجابيّ مُفْتَقد. اليأس ولا جدوى الجهد والمواجهة، ذلك ما أدى بهم الى إيكال المهمة، مهمة إصلاح الخلق، الى الخالق .. ومع أننا حريصون على أن تحتفظ الظاهرة باستقلالها وصفاء رسالتها، لكنها في كلّ حال ظاهرة اجتماعية تعتمد الثقافة وسيلة. أهميتها بالنسبة لنا أنها كارهة للعيوب الاجتماعية والفساد الأخلاقي وأنها "مُجاهَدَة" للوصول الى رؤية الحق"، أو الذات الإلهية أو الجمال الأزلي الذي لا يفنى.
وكأي ظاهرة ذات جذور تمتد الى عصور سالفة، ويعلق بها مما حدث من عدوانات أو مجاعات أو كوارث وأحداث ...، يبقى الخوف من الاقدار بعضاً من مضموناتها وهذا يوجب استعداداً، وطلباً لملاذ أو منقذ وليس للناس في مثل هذا الحال إلاّ الله خالق الكون. لكن الله سبحانه أمر بالإصلاح كما أمر بالابتعاد عن الشرور والآثام وأوجب إصلاح النفس والناس، لا بإرغام الجسد، الإرغام البدني والروحي، على التخلي عن رغباته واحتياجاته، لكن بالعمل والنصيحة أو التبصير. لقد كان التأكيد على كبح مصادر الشر والفساد والشهوات مما يسبب إيذاء للنفس والمجتمع والتسبيب لغضب الله وانتقامه.
بمثل هذا المنطق العقلاني تتأكد إيجابيات الظواهر والروح العظيمة في الأديان والرسل، رسل "مكارم الأخلاق". ومكارم الأخلاق بالتأكيد لا ترضى بالابتزاز والمتاجرة بالمال العام والفسق والإضرار بالآخر مهما كان لونه أو دينه أو لغته...، الإنسانية محترمة كلّها فهي "الأخوَّة في الخَلق" ولعل "تجليات الخالق في الخلق.." تقربنا أكثر الى مبتغانا.
وتواصلاً مع هذا النسق من الإيمان، يكون مفيداً لنا أن نذكر حالاً مجيدة لم تحظ، لسبب أو لآخر، بكبير اهتمام. هي الوجه الغائب للظاهرة. تلك هي الحال الاجتماعية للصوفيين "الذين كانوا حلقة من الإخوان يعيشون لحدّ ما في "تشاركية" المال والثروة فما كان للسالك أن يتحدث عن المال والثروة وأن يرى لنفسه مُلْكاً يختصُّ به ..."
وعن الصوفي إبراهيم بن أدهم: كان يشترط على من يريد صحبتَهُ أن يعمل كلَّ ما يُطلَبُ منه وأن يشارك الآخرين في كلّ ما يملك.." وكان إبراهيم نفسه يعمل ويُنفق ما يحصل عليه من أجر على تلامذته...، وعندما كان الشيخ يعود الى الدار، فإن أول ما كان يقوم به هو إعداد الطعام لهم، من ثم مواصلة أحاديثه الروحية معهم. ومن هنا نستدل على أن الشيخ نفسه كان يخضع لأحكام الحياة "المشاعية" المادية والعبادية. [عن نور اندريه، التصوف الإسلامي، ص146. نقلاً عن عوارف المعارف].
وبهذا الفهم، تكون ظاهرة الزهد – ومنها التصوف- مدرسة تربوية أخلاقية لإقامة مجتمع مختار فاضل يؤمن بالمستقبل الأفضل – أو الآخرة!