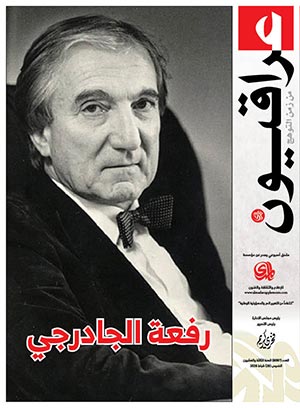وأعني بهم أصحاب الرأي من الكتاب والباحثين والصحفيين والأدباء والفنانين ذوي التوجه العلماني أو الاسلامي المتنور من طائفة الشيعة. هؤلاء، حسب اعتقاد كثيرين بينهم كاتب هذه السطور، مهمون ليوم العراق وغده. وهم في هذه الأيام أكثر أهمية. هذه الأيام التي نوشك فيها على الاقتراب من حرب أهلية، بسبب الاستقطاب الطائفي الذي يزداد حدة مع استمرار تظاهرات المحافظات السنية.
أهميتهم تكمن في أنهم يمكن أن يكونوا عاملا خطيرا من عوامل اشتعال الحرب الأهلية، كما يمكن أن يكونوا، على العكس، عاملا حيويا من عوامل تعزيز التعايش المشترك والسلام الاجتماعي، لأنهم يشكلون أغلبية أصحاب الرأي، وأغلبية المشتغلين في وسائل الاعلام، ولأنهم لذلك يتحملون مسؤولية اعتدال أو تشدد البيئة الفكرية والوجدانية السائدة. والحكومة خصوصا والسياسة عموما لا تستطيعان الذهاب الى هذه الوجهة أو تلك بمعزل عن هذه البيئة.
هل كان لصدام، مثلا، أن يوجد أصلا اذا كانت البيئة السياسية والفكرية المحيطة به معتدلة أو ديمقراطية؟ بالتأكيد لا. كذلك الأمر بالنسبة الى التطرف الطائفي، والى شبح الحرب الأهلية. لا هذا ولا ذاك يمكن لهما الهيمنة على الساحة السياسية اذا أنتج أصحاب الرأي بيئة فكرية ووجدانية معتدلة انسانية نظيفة من التطرف الطائفي. وقد وُضع أصحاب الرأي هؤلاء اليوم أمام تحد فريد من نوعه، بعد اكتساب لهجة الكثير من الخطباء في تظاهرات المحافظات السنية طابعا طائفيا متشددا، ومُستفزا للشيعة الى أبعد الحدود.
بعض هذه الخطب وضع شيعة العراق في موضع عدو "الأمة" و"الاسلام"، وألَّب الكرد والترك والخليجيين عليهم. سمعت وشاهدت هذا الكلام على لسان معمم. وما أبغض رجال الدين عندما يصيرون رجال حرب. انهم يجردون الدين بذلك من سموه ويحطونه الى مستوى ديانة أذى ورعب. وما أسهل أن يبعث هذا الخطاب البشع ضده النوعي المماثل بشاعةً، فتغرق البلاد في الجحيم بين تطرُفَين.
وليس من ثوب المثقف الانجرار الى هذا الموقع الطائفي. دوره وواجبه، على العكس من ذلك، هو أن يكون اطفائية وقت الحرائق، لأن ديانته في كل وقت هي"مجانبة الأذى". إنها ديانة الإيمان "بأن الله يستقبل الذين لم يؤذوا أحدا أكثر من المتعبدين" كما قال ديغول يوما لكاهن.
ان التظاهر حق. و"المظلومية السنية"، الأمنية والقضائية، التي خرج المتظاهرون من أجل رفعها وإنصاف من تعرضوا لها، حقيقة اضطرت الحكومة نفسها الى الاعتراف بها عمليا، بإطلاقها سراح نحو 3200 معتقل "على الشبهة". كما ان التعامل الحكومي مع التظاهرات السنية، بوصفها مسألة تقنية أو فنية، تؤلف "لجنة" لحلها، ليس أكرم ولا أفضل الطرق.
إن حدة الاستقطاب الطائفي لن تتراجع دون النظر الى قضية "المظلومية السنية"، والتعامل معها، بوصفها نتيجة سياسة طائفية، تتطلب تغييرا يؤدي لاستعادة الثقة بين ساسة الطائفتين، وأهل الطائفتين. إن الأمر يتعلق بمصالحة وطنية تأخر تحقيقها، وتوافق لم ينجز على خارطة طريق لمرحلة انتقالية. ولأن ذلك لم يحدث، وجرى النكوص عنه الى نهج تفرد واستئثار بالسلطة، ولأن المحاذير والشكوك والمضايقات الحكومية ظلت تحيط بالتظاهرات، بدل تفهمها واحترامها والاستجابة لمطالبها المشروعة، فقد تراجعت عن التظاهرات لحظة رجل الدين الفاضل عبد الملك السعدي، المعبرة عن الاعتدال، وطفت بدلها على السطح ظاهرة المعممين المتطرفين، دعاة الحرب الأهلية.
وهذه نتيجة لأسباب تتحمل الحكومة في المقام الأول مسؤوليتها. فالحاكم المتطرف يصنع معارضا من نوعه. وواجب المثقفين الشيعة، وبالطبع السنة أيضا، كشف الأسباب والتحذير من نتائجها، لا أن يكونوا جزءا من الأسباب أو النتائج، فيصبون بذلك الزيت على النار. واجبهم العمل والضغط لتكوين بيئة فكرية تسمح بتنظيف الحكومة والسياسة من التطرف، وتوجيههما نحو الاعتدال، تعزيزا للعيش المشترك الذي لا بديل له سوى دمار أُتخمت به البلاد.