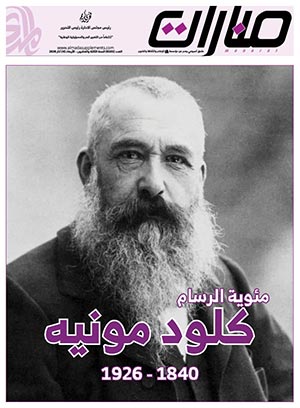نوشك على إكمال الشوط الأول من الفصل الانتخابي الذي بدأ هذا الربيع ولن ينتهي قبل الربيع المقبل في انتخابات برلمان ٢٠١٤. وإذا كان الاقتراعان هما أول تجربة بعد انسحاب أميركا عسكريا وسياسيا إلى حد كبير، فإنهما أيضا أول تجربة انتخابات بعد فصول احتجاج شعبي عارمة تتواصل منذ شباط ٢٠١١.
فهل ستكون هناك آثار في نتائج الاقتراع لكل تلك الثورة والغضب لدى الجمهور، ولدى مراكز القوى السياسية والدينية؟
إن الغضب على السلطة لم يكن يوما بهذا الوضوح والشعبية. المال والدم والسنين وكل شيء، يفترض أنها جعلت مدى الرؤية أبعد.
وماذا عن التيار المدني وسط كل هذا الصخب، هل وجد طريقه أخيرا بعد خيبات لا تنسى؟
إن أول اختبار نعيشه هذه الأيام، هو أن نقيس سلبيتنا. البيانات السابقة كانت تشير إلى أن الطبقات الأكثر تعليما والأقل فقرا، كانت الأقل مشاركة في التصويت. ومراكز المدن دفعت ضريبة كبيرة بسبب هذا، إذ نجح الريف في الدفع بممثليه إلى السلطات تشريعا وتنفيذا، بينما ظل أبناء المدينة يتوجعون ويتألمون لأنهم بلا تمثيل!
كيف سنقيس سلبيتنا بعد ١٠ أعوام من سقوط صدام حسين. وهل سنبقى يائسين ننتظر تغييرا ينزل من السماء؟
أما الاختبار الآخر ريفا ومدينة، فهو أن نختبر خوفنا ومدى تأثيره على اتجاهنا للتصويت لمن فشل، بذريعة أنه فاشل في تحسين حياتنا لكنه "قوي" يحمينا من العدو، وهو عدو جرى تضخيمه بهدف التسيد على طائفة مذعورة. وهذا اختبار لمفهومنا وتعريفنا للقوة. هل ما زلنا نرى أن القوي هو الأسرع صناعة للأعداء والأكثر استخداما لعبارات التهديد وتحريك الهمرات والهليكوبترات؟ أم أن القوي يجب أن يكون القادر على ضمان تفاهمات قوية مع الجميع، والقادر على إقناع الآخرين بأنه قائد موهوب وذو همة ومسؤول، كي يدعموا محاولاته لتحسين حياة الناس؟
سنختبر إذن قدرة الناس على معاقبة الحكومة المحلية الفاشلة. أكثر من مليون ناخب في البصرة مثلا، يشربون الماء المالح، هل سيعيدون انتخاب محافظهم الذي أعاد لخزينة المالكي نحو مليار دولار من أموال البصريين وفشل في تحويلها إلى مشاريع خلال ٢٠١٢؟ هل سينتخبون كتلة المالكي التي عجزت عن تفسير الفشل في إنقاذ البصرة كمدينة كبرى ظلت موصوفة بأنها الميناء النفطي والتجاري الوحيد في العالم الذي لا يمتلك محطة تحلية، رغم أن كل عمالقة البترول السبعة يشربون من حقول ذهبها الأسود؟
وفي الإطار نفسه سيتاح لنا أن نقيس ونختبر الأثر الاحتجاجي الذي يفترض أنه اتسع في قلوب الناس بعد سلسلة تظاهرات شعبية منذ عام ٢٠١٠. هل سنترجم احتجاجنا على شكل رفض داخل صناديق الاقتراع ، أم سننسى أننا شاركنا أو تعاطفنا، مع شباب تظاهروا من البصرة حتى نينوى، وقد سالت دماء بعضهم، وتعرض سواهم إلى كل أشكال الاعتداء والاتهام والاعتقال، لأنهم اعترضوا على رجل تواصل فشله ٧ أعوام في السلطة؟
لكن الجمهور الغاضب، غاضب أيضا على النخبة ويسأل: أين بدائلكم المقنعة، أين أنتم؟
لذلك فإننا سنختبر أيضا قدرة النخب السياسية المحتجة، على تحقيق تواصل أفضل مع الجمهور. ولعل أقسى الاختبارات تتصل بالتيارات المدنية، التي تمتلك جمهورا مؤثرا، لكنها برأي كثيرين لا تحسن التواصل معه، ولا تجرؤ أحيانا على البوح بشكواه.
وهناك من يعتقد أن تياراتنا المدنية لم تقم باستغلال نقاط قوتها بشكل كاف، ولا تزال بعيدة عن جمهورها. وعلى سبيل المثال فإنني لم ألمح مرشحا مدنيا (أو مرشحة) حاول أن يطرح بشكل واضح ملف الحريات المثير للجدل، خلال دعايته الانتخابية. وهذا ملف مؤثر جدا على شريحة الشباب بالخصوص، التي ظلت غائبة محدودة التأثير في الانتخابات العراقية، بينما لاحظنا كيف أمكن لإصلاحيي تركيا وإيران أن يستعرضوا شبابهم بكل الأناقة والحيوية، خلال أكثر من حملة شهدتها السنوات الماضية (ومثلا فإن أنصار خاتمي وموسوي خلال حملتهم الدعائية، نظموا سلسلة بشرية من الشباب والشابات بطول ٥ كيلومترات وسط طهران في انتخابات ٢٠٠٩، وأثاروا إعجاب الجميع).
وأخيرا فإن تأجيل انتخابات نينوى والأنبار، بإرادة رأس السلطة التنفيذية بمفرده، دون قناعة برلمانية أو فنية لدى هيئة الانتخابات، يقدم لنا اختبارا آخر لأنصار التعدد السياسي. لقد فعل السيد المالكي صاحب نظرية الحاكم الفرد، ما أراد، ولم يمكن لمعارضيه تغيير إرادته إلا بقدر يسير (أراد تأجيلها ٦ أشهر ، ويفترض أنهم أجبروه على شهرين فقط). أما احمد الجلبي فقد حذر من حصول ممارسة مشابهة في الاقتراع البرلماني تحت قاعدة أن في وسع المالكي تأجيل أية انتخابات يشعر بأن حلفاءه سيخسرونها.
وعلى أي حال فإن الاقتراع المحلي بروفا جيدة وتمرين إضافي للانتخابات البرلمانية التي ستتضمن تحدياً أكبر وجائزة أوفر، للجميع، ناخبين ومرشحين.