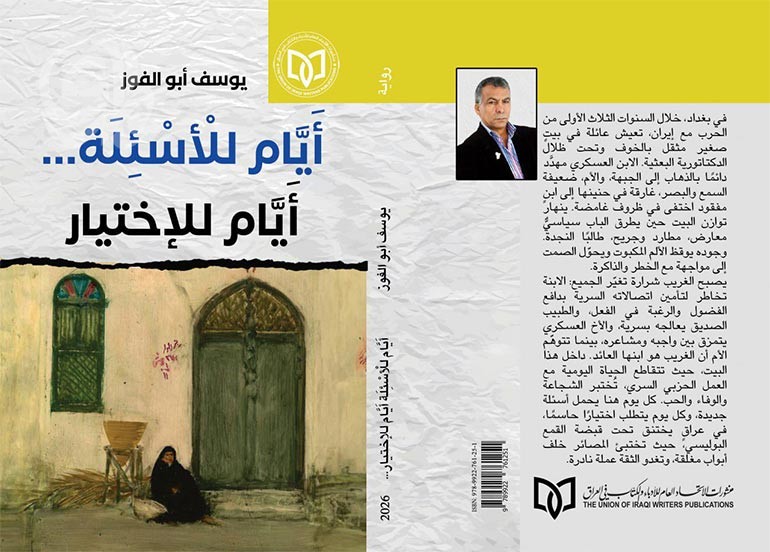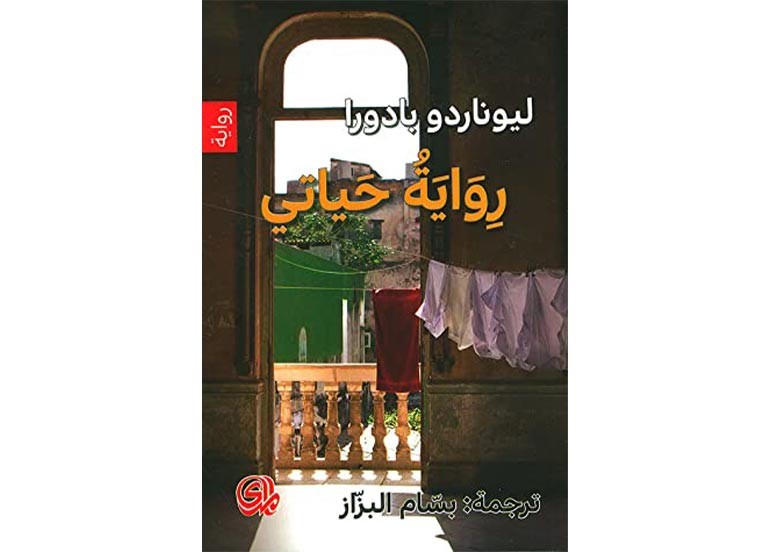(1) في لقاءٍ مع أستاذي المشرف على أطروحتي للدكتوراه، في جامعة إكستر ببريطانيا، جي آر سمارت بدايةَ الثمانينات من القرن الماضي، وضمن حديث عن بعض علاقات الرواية العراقية بالرواية الأمريكية، أشرت له إلى ترجمة جبرا إبراهيم جبرا لرواية وليم فوكنر "الصخب و
(1)
في لقاءٍ مع أستاذي المشرف على أطروحتي للدكتوراه، في جامعة إكستر ببريطانيا، جي آر سمارت بدايةَ الثمانينات من القرن الماضي، وضمن حديث عن بعض علاقات الرواية العراقية بالرواية الأمريكية، أشرت له إلى ترجمة جبرا إبراهيم جبرا لرواية وليم فوكنر "الصخب والعنف"، فأبدى أستاذي استغرابه، وضمناً إعجابه مما وجدها جرأة غير عادية من جبرا لفعل ذلك. ولم يكن ذلك بالأمر المفاجئ لي إذ من الصعوبة غير العادية ترجمة تلك الرواية غير التقليدية، في لغتها وبنائها وبهيمنة تيار الوعي بتداعياته وتقنياته عليها، خصوصاً في تداخلها مع السرد والأحداث والحوارات، وما قادت إليه من تداخلات زمانية ومكانية وحدثيه. ولهذا طلب أستاذي مني النسخة العربية ليرى كيف كانت نتيجة جرأة المترجم الكبير في ترجمة الرواية. وبعد حين ازداد إعجاب الأستاذ بعمل جبرا لما وجده في عمله من ذكاء ودقةِ إيصال لما تشتمل عليه الرواية ولما توحي به. وزاد من ذلك الإعجاب حين عرف موسوعية جبرا وتعدد اهتماماته الإبداعية، التي نستذكرها هنا فنقول أنه كان باحثاً وأكاديمياً، وناقداً أدبياً، وفناناً وناقداً تشكيليا، وقاصاً وروائياً، وشاعراً، وكاتبَ سيرة، ومترجماً.
(2)
تذكرت هذا وأنا أقرأ سوناتات شكسبير وبعض مسرحياته التي ترجمها الكاتب الكبير جبرا إبراهيم جبرا، وأظنها ستّاً، فأجد نفسي وكأني أغور في أعمق أعماق النص الشكسبيري وشخصياته بعد أن نجح المترجم في تذليل كل ما يمكن أن يبرز من حواجز ما بين القارئ وأسرار العمل المترجم وخفاياه، أو ما بينه وبين مؤلف العمل. تساءلت: لماذا يتحقق هذا مع جبرا أكثر مما يتحقق مع مترجمين متميزين عديدين آخرين؟ فقد قرأنا من قبل لسامي الدروبي ترجماته الخالدة لأعمال تولستوي ودستويفسكي، فوجدنا، مع كل ما يُحسب للمترجم، كيف أنه لم يكن يبالِ بما يكفي أحياناً بأن تكون الجملة التي يصوغها صحيحة تماماً أو دقيقة تعبيرياً، ما دامت توصل المطلوب وتؤثر في القارئ بعد أن يجدها، على ما يبدو، مطابقة لما يقابلها في النص الأصلي. ولم نستطيع، ونحن نقرأ ترجمات عبد الواحد لؤلؤة ونتلمس تمكّنه ومهاراته الواضحة التي لا شكل فيها أبداً، لاسيما في ترجماته لسلسلة (موسوعة المصطلح النقدي)، أن نتجاوز تصخّر جملِه العربية وأسلوبه عموماً- إن صح التعبير- وهو يبالغ في أن يصوغ النص العربي بما يجعله مطابقاً تماماً للنص بلغته الأصلية، والأمر يمتد إلى كمال أبو ديب، وما أدراك مَن كمال أبو ديب!، الذي يتخطى تصخّر ترجمات لؤلؤة بكثير، فتكون النتيجة لا الإبقاء على الصعب صعباً فحسب، بل تحويل السهل والاعتيادي إلى صعب. ولكي يعرف القارئ ما نعنيه بهذا نقول وبدون مبالغة إن كمال أبو ديب كاد أن يجعل من كتاب إدوارد سعيد الشهير (الاستشراق)، مثلاً، كتاباً مقيتاً، بل هو كان كذلك فعلاً لطلبتي ونحن ندرسه في مرحلة الدكتوراه الأمر الذي جعلني استبدل ترجمة أبو ديب للكتاب بترجمة الدكتور محمد عناني. وقرأنا لكاظم سعد الدين فتلمسنا شيئاً من التجاوز لبعض طبيعة المتكلم بالإنكليزية والأسرار الكامنة خلف كلامه أحيانا، حتى وهو يقترب منا قرّاءً وبالرغم من تمكنه الواضح من هذه اللغة مفرداتٍ وعبارات. ورأينا كيف يبدو محمد درويش، في ترجمته، أقرب إلى اللغة الإنكليزية التي ينقل عنها منه إلى اللغة العربية التي ينقل إليها ومع كل مهاراته الواضحة، وذلك تحديداً في بعض ترجماته الأولى وقبل أن يبدأ بالاقتراب من خانة جبرا ليكون عندنا فيما بعد المثال الذي نتمنى أن نقترب منه للمترجم الأدبي والثقافي. فماذا يتحقق في نص جبرا المترجم؟ ولماذا وكيف يتحقق ليكون تفرد ترجماته؟
(3)
الذي يتحقق، بكل بساطة، هو أن النص يبدو وكأنه كُتب أصلاً كما نقرأه بكلماته وعباراته وموحياته، بحيث نحس وكأن المترجم هو صاحب النص. وربما من هنا تحديداً يتحقق التواصل الذي كثيراً ما تفقده النصوص المترجمة بينها وبين قارئها، وبدرجة قد لا تقل عن التواصل الذي يكون قد حققه النص الأصلي مع قارئه. أما لماذا وكيف استطاع جبرا تحقيق ذلك؟ فأقول انطلاقاً من تأمل الأمر جيداً، مع أن تجربتي في مجال الترجمة التطبيقية، وهي تجربة متواضعة بالتأكيد لكنها تجعلني قريباً إلى حد ما من أهل الصنعة، يبدو أن الجواب على ذلك يكمن في ما يأتي:
أولا: تمكّن جبرا غير العادي من اللغة الأصلية للنص، نعني الإنكليزية، بما في ذلك معرفة أسرارها وما يكمن خلف ظاهر مفرداتها وعباراتها، مع تمكن من اللغة العربية بل عشق واضح لها حد الإبداع فيها وتطويعها لنقل كل أسرار النص الأصلي.
ثانيا: ونتيجة لذلك يتمكن جبرا مما يمكن أن نسميه إعادة خلق للعمل الذي يترجمه، وبما يجعل منه جزءاً من شخصيته، مع حرص مخلص الى حد كبير على عدم الإخلال بالأمانة للنص الأصلي ولمؤلفه عبر الجهد الذي يبذله للمحافظة على روحيته.
ثالثا: استيعاب المترجم، وهو يمتلك حسّا لكل ما يشتمل عليه النص، للعمل الذي يترجمه بكل دقائقه وكلماته وما وراءها- نعني ظواهرها وخفاياها- وبمستوياته المختلفة، الأمر الذي يقوده في النتيجة إلى تضمين ذلك كله في النص العربي. ولأنه يعرف بحس وذكاء غير عاديين طبيعة القارئ الذي يقدم له النص فإنه يتمكن من صياغة هذا النص بما يتوافق وهذا القارئ ودون التضحية بأي من تلك المستويات.
بقي أننا حين نقارن جبرا بآخرين ممن ذكرنا أسماء بعضهم، فإننا لا نريد التقليل من شأنهم بدليل استشهادنا بهم وبما معروف عنهم حنكتهم وتمكنهم وغنى تجاربهم الترجمية التي لا شك فيها. ولكننا أردنا أن نقول إنه مع كل ما يمتلكه المترجمون الآخرون يبقى لجبرا بعض مما لا يمتلكونه مما يجعل من ترجماته تنفرد بين الترجمات ويجعل منه مترجما متفرداً. ولهذا نأمل أن تكون وقفة قادمة عند المترجم الفذ محمد درويش.
(4)
بقي أن نقول إن جبرا كان بحق مدرسة في الحياة، كما هو كذلك في الأدب والثقافة للعرب جميعا، وبشكل خاص للعراقيين الذين يبدو واضحاً أنه قد وجد نفسه بينهم ومنهم، ولهذا لا نجد غريباً أن يقول بثقة وتأكيد إنه لم ولن يفكر بترك العراق أبداً، وتحت أي ضغط أو ظرف. وهكذا عاش في هذا البلد ابناً باراًّ، وترك بصماته العميقة على الثقافة العراقية من خلال الكثير من وقته وجهده وفكره وإبداعه. وكانت بغداد بالذات زقاقاً من أزقة قلمه التي يجول فيها هو "وصيادون في شارع ضيق"، وحتى خطواته الأخيرة، قبل رحيله، "في شارع الأميرات"، الأمر الذي يدفعنا إلى أن نفعل، لهذا الرجل الذي ترك بصماته علينا وعلى حياتنا الثقافية، ما يخلده، لا من خلال ترجماته التي كانت موضوع مقالنا هذا وتراثه الثقافي والإبداعي فحسب، بل من خلال ما يعبر عن حبنا له وهو الذي أحبنا وبلدنا وبغدادنا، وكتب في ذلك أروع أعماله، وخط أجمل ذكرياته.