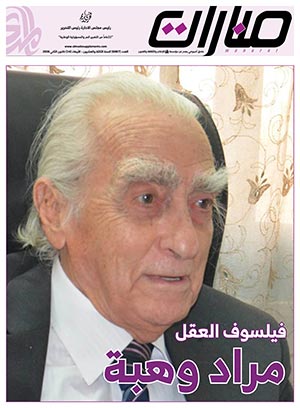لا تقرأني كثيراً لأنك تُصاب بالعمى من كثرة الدُخانفي تاريخي أنا (الأسد) في عش اسميلكنني لا أرغب بجهرة الأسدلأنه شرس وعدوانيكنت أود أن يكون في اسمي الغزال أو الجديأو المهرة أنا لقبي أيضا بلا أحدوهذا أيضا لا يعجبني بعد ثلاثة وسبعين عاماً من الش
لا تقرأني كثيراً
لأنك تُصاب بالعمى من كثرة الدُخان
في تاريخي
أنا (الأسد) في عش اسمي
لكنني لا أرغب بجهرة الأسد
لأنه شرس وعدواني
كنت أود أن يكون في اسمي
الغزال أو الجدي
أو المهرة أنا لقبي أيضا بلا أحد
وهذا أيضا لا يعجبني
بعد ثلاثة وسبعين عاماً من الشعر والنضال الوطني، وهو في قمة انتصاراته، خسر شيركو بيكه س معركته مع السرطان، بعد أن كان تنّبأ بدنو أجله، فأصدر ديوانه الأخير «استعجلْ .. ها قد وصل الموت»، رحل بعيداً عن جبال كُردستانه، جاء نعيه من السويد، التي كانت منفاه في ثمانينات القرن الماضي، ومنحته جائزة توخولسكي، قبل أن يعود إلى العراق نائبا في برلمان الإقليم، ثم وزيراً للثقافة فيه.
كانت حياته الصاخبة مزيجاً بين الشعر والنضال السياسي، عرف مرارة النفي في وطنه وخارجه، فكان لزاماً عليه كتابة عذابات هذه الأرض، دون مساومة على الخطاب الفني، وهو اختط لشعره طريقا خاصاً، ابتعد فيه عن الشعر الكلاسيكي الكردي، بأوزانه وقوافيه، ولغته المختلطة مع اللغتين العربية والفارسية. فابتدع لغته القادرة على استيعاب التجريب والقضايا الوطنية في آن معاً، تحرّر من قيود الشعر القديم وتقاليده، دون أن يفقد ارتباطه بمأساة أمته وهويته الكردية، وظل هاجسه أن يكون ناطقاً باسم شعبه، جزءاً من حضوره الشعري والثقافي، الذي لاقى احتفاءً تمثل بترجمة أعماله إلى لغة الضاد.
يصح تماماً مقارنته بالشعراء العظام، الذين ارتبطت سيرتهم وإنجازاتهم مع قضايا بلادهم، لوركا الإسباني، ونيرودا التشيلي، وناظم حكمت اللتركا، والداغستاني رسول حمزاتوف، وهو الذي كان يرى أن :
الشاعر يشبه حصاناً أسود وحيداً
عُرفه خصلة نار
وصهيل مبلل بالانكسار
يجري في دوران دائم
كتب قائلاً:
جربتُ الرؤيةَ فكانت سرابَ زَيْغٍ
جربت السماع، كان تيه الأصوات والصخب
جربت اللمس، كان خدراً دائماً في يدي
وجربت الذوق، كان جفافاً لا يترك فاهي
بقي لي قلم الرائحة وحده
كي أكتب به هذه المرة قصيدةً جديدة
وهو رغم اعتزازه بقوميته الكردية، ظل وفيا لوطنه العراق، رغم ما لقيه هو وقومه على يد حكامه القومجيين.
ستذهب حلبجة إلى بغداد قريبا
عن طريق غزلان سهول شيروانه
حاملة معها سلة من الغيوم البيضاء
وخمسة آلاف فراشة
تنهض دجلة بوجل
تنهض بكامل هيبتها وتحتضنها
ثم تضع طاقية الجواهري على رأسها
بعدها
تقترب يمامتان من النجف
يغمر حنجرتيهما الهديل
ليحطا على كتفيها
رحل الشاعر الذي آمن أن " الشعر هو الماء الذي لا نرتوي منه أبداً وهو الحلم الذي يسألْ، ولا نهاية لأسئلته وأن اللغة هي الأنثى التي نتزوجها عن حب ومن ثم يأتي الإنجاب والحياة والحركة"، وتيقن أن "وظيفة الشعر هو أن يحافظ على إشراقة وجه الحقيقة ويمسك بالنور الذي يخرج من الكلمات الطبيعة والجميلة لكي يكتب به، وأن القصيدة هي المرأة التي تبهرنا بجمالها وحقيقة إنسانيتها ووثبات أملها ويأسها"، رحل المنفي الذي كان " يرى في المنفى في العالم امتداداً لمنفى الوطن حيث افتقد في كليهما ذلك الوهج الذي يشع منه الأمل والمستقبل واللقاءْ، فالغربة هي نوع من الضياع حيث عالمها بلا عنوان وطرق تسلكها لأول مرة وإنك لا تعلم الى اين تمتد.. غريب المكان وغريب الزمان هكذا وكأنك في الحلم تمشي ولكن على حافات ضيقة وخطرة ودون أن تسقط في هاوية الموت".
رحل الشاعر الذي "حفرت قصائده في أرض الذاكرة لاستعادة ما نسيناه من الينابيع ولاستعادة مياهها الجوفية لكي تتدفق مرة أخرى"، وهو يرى أن " الشاعر الحقيقي كالعاشق تماماً، لا يلتفتُ الى الخسارة والربح أبداً وإنما الى احتراقه المتواصل دون أن ينتظر شيئاً ما، أنه الجدول الذي يجري في العتمة وتحت الشمس والمهم ان لا يتوقف ولا يصمت، ليقل كلمته ويرحل، وفي النهاية حين يجئ الموت لا يأتي إلا كحقيقة مطلقة، فالذي يبقى بعد الشاعر هو فقط قصائد قليلة تصمد أمام الزمن وبإصبعها تؤشر الى الحقيقة والجمال".
رحل الشاعر الواثق أن الموت هو الحقيقة الوحيدة التي باستطاعتها أن تجبره على الصمت وها قد صمت لكن ما تركه من إرث سيظل حياً، وهو الذي خلد أمه بقصيدته
حين كبرتُ
رأى معصم يدي اليسرى الكثير من الساعات
لكنّ قلبي لم يفرح مثلما كان يفرح
حين كانت أمي تعضّ معصمي الأيسر وأنا طفل
وتصنع بأسنانها ساعتها على يدي.