في ذلك الصيف البعيد من عشرينات وثلاثينات القرن الماضي وما بعدها قدم المهاجرون الأوائل، من أرياف جَنوب العراق وأهوارِه، إلى بغداد حالمين بحياة جديدة. كانوا قد قطعوا مسافات طويلة في عربات خشبية لها سقوف من شعر الماعز، تجرها خيول أرهقتها الدروب ال
في ذلك الصيف البعيد من عشرينات وثلاثينات القرن الماضي وما بعدها قدم المهاجرون الأوائل، من أرياف جَنوب العراق وأهوارِه، إلى بغداد حالمين بحياة جديدة. كانوا قد قطعوا مسافات طويلة في عربات خشبية لها سقوف من شعر الماعز، تجرها خيول أرهقتها الدروب الوعرة والمستنقعات الجافة المتشققة، أو في قوافل من سيارات حِمْلٍ مستهلكة. كانت وجوه الرجال مغبّرةً، ورُؤوسُهم ملفعةً بيشاميغ تنحدر منها جدائلُ مرصعة بالعفص والخضرم والودع، ولها نهايات تيبست من العرق والغبار، وعلى ذقونهم نمت لِحى كثة عَلِقت فيها أنصالُ التبن وأعوادُ القَش. كانت أجسادُهم نحيلة وملابسُهم ملوثة بالتراب. جاءوا هاربين، مع أبقارهم وحميرهم وجواميسهم، من الاضطهاد والملاحقة بعد ثورة العشرين. جاءوا هاربين من الإقطاع وعبودية الأرض ومواسم الزراعة التي تضاعف الخسائر والذل والديون. جاءوا إلى الآمال البراقة الوارفة في بغداد فسكنوا عند خاصرتها قرب ساحة الطيران، خلف السدة التي بناها الوالي العثماني ناظم باشا عام 1910 لحماية المدينة من فيضانات النهر السنوية الجارفة. وفي ذلك الشريط البري المفتوح المتصل بالأفق شيدوا صرائفهم وأكواخهم من القصب والبواري والطين وسعف النخيل فنشأت بلدة تكونت من قسمين "العاصمة" و"الميزرة" تفصل بينهما المستنقعات وخط سكك حديد بغداد -كركوك الذي ألغي لاحقا. وبعد سنوات قليلة استقرت ونمت وازدحمت، ثم اشتهرت بالمعتقل الذي بنته السلطات في أطرافها الشرقية والذي اتخذ اسمَه منها: معتقل خلف السدة. هناك في أحد أكواخ ذلك الحشد المأساوي، وسط الظلام والسرجين والمزابل والقمل والبرغوث والصئبان وُلدتُ في العام 1951.
في أواخر ذلك العقد كان علي أن أشق طريقي كل يوم إلى المدرسة الابتدائية النائية بين قطعان الكلاب الضارية المتوحشة والجواميس المتجهمة الغاضبة. وجاء يوم سألنا فيه المعلم: من يرغب بقراءة قصة فليرفعْ يدَه. رفعت يدي مع خمسة آخرين بينهم بنتان. كانت المدرسة مختلطة. سجل أسماءنا ،وبعد انتهاء الدرس قادنا إلى غرفة المعلمين. لم تكن هناك مكتبة بل خزانة صغيرة مزججة تقفل بمسمار. أخرج منها مجموعة كتب ملونة ووزعها علينا. كان من نصيبي قصة "الأميرة والثعبان". في الليل قرأتها خلسة متعجلا على ضوء خافتٍ رجراجْ ينبعث من فانوس قديم قبل أن تُطفِئَه أمي وتمتلئ الغرفةُ الطينية برائحة احتراق فتيلته المتآكلة. "الأميرة والثعبان" هي قصة الأطفال الوحيدة التي قرأتها آنذاك، فالاهتمام بالكتب والمجلات والأقلام يعد ترفا في أوساط تلك الأسر المعدمة. كانت أيُ هواية تتجاوز المنهاجَ المدرسي تثير غضبَ الآباء وقسوَتَهم، فهم يعتبرون ذلك لهوا ينسينا أداء واجباتنا الأساسية. ما كان يشغلهم هو أن ننجحَ ونكبرَ بسرعة لندخل سوق العمل كي نساعدهم على تحمل أعباء الحياة القاسية. باختصار وباستعارة تعبير أنطوان تشيخوف: لم تكن هناك طفولةٌ في طفولتي. انقطعت عن قراءة القصص لكني لم أنقطع عن الاستماع إلى حكايات النسوة المسنات في الجوار اللائي كن يزرن والدتي كل ليلة بعد العشاء. كانت وجوههن مزينة بالوشم، وفي أيديهن المعروقةِ المتيبسة تلتمع فصوصُ الخواتم.
عدت إلى القراءة بعد انتقالنا إلى مدينة الثورة أوائل الستينات. ففي محاولة مخلصة لتحسين ظروف حياتنا، عبْرَ سكن تتوفر فيه الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والطرق المعبدة، نفّذَ رئيسُ الوزراء يومذاك الزعيم عبد الكريم قاسم مشروعا كان قد خطط له مجلسُ إعمار العراق في العهد الملكي وذلك بنقلنا إلى مدينة سميت مدينة الثورة. لكن الصراعات السياسية الدموية لم تمهلْه لإكمال مشروعِه الذي تبناهُ بحب فأتمَه غيرُه على مضض. ومع اختلاف العهود السياسية تغير اسمُ المدينة ثلاث مرات فكان "حي الرافدين" زمن عبد السلام عارف، ثم مدينة صدام، واليوم مدينة الصدر.
في المدينة الجديدة كان لي صديق يخدم شقيقُه نائبُ العريف في وحدة خارج بغداد، تعرفت إليه في إحدى إجازاته. كان يتكلم كحكيم وكانت عيناه تتوقدان ذكاء. حدثنا بطلاقة العارف عن العقاد وطه حسين وإحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ والجواهري والزهاوي. يومها أعارني رواية اسمها "لقيطة" لمحمد عبد الحليم عبد الله. وحين أعدتها إليه أعطاني مجموعة من الكتب أذكر منها شجرة اللبلاب، ماجدولين، تحت ظلال الزيزفون، دعاء الكروان. استعذبت ذلك العالم فأخذت تشغلني الحكايات الجديدة التي لم تكن تشبه حكايات النسوة المسنات، بل حكايات واقعية تحدث في الشارع والمقهى وفي الطريق إلى المدرسة المتوسطة.
عصر يوم جمعة عثرت على فتى يبيع الكتب المستعملة قرب محل جقماقجي لتسجيل الأسطوانات في شارع الرشيد (الآن لم يعد ذلك المحل الزاهي سوى أطلال تثير الفزع والحنين). لم أنتبه للفتى، كنت منصرفا إلى تصفح الكتب الكثيرة المفروشة على الرصيف والمعلقة على جدار الشارع حائرا في الاختيار. تقدم مني، سلّم علي وحيّاني باسمي وقال إننا التقينا في (الميزرة) فهو يسكن قريبا من بيت خالتي. ألقى نظرات سريعة على الرصيف والتقط رواية اسمها "بائعة الخبز" قال وهو يعرضها علي: "لا تشتريها، اقراها ورجّعها وانطيك غيرها". رحت أمر عليه أيام الجمع والعطلات فقرأت روايات مثل عمال البحر، أحدب نوتردام، الزنبقة السوداء، كوخ العم توم، والآمال الكبيرة. لن أنسى تلك الخدمة الجليلة التي وفرها لي ذلك الكتبي الصغير الذي تضوع منه رائحة الورق.
في تلك الأيام وكنت أحبو في طريق التأليف كتبت محاولة قصصية، حكاية عن جندي، وأعطيتها، كعادة الطلبة، إلى مدرس اللغة العربية في ثانوية قتيبة الأستاذ خليل بنيان كي يفحصَها لي. وإذ أثنى على ما كتبت أوصاني بالقراءة الجادة، القراءة بلا انقطاع. وبعد أيام قال لي وهو يضع كتابا على الرحلة: اقرأ هذا قبل أن تكتب. كان ذلك الكتاب مجموعةَ قصصية ليوسف إدريس عنوانها "النداهة". انبهرت بها، بأدائها وبعمقها، يومها لم أكن مطلعا على النتاج القصصي العراقي. واستجابة لنصيحة أستاذي قررت ألا أكتب حتى تنضج أدواتي الفنية.
مرة ذهبت إلى المكتبة المركزية في باب المعظم بقصد استعارة بعض الكتب فرفضوا إعارتي. بين جدران الكتب والمخطوطات، لمحت شخصا أعرفه منذ أيام الدراسة الابتدائية. كان يعمل هناك. أكد أنه لا يحق لي سوى المطالعة داخل المكتبة المركزية لأني من طلاب الجامعة المستنصرية وليس من طلاب جامعة بغداد. لكنه وجد حلا مذهلا هو أن يستعير الكتب التي أريدها باسمه. وبدأ يعطيني كل خمسة كتب دفعة واحدة مع التوصية بالحفاظ عليها من التلف أو الضياع لأنه سيدفع غرامة على ذلك. إني أتذكر، بكل الحب والاحترام، جميعَ أولئك الذين ساعدوني على الطيران بأجنحة غضة.
في تلك الأثناء كانت الحكاية تنمو من حولي فتأخذ ثيمات مختلفة: مجيء طالب جديد منقول، حريق في بيت مجاور، شجار في مقهى، معركة بين قبيلتين، أمنية اقتناء دراجة هوائية. كنت أُعيد تشكيلَ تلك الحكاية المثيرة للدهشة ثم استمع إليها بكل حواسي فتهزُني رجفةُ الخائف.
هكذا ظلت الحكاية بالنسبة لي كالأم الجأ إليها في لحظات الشوق والسأم والخوف حتى جاء يوم انفض فيه منتدى الحكاية وتفرق الفتية، رواد الكلام، وعاد الجنود من ثكناتهم بإجازات ليعقدوا مجالسَهم الليلية ويرووا لنا حكاياتٍ جديدةً في الظلام قرب سُرادق المآتم أو تحت الضوء الشحيح لأعمدة الكهرباء. تلك الحكايات ستجد صداها في عدد من القصص التي نشرتها في الصحف العراقية أواسط السبعينات ثم ضمتها مجموعتي الأولى وعنوانها "حقول دائمة الخضرة".
ذلك أنني، وفي إطار بحثي عن الحكاية التي أتطلعُ إليها، عثرت على نماذِجِها الحديثة، النموذج الموباساني ثم التشيخوفي، بعدها سحرني ذلك النموذج في صيغته العراقية من خلال عبد الملك نوري (العاملة والجرذي والربيع)، غائب طعمة فرمان (عمي عبّرني)، فؤاد التكرلي (العيون الخضر)، محمد خضير (حكاية الموقد)، فهد الأسدي (الجدار وألسنة يأجوج)، جليل القيسي (أنا لمن وضد من) فاضل العزاوي (كانت الطائرات تحلق عاليا). هذه النماذج نأت عن السرد التقليدي التأسيسي في الثلاثينات والأربعينات الذي اتسم بالشعارات والخطاب الوعظي الإرشادي كما هو لدى محمود أحمد السيد، جعفر الخليلي، ذو النون أيوب، أنور شاؤول إدمون صبري. لقد شَيدَتْ القصةُ الخمسينية والستينية معمارا فنيا مبتكرا دفعني إلى الاهتداء بأضوائه المشعة الملهمة فكانت لحظة التحول، التي قادتني إليها فنارات أولئك المعلمين الكبار، لحظة القصة القصيرة الحديثة التي يعتبرها ميشال بوتور أحد المقومات الأساسية لإدراك الحقيقة، ثم الرواية التي يراها جان بول سارتر تصفية حساب مع الماضي.
في مقال له بعنوان "أوطان خيالية" يكتب الروائي الهندي الأصل، البريطاني الجنسية، سلمان رشدي قائلا: إن مصدر كلمة ترجمة يعود اشتقاقيا إلى الكلمة اللاتينية "ترادوسيره" والتي تعني النقل إلى حيّز أبعد، وقد نُقلنا إلى مكان أبعد من مكان ولادتنا، إذاً نحن كائنات مُترجَمةْ. ويضيف رشدي قائلا إن "هناك اتفاقا على أننا نخسر في الترجمة شيئا ما، ولكني أتمسك بفكرة أننا سنربح شيئا أيضا". وبالنسبة لي كنت أحلم دائما بأن أربح شيئا من عملية الترجمة تلك المعادلة للمنفى القسري الذي تعرضنا له. كنت أُدرك أن المنفى سوف يَسلُبني بعضا من حياتي وربما إنسانيتي لذا علي أن أقاومه، لا أريده أن يقوضني. ورحت أمضي الساعات وحيدا في منزل صغير في أقصى غرب العاصمة البريطانية أبني وطناً خياليا، وطناً لي وحدي بحجم الكف، أي بحجم القلب، أرسم منازلَه وأشجاره وأنهاره وأكواخه ومواطنيه حتى نهض أمامي عالم واقعي أعاد الخيالُ بناءَ تواريخه وشخوصه ومصائرها فكانت روايتي الأولى "خلف السدة" الصادرة عام 2008. حدث ذلك بعد أكثر من ثلاثين عاما على زوال منطقة خلف السدة من الوجود تماما للحد الذي لم يبق أيُ شاهد عليها سوى ضريح السيد حمد الله القائم حتى اليوم. استعدت في هذه الرواية وقائعَ الهجراتِ الأولى فبنيت ذلك العالم الزائل وأعدتُه إلى الحياة بحزنِه وشقائه وكفاحه وطقوسه وبالنتائج الكارثية التي نتجت عن أبرز حدثين في تلك الفترة ثورة 14 تموز 1958 وانقلاب 8 شباط عام 1963.
في المدينة الجديدة أصبح أولئكَ الفتية، أبناءُ المهاجرين الطالعين من الغَضار والأحراش والرماد، أحفادُ الرجال الذين تحدروا من أزمنةِ القصب والأسماك والمياه والقمح والنخيل، أصبحوا
متجهمين نزقين عندما اكتشفوا أن حياتهم لم تتغير، وليس ثمة في الأفق ما ينبئ بتغييرها، بل استمر الفَقر ينهش قلوبَهم الصغيرةَ العامرةَ بالآمال. كانوا يتطلعون إلى اليوم الذي يحصلون فيه على عمل لكنهم وجدوا أنفسَهم في الطرقات بلا ظل أو مورد. كانوا مستلبين مقموعين في البيت والمدرسة والشارع والمقهى والسوق ما خلق لديهم شعورا بالتمرد والعصيان فانهمكوا في مواجهة السلطة، أيةِ سلطة مهما كان نوعها. إنهم نبلاء ومتسولون، أوفياء وغدارون، صالحون وطالحون، يدافعون عن الشرف وينتهكونه، يمارسون قيم الفضيلة وينتصرون لغيرها، يأملون بالفرح وحين يأتي يحولونه إلى مأتم، يستجيبون لنداءات بعضهم في لحظات صفاء نادرة، وفي لحظات أخرى يمزقون أجسادَ أصدقائهم ومعارفهم بالسكاكين أو يشلون أعضاءهم بالخناجر. في المدينة الجديدة، مدينة الثورة التي اتسمت بالدفء والشراسة وجد الناس أنفسهم بين حصارين، حصار السلطة التي سعت بكل قوتها إلى ترويضهم وإخضاعهم، وحصار القلق والخوف من ترحيل جديد بعد الإعلان الرسمي عن أن المدينة تعوم فوق بحيرة من النفط. في هذه الأجواء، التي اخترقتها موجة اغتيالات سياسية بعد العام 68 ثم التحالف السياسي الكئيب بين الحزب الشيوعي العراقي وحزب البعث الحاكم آنذاك في إطار ما أطلق عليه (الجبهة الوطنية) واصلتُ متابعةَ حياة عائلة مكية الحسن وابنِها علي سلمان بطلي رواية "خلف السدة" في رواية جديدة صدرت مؤخرا باسم "دروب الفقدان". إني هنا أقتفي آثار تلك الرحلة المضنية التي بدأها المهاجرون الأوائل إلى بغداد ومعاناتِهم من أجل بقاء أحلامهم على قيد الحياة بعد أن أخذت تتكسر وتتهاوى. إنها سيرة جيل، تعرض في فترة السبعينات إلى الاضطهاد والتعسف يقابله سعي علي سلمان الدؤوب من أجل إنهاء دراسته الأكاديمية وتعلم الموسيقى. لقد حاولت أن أرصد التغيرات التي طرأت ليس فقط على مدينة الثورة، التي اتخذْتُها ذريعة، بل على المجتمع العراقي كله، ونتائج الخلافات السياسية والنزعات الدكتاتورية عليه. أردت أن أكشف قدرة الإنسان على تحدي القهر والعبودية والبؤس، أن أكشف عبقريةَ الإنسان في مواجهة الألم.
*شهادة ألقيت في "الملتقى الأول للرواية العراقية في المنفى" الذي عقد في لندن .






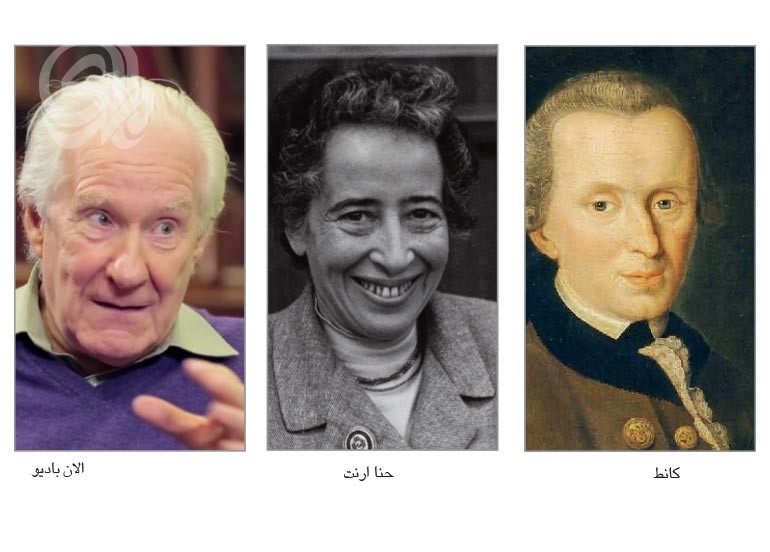
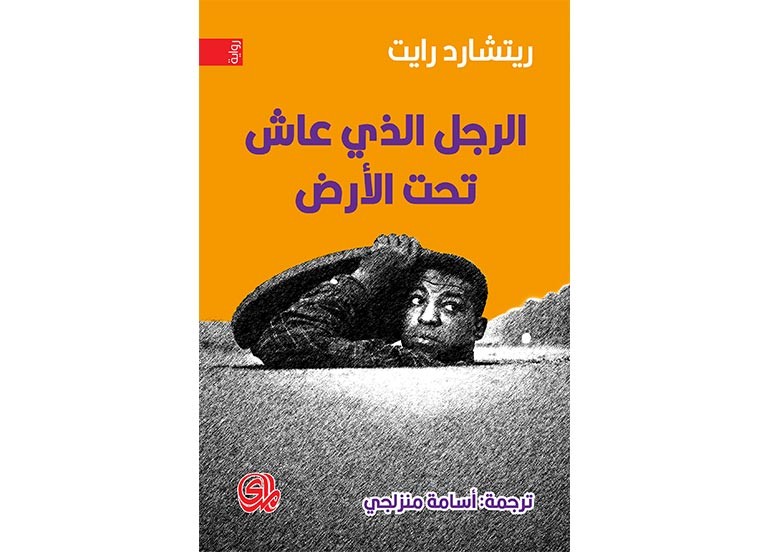
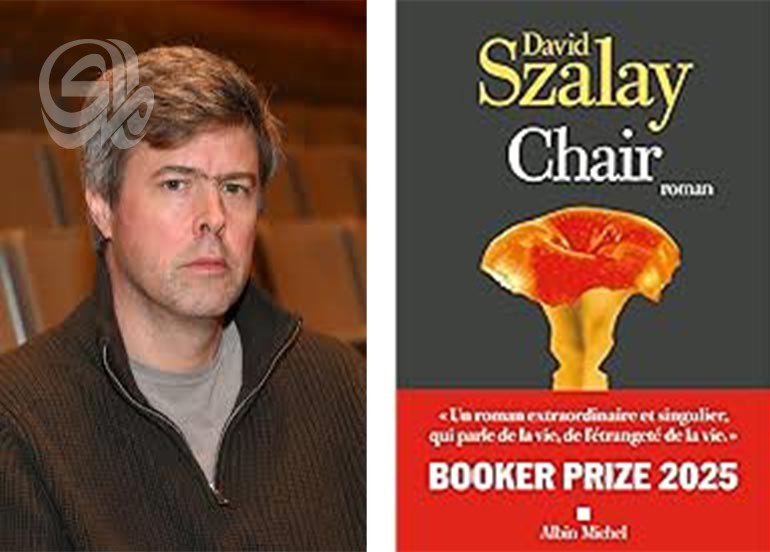


جميع التعليقات 1
حارس القندلفت
عزيزي أبو خيّـام : كنت وادّاً لو تطرقت الى قلق الكتابة في المنفى، وخصوصاً في سوريا، التي أخذت منّـا الكثير .