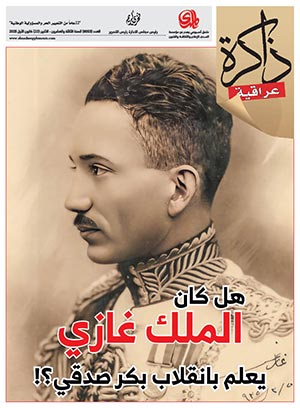عقيل عباس في تموز ٢٠١٠، في خضم السخونة اللاهبة للصراع على منصب رئاسة الوزراء بين إياد علاوي ونوري المالكي، تحدث الأخير في لقاء مع قناة العراقية عن أزمة تلك الأشهر الصعبة . أثارني في حديثه هذا إشارته إلى انه كرئيس للوزراء لن يسمح أن يحتل هذا المنصب شخصٌ غير جدير به (ربما في إشارة مبطنة لعلاوي)
وصورَ مهمته الدفاعية عن "حرمة" المنصب على أنها أمانة أخلاقية ووطنية في عنقه. استوقفني كثيراً تمددُ صلاحيات المنصب في ذهن المالكي ليشمل "حقه" الضمني في تحديد من يخلفه في رئاسة الحكومة أو ضمان أن يكون خليفته "مناسباً" على النحو الذي يعتقده هو. بالطبع، لا شيء في الدستور أو العُرف السياسي يمنحه، أو أي شخص آخر، مثل هذا الامتياز الأخلاقي أو القانوني. من بديهات الديموقراطية، حتى في تخريجتها العراقية المتعثرة، أن من يقرر من يشغل المنصب الأول في البلد هم الناخبون فقط. عموماً، تحفل كلمات الرجل بالكثير مما يُقلق بهذا الصدد، ففي احد تصريحاته الفاقدة للحساسية الديموقراطية والإنسانية، اتهم سجناءً معتقلين كشفت منظمات حقوق إنسان دولية وخبيرة تعرضهم للتعذيب في سجون حكومية بأنهم افتعلوا أنفسهم آثار التعذيب على أجسادهم لخداع هذه المنظمات! ومؤخراً ظهر في مقطع فيديو وهو يحث منتسبين في القوات الأمنية على شن عمليات دهم عشوائية! كثيرة هي تصريحات المالكي التي تخالف الديموقراطية وتخرج على الدستور. في البلدان الديموقراطية العريقة تكفي بعض تصريحاته هذه للإطاحة بمستقبل أي سياسي يتفوه بها ووضعه بمواجهة القضاء، وحتى وراء القضبان. باستمرار تتمدد سلطة المالكي ويتسع نفوذه خارج إطار الصلاحيات الدستورية لمنصبه. جاءت بداية هذا التمدد في أسلوب قيادته القوات المسلحة والأمنية الساعي لتركيز السلطات بين يديه ،فبدلاً من الإشراف المدني على هذه القوات كما قَصدَ الدستور، وكما هو مألوف في الدول الديموقراطية، لجأ الرجل إلى أسلوب القيادة المباشرة على نحو همش دور وزارتي الدفاع والداخلية وقوض السياقات الرسمية والمؤسساتية في الإدارة والقيادة في دولة يُراد لها أن تكون دولة مؤسسات. يبدو هذا الأمر واضحاً في إنشائه، من دون تخويل أو إشراف برلماني، غرفَ عمليات عسكرية-أمنية خاصة (غرف عمليات بغداد، وديالى ونينوى) بصلاحيات واسعة يديرها هو مباشرة ً، ويُعين ضباطها الكبار وتدين بالولاء له، ويستخدمها ضد خصومه أو يخوفهم بها كما أشارت إلى ذلك تقارير منظمات دولية كثيرة . يخضع نحو مليون رجل في المؤسستين العسكرية والأمنية لأوامر شخص واحد، من دون إشراف أو مساءلة برلمانية حقيقية، بالرغم من أن هذه الهيمنة الشخصية على هاتين المؤسستين لم تفض إلى وضعٍ امني أفضل يفوق شبه الاستقرار الذي تحقق منذ ربيع 2008 وتواصل حتى الآن. سياسياً، جاءت علامات التمدد الأولى عبر تأسيس المالكي مجالس إسناد في المحافظات بتمويل حكومي لتروج انتخابياً وسياسياً له ولحزبه. ثم هناك محاولات القضم التدريجي لاستقلال المؤسسات التي خُطط لها أن تكون مستقلة كهيئة نزاعات الملكية ومفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة وغيرها. ومنذ توليه رئاسة الوزراء، تراجع كثيراً الاستقلال القضائي الهش الذي بدأ بالبروز منذ 2003، ليتحول القضاء إلى إحدى أدوات نفوذ رئيس الوزراء. حتى في اتهامه طارق الهاشمي بالإرهاب وسلوك القضاء في هذه القضية لحد الان، يبدو المالكي محفزاً برغبته هزيمة خصم سياسي أكثر منه تحقيق العدالة وكشف الحقيقة قضائياً. لعل المشهد الأشد علنية على نزوع الرجل نحو الاستبداد وضيقه بالمعارضة هو الشراسة الأمنية اللافتة والتشويه الإعلامي الواسع الذي تعامل بهما مع تظاهرات الاحتجاج السلمية الصغيرة نسبياً التي رافقت وغذت النشوة العراقية بالربيع العربي. على الأرجح، يروق كثيراً للمالكي موقعه المركزي المهيمن على مشهد السياسة اليوم، فكل اللاعبين فيه إما يخشونه أو يطلبون رضاه، سواءٌ كانوا حلفاءه المستائين والعاجزين عن تغيير سلوكه أم خصومه الخائفين برغم استمرار تحديهم له، أم أنصاره غير المشككين. يؤمن المالكي بضرورة الزعيم القوي لحكم العراق، تلك الفكرة الكارثية التي كانت دوماً تقود في العراق إلى بناء سلطة الحاكم وإضعاف مؤسسات الدولة. لم يخلُ العراق من زعماء أقوياء كنوري السعيد، وعبد الكريم قاسم، وصدام حسين، تشابهوا في ذات المسعى مع المالكي في بناء سلطة قوية، لكنهم جميعاً، برغم اختلافاتهم الشاسعة الأخرى، ارتكبوا ذات الخطأ الفادح بإغفالهم أن جدران هذه السلطة، لشدة صلابتها وارتفاعها، كانت عازلة عن كل ما يقع خارجها: قلق الشارع، وإيقاع السياسة، ودروب المستقبل. من هنا كان فشلهم جميعاً في حكم العراق. في عام ٢٠٠٣ كان إغراء العملية السياسية، واختلافها الجذري والإيجابي عن كل تجارب الحكم السابقة في العراق، يكمن في إ
مــن أجــل عمليــة ديمقراطيــة لا سياسيــة!

نشر في: 12 مارس, 2012: 08:01 م