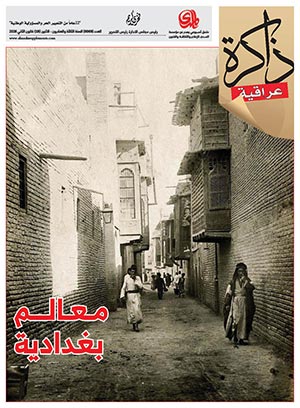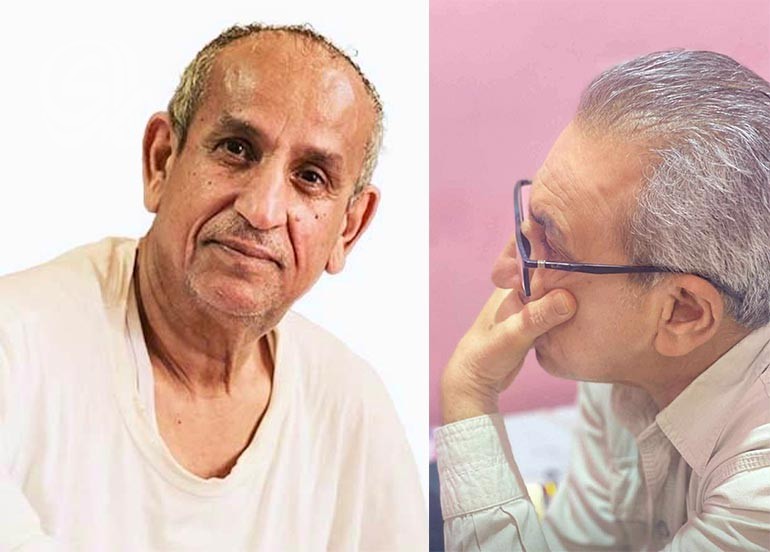(!) مات الطاهر.. كلمتان أليمتان سمعناهما قبل ست عشرة سنة بالتمام، وتحديداً يوم 9/10/1996، وبالرغم من أن الوسط الثقافي في العراق كان يتوقع رحيله حينها بسبب اشتداد مرضه في أيامه الأخيرة، إلا أن الخبر كان له، مع هذا، وقع أليم وعميق في المهتمين بالكتابة
(!)
مات الطاهر.. كلمتان أليمتان سمعناهما قبل ست عشرة سنة بالتمام، وتحديداً يوم 9/10/1996، وبالرغم من أن الوسط الثقافي في العراق كان يتوقع رحيله حينها بسبب اشتداد مرضه في أيامه الأخيرة، إلا أن الخبر كان له، مع هذا، وقع أليم وعميق في المهتمين بالكتابة الأدبية والنقدية وقرائها، وفي تلامذته ومحبيه. ولم يأت هذا الوقع الصادم والمؤلم من أنّ الطاهر كان أستاذاً وناقداً فحسب، بل من أنه كان أحد محرَّكات الثقافة العراقية، الأدبية والنقدية منها بشكل خاص، على امتداد نصف قرن تقريباً امتدت من أوائل الخمسينات حتى منتصف التسعينات. ولا يزال بظني يحرك هذه الثقافة سواء أكان ذلك من خلال العشرات من الكتب، والعشرات وربما المئات من مقالاته ودراساته في الدوريات العربية المختلفة، والمئات من طلبته الذين تمتد أصابعه من خلال أستاذيته الصفية وغير الصفية في كتاباتهم. الواقع أن الطاهر، رحمه الله، لم يكتف بما كان يؤلفه من كتب أو يكتبه في الصحف والمجلات، لا بأستاذيته في الجامعات العراقية، ولا بنشاطاته ومتابعاته، التي ما عرفتْ فتوراً أبداً، في الندوات والمهرجانات الثقافية، بل كان قلباً مفتوحاً في طيبته وحبه لأهل القلم وتقديسه للعمل العلمي والبحثي، وذهناً مفتوحاً لم يريد أن يُسمعه شيئاً، وراعياً ودوداً لكل من يؤمه طلباً لرأي أو توجيه أو موضوعٍ للدراسة.
لقد امتدت مسيرة الطاهر بدأبها وعطائها العلمي أكثر من نصف قرن، بدأت حين شدّ رحاله في الأربعينات إلى (أم الدنيا) وعاصمة الثقافة العربية، القاهرة، ومن ثم إلى عاصمة الجمال والثقافة الغربية، باريس، ليحصل فيهما على شهاداته العليا ويعود فيبدأ إسهاماته الأكاديمية من خلال دوره التدريسي والبحثي في جامعة بغداد بكليتيها الرائدتين التربية- دار المعلمين العالية سابقاً- وكلية الآداب، ودوره الثقافي والأدبي خارج الجامعة، خصوصاً عبر إسهامه الريادي مع الرواد المؤسسين الحقيقيين الآخرين لاتحاد الأدباء العراقيين، وترسيخه للتقاليد الثقافية التي عرَفَتْها، وما زالت حتى الآن، مؤسسات الثقافة واتحاداتها في العراق. ومنذ تلك الأزمان عرفته الصحف والمجلات كاتباً ومتابعاً دؤوباً وصاحب أعمدة وأبواب ثقافية. وهو في ذلك لم يتوقف عند الحدود القطرية، التي لا تعرفها الثقافة بالطبع، فامتد نشاطه من داخل العراق إلى خارجه، في مصر والسعودية والإمارات ولبنان والمغرب العربي واليمن والكويت وغيرها. وهو في ذلك ما خف له نشاط، حتى حين خفتت أنفاسه، وما تباطأ دأبه ومتابعاته وحيويته حين تباطأت نبضات قلبه، فشهدت سنواته بل أيامه الأخيرة نشاطاته النقدية والكتابية والتأليفية، كما عهدناها من قبل. ولهذا كله ليس غريبا أن يحظى الأستاذ الراحل بتقدير المؤسسات والاتحادات والجمعيات العلمية والثقافية الرسمية وغير الرسمية في كل الوطن العربي، فكانت تضييفاتها وتكريماتها له التي كان آخرها حصوله قبل بضع سنوات من وفاته على جائزة العويس الإماراتية الكبيرة.
(2)
وضمن منهجه الثقافي الحياتي تطبيق الطاهر لما آمن به من اختلاف الرأي الذي لا يكون النقد إلا به واحترام الآخر والرأي الآخر، وهو ما كان يجسده في كل شيء يمارسه أو يسلكه كتابةً ونقداً وتدريساً ورعايةً وعلاقات. لا شك أن اختلاف الرأي مسألة طبيعية في الحياة، قبل أن تكون في الأدب، وفي مجالات الثقافة والفكر المختلفة، وتبعا لذلك فإن حرية الرأي والدفاع عنه طبيعية أيضا. ولكن هذا لا يعني أن نقول ما نشاء، وكيفما نشاء، وبدون مراعاة لأصول ولياقة مناسبة وعقلنة وتعليل. فمرة أخرى إن الإيمان بالرأي والرأي الآخر والاختلاف الصحي في الآراء والرؤى هو أبرز ما جسدته شخصية الطاهر، ولعل هذا هو عينه الذي قاد ناقدنا الكبير إلى ما أساء بعضهم فهمه واستيعابه وفي النتيجة من ممارسته من النقد الانطباعي أو ألتأثري. والمفارقة أن أصحاب هذا الفهم لمواقف الطاهر ونقده الانطباعي، قد أساؤوا في الأصل فهم النقد الانطباعي أو التأثري، حين كانوا يكتفون منه بما جسده المذهب الانطباعي في الفن. فإذا كانت الانطباعية أو المذهب الانطباعي، حين ظهر في الإبداع، وتحديداً الفن التشكيلي على أيدي فنانين مثل رينوار، يعني التعبير فنياً عن التأثر الذاتي، فإنه حين انتقل إلى النقد، والنقد في موضوعيته وعدم نفي الذاتية بشكل مطلق هو غير الإبداع في ذاتيته وعدم نفي الموضوعية بشكل مطلق، صار يعني التعبير عن التأثر والانطباع أيضاً، ولكن مع إدخال التعليل والتبرير وبعض العقلنة، حتى وإن بقي يعني "النقد الذي لا يهتم فيه الناقد بتحليل الأثر الأدبي، ولا بترجمة حياة مؤلفه، ولا بمناقشة قضايا جمالية مجردة، وإنما يقدم في أسلوب جذاب حي انطباعه هو نفسه بالأثر الأدبي الماثل أمامه"
لقد كان طبيعياً هنا، ونحن نستذكر بعض مقالات الطاهر في هذا الاتجاه، أن يتفق بعضهم معه ويختلف بعض آخر. في الواقع لقد اتفق الكثيرون معه في كل شيء تقريباً، واتفق آخرون مع أغلب طروحاته وآرائه وشخصه واختلفوا في بعض آخر ولكن من دون أن يقلل ذلك من وعيهم بما يعنيه له ولغيرهم وللنقد عموماً، بينما اختلف فريق ثالث معه بشكل شبه كلي ولكن انطلاقاً من حق يمتلكه كل منا في أن يفعل ذلك وفي أن يكون صاحب رأي آخر. ولكن هناك فريق رابع أريد أن أتوقف عنده في هذه الفقرة وهو الفريق الذي اختلف أفراده مع الطاهر، وأساءوا الاختلاف، ثم أساءوا التعبير عن الاختلاف، بل تجاوزوا ذلك في ما كتبوه للتعبير عن ذلك لا على الطاهر ناقداً ولا على آرائه بل على شخصه. هنا نستذكر واحدة من هذه الكتابات بوصفها نموذجاً لهذا، وقد كتبنا رداً عليها وعلى صاحبها حينها، وهو مقال "تساؤلات حول حوار في النقد القصصي العراقي" المنشور في صفحة (ثقافة) من جريدة "الجمهورية" العراقية قبل وفاته ببضعة أشهر، وهو مقال جاء تعليقا على حوار أجراه، مع الدكتور على جواد الطاهر، القاص أحمد خلف في مجلة (الأقلام)، قبل ذلك بأشهر. فإذا كان العنوان لا ينم عن خلل في أصول الحوار والاختلاف والموضوعية، فإن الموضوع نفسه افتقد الكثير من ذلك بشكل صريح وواضح، في أسلوبه وفي محاورته للناقد الكبير وفي تلميحاته غير اللائقة، وهو ما لم نكن نتوقع أن يصدر عن أديب شاب مثل القاص زيدان حمود، مع أستاذ جليل كبير متفرّد بكل معاني النقد والأدب والأكاديمية كالدكتور الطاهر. فما من أحد جاد وناضج في الوسط الأدبي لا يحترم أن يكون لكاتب أو ناقد شاب مثل زيدان حمود رأي واختلاف مع أي كان، بمن علم مثل الطاهر، ولكن أن يكون هذا شيءٌ وأن يكون في الكتابة والتعبير عن الرأي والاختلاف فيه مع الآخر بأسلوب يخلو من اللياقة ومن أصول الاختلاف وأصول التعبير والنقد شيءٌ آخر. وهكذا إذا كنا نسلّم بأنْ يبدي القاص ما أبداه من آراء، في مقاله، فإنه لعيب، بكل المقاييس أن ينجر وراء بعض المتعالمين، ليخاطب أستاذاً جليلا بأستاذية غير مبررة، حين يخاطبه مثلاً بالقول:
"النص الحديث نص عميق إنساني يحمل شفراته المبثوثة عبر عوالم دفينة قابلة للتحليل والتأويل، وهذا ما يكتشفه النقد الحديث".
وإننا لنتساءل مشدوهين ومستغربين: كيف يصدر خطاب بهذا الأسلوب التعليمي من كاتب لمّا يزل يختطّ طريقه ويتلمس مواطئ أقدامه، بدلاً من التماس الرأي ممن يوجه إليه الخطاب؟ الواقع أن أسلوباً مثل أسلوب زيدان حمود قد جعلنا وقتها نتيّقن من صحة تشخيصات الطاهر نفسه حين يلتفت إلى النابه من الكتّاب، ومن الطبيعي أن يكونوا قلّةً، وإلى المتميّز من الكتابات، ومن الطبيعي أن لا تكون كثيرة جداً، ونفهم أيضاً تجاوزه لعدد غير قليل من الكتّاب حين لا يجد لديهم وفي كتاباتهم ما يثير أو ما يعِد به، وفوق هذا يروحون يصرخون ويتعالون على مَن من حولهم. في الواقع، هنا بالتحديد تتجسد المآخذ الرئيسة على بعض الكتّاب الشباب وقتها وحالياً نعني: عدم احترام الرموز الكبيرة في حياتنا الثقافية، وافتقاد تقاليد الكتابة، وانعدام اللياقة، مع المكابرة والإصرار على السير في الطريق الخاطئ، وفي كل ذلك ترى بعضهم، وهنا لا أعني زيدان حمود بل آخرين، يحاول الطيران بغير أجنحته، إن صح تعبيري المجازي.
*أستاذ النقد والأدب المقارن والحديث
كلية الآداب – جامعة بغداد