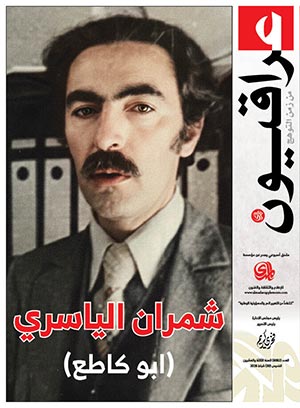كنت كتبتُ ذات مرة "بأن القبر لم يكن المكان الوحيد الذي سبقنا إليه محمود البريكان"، ذلك لأنه كان رائدا في الشعر وفي كتابة المطولات من القصائد وكتابة القصيدة المدورة ومعرفة الموسيقى فضلا عن اهتدائه المبكر لكتابة نمط شعري يعتمد الوجود والكليات الكبرى، وهو دأبُ الكبار من الشعراء.
تذكرت الكلمة تلك وأنا عند قبره قبل نحو من أسبوع صحبة الكاتب الكبير محمد خضير والروائي المغترب الصديق نجم والي الذي كان وراء زيارتنا لمقبرة الحسن البصري حيث يرقد الملوك والولاة إلى جوار نخبة من علماء ومشايخ وأدباء كبار بينهم الشاعر بدر شاكر السياب والشاعر المربي محمد علي اسماعيل والكاتب والقاص محمود عبد الوهاب وآخرون.
يقول رينيه شار: "عليك أن لا تشكو من الموت، أكثرَ من الموتى أنفسهم..." لكن المكان موحش، والقبر قاع أعمق من تصورنا، وهو في النهاية مسكن الذين تعبوا من الجري على الإسفلت، ولأن مقبرة الحسن في الزبير قريبة لنا نحن الذين نسكن البصرة فقد كانت زياراتنا لقبور أصدقائنا من الأدباء هنا بمثابة (نزهة) قصيرة عابرة للحظة الوفاء إلى ما هو أبعد. لحظة لا تدل على التذكر في لحظة الفقد حسب، بل للبحث عن المكان المناسب الأخير لأجساد تتهاوى تباعا. ترى هل فكّر شاعر كبير مثل كاظم الحجاج -هو الذي أسرّني بأنه أشار على أهله بدفنه هنا-أقول هل فكّر بان المكان في رملة الزبير مناسبٌ لشاعر مثله (لم يكلف الله طينا كثيرا) هل قال لهم: "اتركوني إلى جوار صديقي محمود عبد الوهاب فثمة طرْفة لم أحدّثه بها"؟ أو لعله قائل لهم : "الفسحة التي عند البريكان أقرب للمدخل من التي تنتهي بالسياج". هو يراها أكثر سعة فيما يبدو الحجاج بنفوره من الأماكن المزدحمة، وهو الذي يتضايق من جليس سمين في حافلة على الطريق بين بغداد والبصرة، وأنا مثله قلت لأولادي:
"لا تحملوا جثتي إلى وادي السَّلام. فالطريق إلى النجف جدُّ طويل
دعوها غضةً، رطبةً على الأنهار في أبي الخصيب
البلابلُ تسمّي الصباحاتِ لها. والدبابيرُ ،أعرفها تمرُّ مسلمةً
الأبقارُ تلطعُ الملحَ عن شاهدتي. فدعوني هنا ...
لا أحبّني مربوطاً بالحبال على المركبات
وإنْ لمْ يكنْ لكم مِنْ بدٍّ علي، وسّدوني الرمل، لصّق سيّدي الحسن البصَّري
حيث يرقد أشياخي السيّاب والبريكان وعبد الوهاب ."
هل شكونا من الموت أكثر من الموتى أنفسهم يا رينيه شار؟ في لحظة تجوالنا بين أضرحة السيّاب والبريكان ومحمود عبد الوهاب كنت خائفا من لحظة الموت حقا، ثم أني وجدت أن محمد خضير لم يكن لينصرف بكليته نحونا أنا ونجم والي. ظل محمد منشغلا في معاينة الرمل، وتصفح الحجر والشواهد، يصمت طويلاً لكنه مع عبد الوهاب كان أشدنا وقاراً، هو الذي ظل إلى جوار سريره في المستشفى أكثر من 40 يوما ، وهو الذي شهدنا معه هول التراب وهو ينغلق شيئا فشيئا وإلى الأبد عن الجسد البائد النحيل. هل كان محمد خضير يفكر في لحظة أخرى، لحظة غياب ستأتي على أحدنا؟ وهنا لا يمكن تحديد نتائج الرهان والسبق. ولكي أقطع لحظته المرعبة سألته ما إذا كان قد اختار مكانه بعيدا عن أصدقائه، هناك في وادي السلام مثلا؟ قال : لا، هنا. وأشار الى الرمل والحجر والشواهد التي تفرقت في المكان.
قبور كثيرة تحيط بقبر البريكان ، لكنها غير معاينة لنا فقد شغلنا بواجهته التي أنشئت حديثا، مقاطع حديدية زخرفت ببساطة، لعلها من عمل حداد أخذ أجره ومضى يبحث عن قبر آخر. واجهة خُط عليها بحروف لا تدل على عناية الكاتب،-هو الذي كان يسحر عيون طلابه بخطه على لوحة الدرس-،كتبوا اسمه وتاريخ وفاته، وسوى الطلاء الذهبي الذي يبرق من اللوحة الصغيرة لا شيء يدل على مكانة وعظمة صاحب القبر.
هناك لحظة أخرى تشبه لحظة غيابنا عن تشييعه في 28 شباط 2002. اللحظة التي أُستعْملت على عجل ليدفن الشاعر، في غياب من بعض اهله وأصدقائه ومحبيه، هكذا بغياب صامت غريب لم يخطط له حشدُ المشيعين آنذاك، ليذكرنا بلحظة إنشاء ودفن السيّاب قبل أكثر من خمسين سنة.
ان وقوع المقبرة على طرف المدينة المزدحمة،-أنت تسمع جلبة الناس وأبواق السيارات وترى إنارة الشوارع- جعل من المكان أقل رهبة ووحشة ، أكثر تعاطفا مع الحياة. ما تقوله حقا يا رينيه شار.
ولأن الوقت للتذكر أكثر منه لكتابة حية متطفلة بجوار الموت تذكرت محمود البريكان قبل نحو من عشرين سنة، وهو يمرُّ وحيدابخطى وئيدة لا تكاد تسمع قرب تمثال السياب على شط العرب. كنتُ على مبعدة منه، رأيته يقلب طرفه الحييّ بالمعدن البعيد في السماء، نظرة من الامام وأخرى من الجانب، ومثلها في الرأس والصدر واليدين. هل كان البريكان يقترح على السياب وقفة مغايرة؟هل فكر فيه حياً، في مقهى ما، منزل ما في بغداد أو البصرة، أم راح يقلب لحظة موته الغريب في المستشفى الأميري بالكويت؟
لم يدخل البريكان مستشفى ما، وما عرفت عنه شكوى من مرض ، وسوى لحظات فزعه الأخيرة لحظة تلقيه الطعنات، لم يشك من شيء. ظل صامتا منطويا على أسئلة الوجود الكبرى حتى لحظته الأخيرة. هذه التي تفصل بيننا الآن.
بصوت هو أقرب لليأس، يهمس محمد خضير بأذني ساعة خروجنا من المقبرة لو أن مؤسسة ثقافية حكومية ربما تعمل على جمع نثار مبدعي المدينة، لملمة قبورهم في أقل تقدير. قلت هذه فكرة تنشئها لحظة أخيرة، نعم وتذكرت قبري التميميين جرير والفرزدق تذكرت الجاحظ والأصمعي والفراهيدي وابن برد وأبي نؤاس ورابعة العدوية، ولما طالت القائمة تذكرت من الأحياء والأموات ذلك لأن اللحظات تساوت عندي فقلت: محمد ناصر ونجيب المانع ومحمد سعيد الصكار وسعدي يوسف ومصطفى عبد الله وعبد الخالق محمود وإسماعيل فهد إسماعيل وصلاح جياد وفيصل لعيبي.. لا، سأكف عن التذكر. هذه المدينة المتحف، هذه المقبرة المدينة. سلام على الذين في بطنها. سلام على الذين عليها.