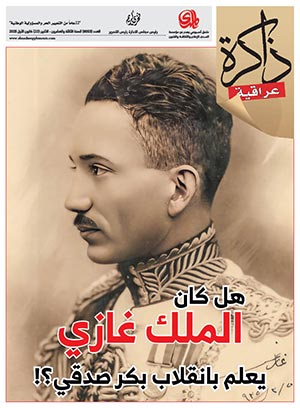عشية الانتخابات التشريعية الأخيرة في العراق عام ٢٠١٠، برزت ظاهرة تحوّل كل الأحزاب والكتل الانتخابية، باستثناء الحزب الإسلامي، إلى اختيار أسماء تضفي عليها طابعاً "مدنياً " بعيداً عن المسميات الدينية، ورافقت تلك التغييرات " الشكلية " حملة براءة بأشد الصيغ والمفردات من " الطائفية " وانحيازاتها، حتى قيل أنها " مقيتة " وغير ذلك من النعوت التي بشّعت الداعين لها والمحرضين عليها.
وتباينت ردود الأفعال على تلك الظاهرة. فالبعض رأى فيها بدايةً لصحوة ومنطلقاً لإعادة النظر في طبيعة ومسارات العملية السياسية، ورغبة في تجاوز المحاصصة الطائفية البغيضة. ورأى آخرون أنها ليست سوى محاولة للتمويه والخداع، وذرّ الرماد في عيون الناخب المبتلى، والتشويه عليه في عملية الاقتراع في الانتخابات واستحقاقاتها.
وما لم يدركه القائلون بالتوصيفين للظاهرة، أنهم إذ حددوا جانباً من الدوافع التي كانت في أساس ظاهرة " التغيير الشكلي " والهدف من وراء تبنيها، فقد غاب عنهم ماهو اهم من ذلك، بل ما هو في واقع الحال "جوهر الظاهرة وأُسّها ". فعملية التغيير التي ارتبطت بالاستحقاق الانتخابي التشريعي، عكست ادراكاً من الأحزاب والكتل الدينية، الطائفية بطبيعتها، لافتضاح نواياها وفساد دعاواها وانفضاض الناس من حولها، بعد ان عايشوا وتجرعوا الأمرّين من سياساتها ونهجها في الحكم، واكتشفوا البون الشاسع بين القيم الدينية، وسلوك قياداتها وكوادرها في الحكومة وأجهزة الدولة، وإمعانهم في نهب المال العام والتعديات على كرامة الناس وحرياتهم وعزوفهم عن كل ما له صلة بالصالح الوطني.
وقد أميط اللثام عن كل ذلك بعد الانتخابات مباشرة. فالاصطفاف الطائفي ظل على حاله، بل ازداد استقطاباً، والمظاهر التي أفسدت الحياة السياسية بمختلف جوانبها، اتخذت طابع تحدٍ لمشاعر المواطنين، بعد ان تحول النهب والرشوة والفساد الإداري والمالي، إلى سياسية دولة، بعد ان كانت ممارسته تتم بشيء من الحياء والكتمان، انّى كان إلى ذلك سبيل. وأضيف إلى تلك المثالب والخطايا انزياح في فسحة الحريات، واستدراج للدولة والحكومة نحو تكريس سلطة الحزب الواحد والقائد الواحد، وانسياق البلاد إلى متاهات أزماتٍ متفاقمة، ظل الهدف الكامن من ورائها تكريس سلطة استبدادٍ للفرد، تحت واجهة مخادعةٍ تستظل بالطائفة، وادعاءٍ باطل بالمصالح الوطنية.
ومنذ أعيد ترتيب البيت الحكومي على مقاس السيد الفرد، وتصاعد الأزمات الواحدة تلو الأخرى في تزامنٍ مريرٍ مع اختناق المواطنين بالحرمانات والمضايقات وانغلاق سبل الخلاص من الإرهاب وخلافه، برز عامل جديد كان له ابرز دور في تبيان الطبيعة السياسية، المتناقضة مع ادعاء الأحزاب بالتمثيل الديني والطائفي، وهو نفور المرجعية الدينية في النجف الأشرف، عن الطبقة السياسية الحاكمة، وعزوفها عن قبول أية صلة بها، تعبيراً جلياً لا يحتاج إلى تفسير، عن رفضها لارتباط ما يتم في أروقة الدولة والحكومة، من نهج وممارسات ونهب وتعديات، باسم الدين والتدين وقيمهما، وما يتطلبه هذا من نظافة اليد ورجاحة المنطق والالتزام بالأخلاق الحميدة والضمير الحي. وهذا كله يجري التأكيد عليه بلسان عربي فصيح في خطب وكلاء المرجعية في مساجد النجف والكوفة وكربلاء.
ومن الواضح في مجرى هذا السياق، انفصال الإسلام السياسي، ككيانات وأطر ومسميات، عن التوصيف المرجعي الديني والطائفي. واندراج حركاته في صيغ من الممارسة السياسية الحزبية، بإقحام الدين وتحت خيمته، وباسم الدعوة له ولرسالته، في عالم السياسة وكبائرها وملاعبها المشبعة بأساليب الخديعة والمكر والتزوير والتلاعب بالمصالح والتجاوز على الأعراف.
ولا يقتصر الأمر على ما نعيشه في العراق من تناقض بين ظاهرة الإسلام السياسي وتجلياته الحزبية، وإنما يمتد ليشمل الظاهرة في كل مواقع حركاتها في العالم العربي والإسلامي. وها هو الأزهر الشريف وموقفه من الإخوان المسلمين والحركات السياسية الإسلامية، وإدانته لإقحام الدين في السياسة، والسياسة في الدين، بالإضافة لإدانته فتاوى "إمام قطر" القرضاوي، واعتبارها خروجاً عن رسالة الإسلام وأهدافها، وتوظيفه المخل لها في السياسة، لأغراض متحزبة، مناقضة لمصالح الأمة.
فهل الإسلام والمسلمون بحاجة إلى مرجعية دينية تكفُل النصح والإرشاد لتصويب ما يخرج عن مساراتها الإيمانية، دون الإثقال على ضمائر الناس، أم أن الإيمان لا يستقيم إلا بالحجر على دنيا المؤمنين بوسائل السياسة التي تستعير الشعارات الدينية لتحقيق أغراضها ومصالح قادتها وأفرادها، وتستهوي ممارسة كل مباءات العمل السياسي، دون ان تبالي بتدنيس الدين الحنيف، وهي تخوض مستنقعاته؟
وكيف يبدو الأمر حين يصبح الإسلامي السياسي في تعارضٍ وتناقضٍ مع المرجعيات الدينية؟!