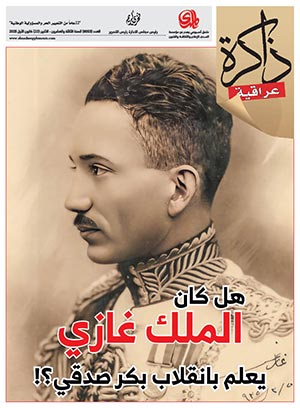يتّخذ النقاش في الموقف من الأنظمة الدكتاتورية في العالم العربي، طابعاً ملتبساً شديد التناقض، حين يدفع باتجاه التغيير وتقييم أدواته، دون اعتبارٍ للبديل السياسي والقوى المرشحة للوثوب إلى السلطة. لكنه ينطوي من جانب آخر على تبرير الدكتاتورية وإمكان التعايش معها ما دام البديل المرئي ضبابياً، أو يعيد إنتاج استبدادٍ آخر. ويتغافل المتساجلون عن رؤية خيارات بديلة كامنة، تتطلب البحث داخل ظاهرة الصراع، بين الدكتاتورية القائمة، والقوى الاجتماعية والسياسية صاحبة المصلحة في التغيير. وقد لا يكون يسيراً التقاط العناصر الإيجابية في الظاهرة وهي في طور التكون والتطور، إذ تختفي ملامحها وهي جنينية، في رحم القوى المهيمنة الأكثر تنظيماً، والأقدر على تصدر الحراك وتأطير المشهد السياسي "الثوري".
وتجربة الانتفاضة الشعبية المصرية في مرحلتها الأولى، تجسيد لهذا التناقض والالتباس. إذ تمكن تنظيم الإخوان المسلمين من استدراج الثورة إلى مواقعه، بحكم قوة تنظيمه وانتشاره، وتخدير القوى الشعبية التي لم تمتحن صدقية شعاراته، وأساليب تعامله مع مسؤولية الدولة، واحترامه لإرادة الناخبين، وقناعته بمفهوم الديمقراطية باعتبارها تتجاوز صناديق الاقتراع المجردة. كما أن التنافس الذي اقتصر في الدورة الثانية على المرشح الإخواني، والمرشح الذي يرمز في وعي الناخبين إلى النظام القديم، عمّق الالتباس لدى أغلبية المقترعين، وأوساط وشرائح واسعة من القوى الوطنية والتيار الشبابي الثوري، محرك الانتفاضة وملهمها، لصالح الإخواني الذي لم يوفر أيّ وعد أو شعار أو ضمانٍ للالتزام بروح الثورة وأهدافها ومطالب المنتفضين. وتمخض ذلك الالتباس عن إعادة إنتاج نظامٍ استبدادي النزوع، بطبائع تكفيرية للمجتمع غير الملتزم بالسمع والطاعة للجماعة، مما شكل خطراً داهما على بقاء الدولة وإلغاء للمواطنة المصرية.
ولا تخلو التجربة التونسية والليبية، من عناصر السياق الذي انقادت اليه الانتفاضة المصرية. وتتفاعل الساحة السورية المتشظية، عن حراكٍ تتفاعل فيه اتجاهات وأطراف وقوى متناقضة في التكوين والشعارات والأهداف، وتكاد التيارات الإسلاموية، التكفيرية بشكل خاص، ان تحتل مواقع متقدمة في الصراع المسلح، وتهدد، إذا ما تعدى نموها وفعاليتها إمكانية لجمها وتحجيمها، مصائر الصراع الدائر حول المستقبل الديمقراطي لسورية.
ان المنعطف الذي تجتازه دول الربيع العربي، وما تبقى من شظاياه واشلائه، يكفي للاستدلال على ان الانطلاق من التغيير، مجرداً عن تقييم قواه الفاعلة واتجهاتها، يمكن ان يضعف اليقظة من العواقب والتصاريف السلبية التي من شأنها إعادة انتاج بديل استبدادي مُكيف، أياً اتخذ من لبوس وتعهدات.
ويبدو واضحاً اليوم من رصيد التجربة المعاشة، في أكثر من بلدٍ ومنطقة، ان الإسلام السياسي، بكل اتجاهاته وميوله وطوائفه، لا فرق بين القائمين عليه، ليس بإمكانه إلا إنتاج نظامٍ شموليٍ طائفي، يتنكر لمفهوم الديمقراطية، بما هو عليه من تداولٍ فعلي للسلطة، ومصادرة إرادة الناس، وتغييب الآخر، عن المشهد السياسي. وربما يرى البعض ان اعتماد الطائفية وويلاتها، إنما هو حكرٌ على بلدان التعدد والتنوع الطائفي والمذهبي. لكن الواقع يدحض عملياً هذا الاعتقاد، ويؤكد بان الإسلام السياسي، في أي مجتمع أمكنه ان يتسلط أو يهيمن، يتعذر عليه الحكم خارج إطار الطائفية، ورفض وتكفير الاختلاف. ولنا في العراق ومصر والسودان وأفغانستان وغيرها من الدول التي قادتها أقدارها إلى خيار تسلط الإسلام السياسي على إرادتها، أمثلة على أنها ودون استثناء، تتميز بتمزيق نسيج المجتمع، وتقسيمه إلى معازل وكانتونات، وإفراغ المفهوم الإنساني للمواطنة من جوهر قيمه وأدواره في تحديد خياراته الحياتية ومستقبل تطوره.
ولكن بغض النظر عن هذه التناقضات التي ترتبط بعملية التغيير وإرادة الانتقال إلى الديمقراطية، فان ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال، ومهما كانت الصعوبات، تبرير الاستكانة والقبول بالتعايش في ظل النظام الدكتاتوري، خشية من البديل. لكن ذلك يتطلب، لكي يصبح المسار آمناً وسالكاً، التفاعل مع قوى التغيير بيقظة، والعمل على فرزها وإعادة الاصطفاف بين صفوفها، وان أدى ذلك أحياناً إلى تبديد وقتٍ إضافي.
ان عملية التغيير، تعني في المحصلة النهائية، تحرير إرادة الشعب والاستجابة لتطلعاته واستشرافاته، وفكّ أي قيد من قيود القسر القيمي، تحت أي مسوغ، عن رحابة عقله وضميره.
إنكار الدكتاتورية لا يزكّي البدائل التكفيرية الإسلاموية
نشر في: 15 يوليو, 2013: 10:01 م