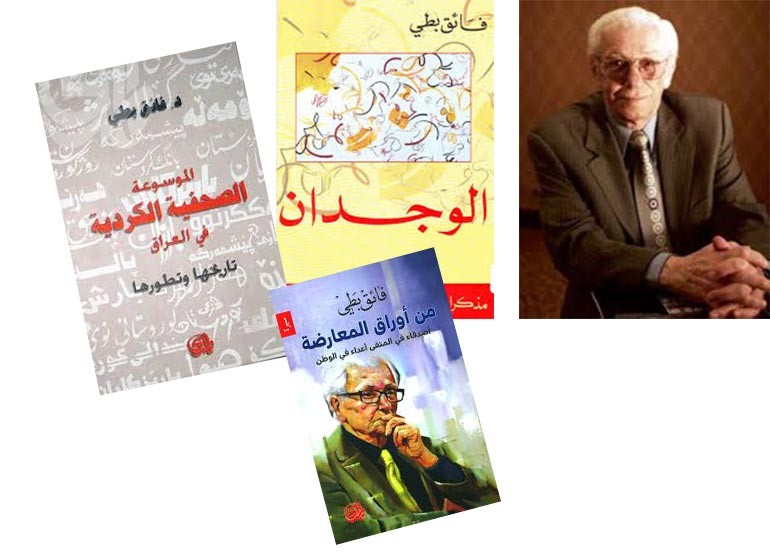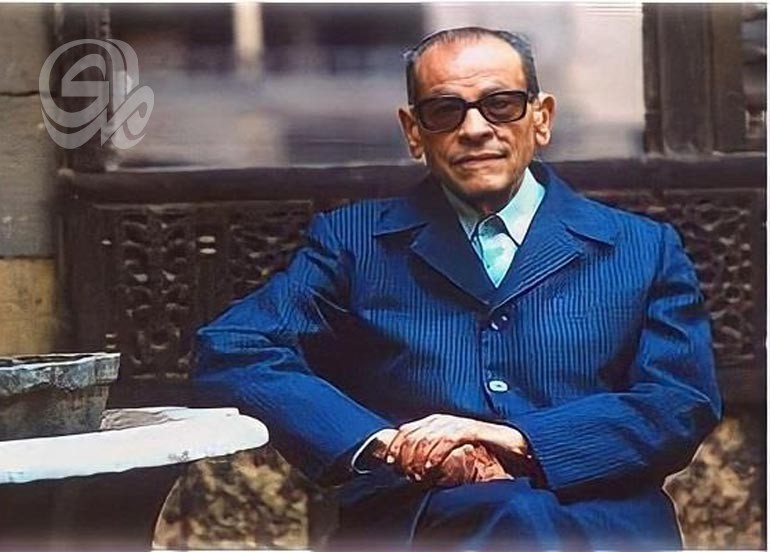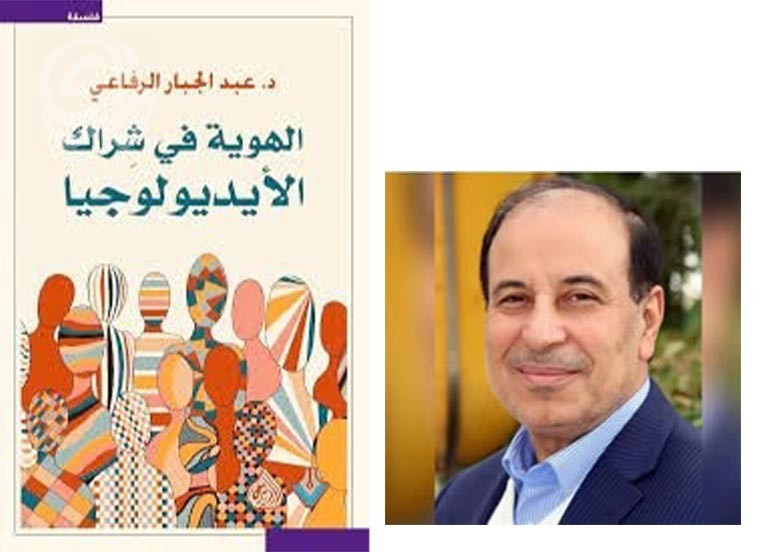لا احسب ان رحيل الشاعر حسين عبد اللطيف عن عالمنا الصاخب والمريب كان رحيلا مطمئنا، اذ كان مسكونا بالخوف من ان تخذله قدماه للعبور، ومن ان لايعيش لحظة (ديموزي) في رحيله للعالم السفلي...الشاعر كان ينظر للحياة بوصفها خلودا ساذجا، لم يشأ ان يغادر لأجلها أم
لا احسب ان رحيل الشاعر حسين عبد اللطيف عن عالمنا الصاخب والمريب كان رحيلا مطمئنا، اذ كان مسكونا بالخوف من ان تخذله قدماه للعبور، ومن ان لايعيش لحظة (ديموزي) في رحيله للعالم السفلي...
الشاعر كان ينظر للحياة بوصفها خلودا ساذجا، لم يشأ ان يغادر لأجلها أمكنته المثيولوجية، ولم يفكر بالبحث عن عشبة واهمة لهذا الخلود، جلّ ما كان يراوده هو أنوثة القصيدة، تلك التي تسكن قميصه، وتبادله الشغف واللذة والخوف، لذا كان يتوهم الرحيل اليها دائما، والعبور الى عتبتها الأكثر توهجا وغواية، اذ يصطنع لها جحيما ومطهرا وفردوسا، حدّ انه كان يتحسسها ليلا وهي تشاطره السرير والليل والعواء..
رحيل الشاعر حسين عبد اللطيف فيه الكثير من الفقد، ليس لأنه رحل مضطرا تحت سطوة عذابات موحشة تركت له الكثير من الوجع والشعر والاسئلة، بل لأنه ترك بعض قصائده عند حافة السرير مثل أصص النرجس، تلك القصائد التي كان يبادلها اغترابه وخوفه، والتي ستصاب بالعطب حتما، اذ لا ارث للشعراء الموتى..
موت الشاعر لايعني سوى ذلك الفقد، ولايعني سوى الذهاب الى حائط العائلة او المكتبة تلك التي توحي للاخرين بوجوده الغائب، رغم انه كان اكثر الشعراء هوسا بملاحقة الوجود عبر الاخرين من الشعراء الذين يعشقهم بحثا عن اوهام للخلود...
حسين عبد اللطيف كان يدرك وحشة الفقد، مثلما كان يدرك قسوة ان يغامر بالشعر وحده، وان يضع جسده إزاء حرائق وجودية لاتنتهي، لكنه كان متيقنا من ان هذا الشعر كان بعض خلاصه، وبعض اطمئنانه- حتى وان كان مغشوشا- فهو كثير الصمت وكثير القلق وقلق البحث عن شقوق اخرى في الجدران التي تحوطه..
منذ نشر حسين عبد اللطيف كتابه الشعر الاول(على الطرقات أرقب المارة) عام 1977 وهو يثير الانتباه الى تجربته الجادة، اذ تنحو قصيدته الأكثر انحيازا للنثر باتجاه التعبير عن اغتراب وجودي وعن نوع من الحساسية الشعرية إزاء تاريخ مهووس بشعرية الاصوات، ولعل كتابه الشعري الثاني(نار القطرب) المنشور في العام 1995 كان باعثا للكشف عن ملامح هذه التجربة التي تتشكل وسط اصخاب شعري عراقي وعربي، فالشعراء الستينيون يبحثون عن وجوه اخرى للكتابة الشعرية، وشعراء بيروت اكثر احتشادا بأوهام التناصات الشعرية واسئلتها المرعبة والباحثة عن بهجات سرية للجسد والقصيدة والمكان، وبين هذا وذاك كان حسين عبد اللطيف يلملم لغته الشعرية بخجل الجنوبي المصاب بهلع الأمكنة، بحثا عن لحظته الخاصة، عن لغته الواهبة للتفكير والسكنى، عن صوته العالق بهواجسه، وباحلامه التي ظلت لصق اسطورة المكان البصري، ومثيولوجيا الشغف الحكائي الذي نهل منه السياب والبريكان كثيرا..
حاول حسين عبد اللطيف ان يكتب قصائد اخرى لتكريس تجربته الشعرية، ولتوكيد ما انجزه في مشروعه الشعري غير المكتمل، فكتب كتابه الشعري الثالث ( لم يعد يجدي النظر) وكتابه الشعري الرابع( أمير من أور) واخيرا وتحت هاجس الاحساس بالموت كتب هواجسه الشعرية في كتاب يحمل الكثير من ارهاصاته بالنص المختلف، اذ كتب مجموعته الشعرية(بين آونة وأخرى يلقي علينا البرق بلقالق ميتة- متوالية هايكو) في العام 2012. وكأن هذا الكتاب/ المجموعة كان يعبر عن قمة الفقد الذي يساكنه، اذ تجوهرت كتابته في النزوع للكثافة الشعرية، ولإيجاز الجملة والفكرة، فجسده المضنك بالوجع لم يعد قابلا للتمدد خارج الصوت الشعري، وروحه اللائبة بالخسارات لم تعد قادرة على تحمل القصيدة التي ترحل مثل سفائن البحارة، وبذا وجد في قصيدة(الهايكو) المختصرة ومضته اللامعة إزاء الحياة والوجود والأفكار التي تضج تحت قميصه..
موت حسين عبد اللطيف سيترك حتما فراغا من الصعب اشغاله بالتذكر، ليس لأنه صوت مميز بتجربته وحضوره حسب، بل لأنه كان ضاجا باليوميات الثقافية البصرية وحاضرا في مشغلها وذاكرتها، ورغم صمته المعهود الاّ انه كان مسكونا بالعاصفة والشغف بحضور القصيدة التي تهمه كثيرا، اذ تعني هذه القصيدة الوجود واللذة والفكرة والاحساس بان العالم صالح للتفكير والمعيش..
هكذا يرحل الشعراء في عالم مابعد الحروب، عالم لايصغي لاحد، بل يكتفي بالعطب والفقد واطلاق الشياطين لكي تعابثنا بالمراودة القاسية، بالاخطاء التي لانطيقها، بالاكاذيب والفؤوس والاسماء والعناوين التي لاتفضي لامكنة الاطمئنان ابدا..