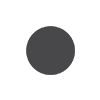يرى الكاتب والباحث الاكاديمي العراقي، الدكتور وليد محمد خالص، في كتابه الصادر حديثا "لو كان فولتير عربيا؟"، ان ما قدمه الكاتب والمفكر السوري جورج طرابيشي للثقافة العربية، يوازي ما قدمه فولتير لفرنسا، وأوربا، دون ان ينسى التنويه الى ان صاحب "المعجزة أ
يرى الكاتب والباحث الاكاديمي العراقي، الدكتور وليد محمد خالص، في كتابه الصادر حديثا "لو كان فولتير عربيا؟"، ان ما قدمه الكاتب والمفكر السوري جورج طرابيشي للثقافة العربية، يوازي ما قدمه فولتير لفرنسا، وأوربا، دون ان ينسى التنويه الى ان صاحب "المعجزة أو سبات العقل في الإسلام"، ظل مشتغلا في مناخ أكثر تعصباً، وقتامة من ذاك الذي استظلّ فولتير بظلاله.
كتاب الباحث العراقي الصادر عن دار "بيت الغشام للنشر والترجمة" بسلطنة عمان التي قضى فيها خالص سنوات عدة في مجالات البحث الاكاديمي والتعليم العالي، استاذا لاداب اللغة العربية، جاء توسيعا مستحقا لبحث خصّ به حفلا لتكريم طرابيشي في تونس، تولته جمعية "الأوان"، و "رابطة العقلانيين العرب"، وقد أُنجز ذلك البحث القصير بما يتلاءم مع مناسبة كتلك التي أشار إليها، غير أنه يوضح سببين اثنين دعيا إلى أن يصبح ذلك البحث كتاباً، وأولهما: أنه لمس في ذلك البحث فجوات، فأعمل نقده الذاتي فيه من حيث ملء تلك الفجوات، وإكمال نواقصه، والاطلاع على المزيد من المصادر التي أثرت الكتاب، وأخرجته بهذه الصورة التي يأملها. فدرس علمين كبيرين هما فولتير، وطرابيشي من خلال "موازنة" الدورين اللذين اضطلعا به، وصولا الى كشف مواطن الاتفاق، والاختلاف بينهما، ليصل بعدها إلى أن "ما قدمه طرابيشي للثقافة العربية من حيث تحريك المستقر، وخدش النسق، وتوظيف منهج نقدي متمايز، والاقتراب من مناطق محظور الاقتراب منها".
واحال السبب الثاني لتحويل البحث اياه كتابا بنحو 250 صفحة من القطع المتوسط، الى "ما مر به الوطن العربي خلال السنوات القليلة المنصرمة من تمزق، واحتراب، وهويات متصارعة، وطائفيات مستثارة"، منوها الى انه لحظ ، وهو في خضم دراسته، ذلك التشابه الكبير بين ما حصل سابقاً (فرنسيا)، ويحصل حالياً (عربيا)، وهو شاهد عيان عليه، فآثر، أن يعمق في ذلك "التوازي بين العصرين، وما اصطرع، ويصطرع فيهما من أزمات، بل نوازل، لعلّ في هذا (التوازي) عبرةً يقف عندها قارئ واعٍ فيفيد منها، ويرشد إليها آخرين، فكأن ما نعيش لحظاته اليوم ما هو إلا (إحياء) لماضٍ ما كان ينبغي أن تُبث الحياة فيه كرة أخرى، ونحن في عصر البرمجيات، واللواقط، والحواسيب، والثورات العلمية المتنوعة، فهل كانت (الحداثة) التي يدعيها البعض، ويدعو إليها آخرون (قشرة) مستعارة، وطلاء خارجياً سرعان ما يذوى، ويزول، لتبرز طبقات قيم القرون الوسطى".
وعن ما جمعه الى صاحب "نقد نقد العقل العربي" باجزائه الثلاثة، يوضح خالص، علاقته القصيرة، والطويلة في آن واحد مع طرابيشي: "أّنها قصيرة فأريد بها تعرفي القريب على شخصه الكريم، ومراسلاتي معه، ولقائي النادر به في مدينة مسقط، بسلطنة عمان قبل سنتين، وهو ما فصلت الحديث عنه في كتابي "معضلة اللغة العربية بين الجابري وطرابيشي"، وإما انها طويلة فأعني بها تلك الآصرة الفكرية التي ربطتني، ومعي كُثُر، بما كان يصدره الأستاذ طرابيشي من مؤلفات، وترجمات عملت على تشكيل العقل، وتهذيب الروح، وأدخلتنا في عوالم، ربما بدت غريبة علينا في ذلك الوقت، وفتحت أمامنا آفاقاً من المعرفة، ما كان بمكنتنا التزود بها لولا إنتاجه الغزير، المتنوع".
ويتساءل الباحث، الذي اصدر من قبل "أبو العلاء المعري ناقداً" و"الشعراء النقاد": "ألا يحق لي، وربما لغيري، أن يتساءل: ماذا كّنا فاعلين لو لم يكن جورج طرابيشي؟ ألم أقل إّنها علاقة طويلة من هذه الجهة؟ وها قد ذرفتُ على الستين، وعمر هذه العلاقة ربما تجاوز خمساً وعشرين سنة، وعلى سبيل الرياضة الفكرية حسب، فقد أحصيت للأستاذ طرابيشي أكثر من مائة كتاب بين مؤّلف، ومترجم، أما البحوث، والمقالات، واللقاءات فأعترف بعجزي عن استقصائها"، منوها الى ان علاقته بطرابيشي تعمقت معرفيا "حين انصرفت إلى (مشروعه) في نقد نقد العقل العربي، وفي إشكالية واحدة فيه هي إشكالية اللغة والعقل في التراث العربي، وكانت ثمرة ذلك الانصراف كتابي (معضلة اللغة العربية بين الجابري وطرابيشي) الذي تزين بكلمة تفضل الأستاذ طرابيشي فقدم بها للكتاب، فأضاف بذلك أيادي بيضاء جديدة، ومنح الباحث كثيراً من الطمأنينة، وهو يجول في تلك الدروب المتشعبة العسيرة، المليئة بالأشواك، والمزالق".
وبحسب صاحب كتاب "أوراق مطوية من تاريخ الأدب المقارن في الوطن العربي"، فان فولتير يحضر في إنتاج طرابيشي "صراحة تارة، وضمناً تارة أخرى. ونريد بالأول هو ورود اسم فولتير تعييناً بالاسم سواء أكان هذا الورود استشهاداً برأيه، أو اتخاذه دلالة على موقف من مواقفه، وأما الثاني، أي (ضمناً)، فالمقصود به انسراب مجمل فلسفة فولتير، وإنتاجه الأدبي، وسخريته، ومواقفه الفكرية والحياتية في نسيج إنتاج طرابيشي، ولعلّ الوصول إلى هذه الثانية أكثر عسراً، وصعوبة بسبب استتارها، وخفائها، إذ هي أقرب إلى ما اصطلح عليه في القراءة الحديثة بـ(النص الغائب)، أو (التناص)، أو (التعالق)، إلى غير ذلك من المصطلحات المختلفة بسبب اجتهادات المترجمين للمصطلح الأجنبي".
ويؤكد الباحث الدكتور خالص ان "مهمة طرابيشي أعقد، وأخطر من مهمة فولتير في زماننا الحاضر، وهو ما يهمنا بالتحديد، ولا ينكر أن فولتير قد أدى مهمته في زمانه على أكمل وجه، غير أن ما يجابهه مفكر مثل طرابيشي، وهو يواجه الأصولية، بل الأصوليات، وهي ذات أنياب، ومخالب، وثروات، ونفوذ، تضيف إلى مهمته عقداً، وعراقيل".
واذ يرى خالص ان طرابيشي "يقّلب جمر الاسئلة بيديه إمعاناً في إبقائه مشتعلاً، مضيئاً، إذ ليس المهم احتراق اليدين. المهم أن تظلّ النار مشتعلة، وهي الأسئلة المحرقة بوجه آخر، وعلى وفق هذا أشار في كتبه الأخرى: طرح الأسئلة، وتقديم الأجوبة إن أمكن. الجوهر هو الطرح، وليبق الجواب مفتوحاً"، فانه يذهب الى اسئلة طرابيشي وفولتير المستمدة مقولاتها من منطق العقل، ونبذ التسليم، مستخدمة أدواته المعرفية الغنية للوصول إلى النتائج"، فانه يعتقد ان الاسئلة لم يكتفِ بها طرابيشي، ومن قبله فولتير، بل ذهبا في خطوة أخرى على هذا الطريق الشائك، وهي نقد التشدد الديني، فقد بذر فولتير بذرته فأنبتت نباتاً طيباً، ولو بعد حين، وقال طرابيشي كلمته، فتجهمت وجوه، وقابلتها أخرى بالصمت. وبذر بذرته، وهو يعلم أ ن التربة غير مستعدة، والمناخ ليس بملائم، غير أّنه فعل.
ويخلص الباحث د. وليد محمود خالص الى ان تأكيد فولتير وطرابيشي على "ضرورة الأخذ الصارم بالعقل، وما يفرزه من آليات"، يجب أن لا ينسينا أن الاخير سليل عصر النهضة العربي، فقد "عاش كثيراً من لحظاته الناجحة، والمبهرة، واكتوى أيضاً بكثير من انكساراته، وهزائمه، وهاهو يعيش اليوم لحظات (الردة) عنه"، لكن ذلك لم يفت في عضده، رغم الاجحاف الكبير الذي تعرض اليه، وظل العقل واسئلته العميقة حاضرة في جوهر نتاجه المعرفي حيال وقائع لا تبدو مناقضة لشيء، قدر تناقضها مع المعرفة والعقل.