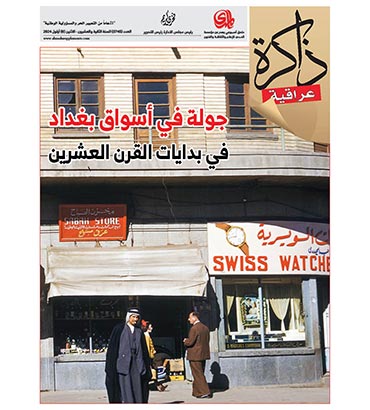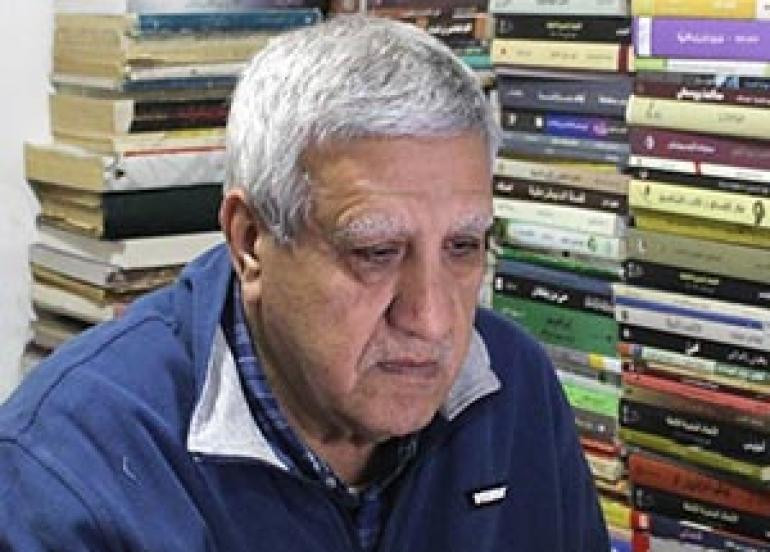(1)
عندما اجترح رواد الشعر الحديث في العراق مأثرتهم الكبرى، أواخر أربعينات القرن الماضي، بدت (تلك المأثرة) أول الأمر، مثل قفزة في الهواء، لكنها قفزة في غاية الجرأة، وإن لم يبلغ شعراؤها السماء لكنهم لم يغادروا الأرض.شغلتني، مثل غيري، فكرة تأصيل قصيدتنا العراقية، ولا أعني بالتأصيل، هنا، العودة إلى الأصول (أية أصول) أو "الأصولية" كحركة انكفاء، أو "تقعيد" القصيدة بأثر رجعي، إنما هو التفكر بـ "أصالة" الأثر والمنطلق، معاً، إلى الدرجة التي تمكن القارئ، أينما كان في المدن العربية، من القول: إنه لشعر عراقي.
محلية الفن هي جذر الشجرة مهما امتدت غصونها بعيدا، والمحلية ليست "قطرية" أو "قومية" تعزل النوع الفني عن محيطه القريب أو عالم الفن المترامي، إنما هي المنبع الصافي الذي يتخطى الحدود والتذوق الجغرافي، وحتى التاريخي، للنص، مثلما تلقفنا، نحن القراء الذين أصبح بعضنا شعراء فيما بعد، ما قدمته لنا الترجمات العظيمة والمتواضعة، من نصوص العالم البعيد.. وثمة عراقيون يكتبون قصائدهم بلغات أجنبية، اليوم، وإن كانوا قليلين جدا.. لكن الأهم هو أن تجارب العالم "البعيد" في الشعر والسرد والتتشكيل والموسيقى والمسرح، وغيرها، لم تعد بعيدة من متناول القلب والوعي، خصوصاً بعد ثورة المعلومات والاتصال المدهشة.
نعم، ثمة خصوصية شعرية في تجربة شعرنا العراقي، رغم تذبذب الخط البياني لمسيرة القصيدة العراقية، ولأن القصيدة مخلوق هش فهي قوية أيضاً، وما مجاهدة الشعراء العراقيين الذين اجترحوا الشعر الحديث، السياب والبياتي والملائكة، وإلى حد ما الحيدري (بلند) إلا وثبة كبرى في لعبة التجديد الصعبة، عندما نتذكر القصيدة العربية، شكلها ومحتواها، والتي عمرها نحو ألف وخمسمئة سنة، ليأتي شبان شجعان، لهم من الحساسية التحديثية، ليقولوا "شيئاً" مختلفاً أطاح الرنين القديم والتواتر الممل للقوافي، وما يستدعيه من حشو وإطناب و "إسفاف أيضاً" بل أطاح "نمط التفكير" الشعري، وهز "البنى الفوقية والتحتية" للشعر العربي، أما هشاشة القصيدة فتعود إلى هشاشة شاعرها، عندما يثقل عليها بما هو خارج اشتغالها ودخيل على بنيتها اللغوية وترميزاتها الفكرية الداخلية وأثرها الشخصي، والخاص جداً، جمالياً، لتأتي "مثخنة" بجراح الآيديولوجيا والسياسة، وكأن القصيدة لا تتنفس ولا تحيا إلا بماهو خارجها من منغصات، عدا ان الواقع، العراقي تحديداً، مفعم بالقسوة والحروب والانكسارات والأوجاع، ما يضع الشاعر وقصيدته تحت وطأة أثقال تقصم الظهر، عليه أن يبدي أكثر ما يستطيعه من مقاومة، وهي مقاومته لكل ذلك بالجمالي، وليس بالدخول جندياً في ساحات الوغى.
أفكر بهذا وأنشغل به وما يمت له، ولست ممن يتوصل إلى إجابات صارمة.. إنما هي تداعيات ضمن مسار الفكرة الحائرة وتواضع القصيدة وزهدها بالخارجي والدخيل على نسيجها المنسوج من خيوط عنكبوت واهية، لكنها في صلابة الفولاذ... ويقع بين يدي كتاب قديم أتصفحه فأجد ما يغريني بأفكاري وأن أسدر فيها، إذ يتناول بروفيسور متخصص بالشعر تجربة القصيدة الإسبانية الحديثة (في معرض حديثه عن فردريكو غارسيا لوركا) فيشير إلى أن هذه القصيدة، مهما تحاورت مع جاراتها الأوروبيات: الفرنسية والإنكليزية والروسية، "اتجهت اتجاها خاصاً" ويحدد أكثر "أندلسيتها" ولكن، على عادة الكثير من الأكاديميين الغربيين، لم يكلف نفسه بإيماءة بسيطة إلى الدم العربي الذي يجري في عروق تلك القصيدة، وعروق لوركا، نفسه، وباعترافه.
يقول: "تركز اهتمام الشعراء الأسبان بالوسائل التي تمكنهم من جعل الفن معاصراً، كل المعاصرة، وشأن شعراء عصرهم الآخرين، انطلقوا بفكرة واضحة ومتبلورة حول تجاربهم الخاصة، في ميدان الشعر، يحدوهم الإخلاص لهذه الفكرة من دون الاهتمام بأية اعتبارات خارجية". (*)
(*) البروفيسور س. م. بورا، التجربة الخلاقة، ترجمة سلافة حجاوي، منشورات وزارة الإعلام العراقية (1977).
يتبع جزء ثان
عراقية القصيدة العراقية
نشر في: 2 نوفمبر, 2015: 09:01 م