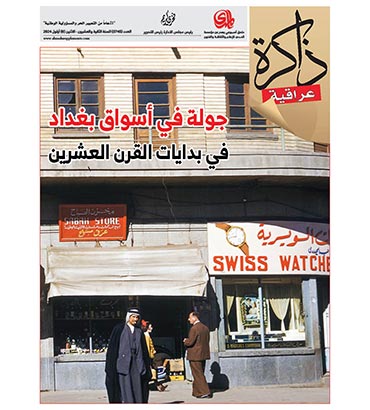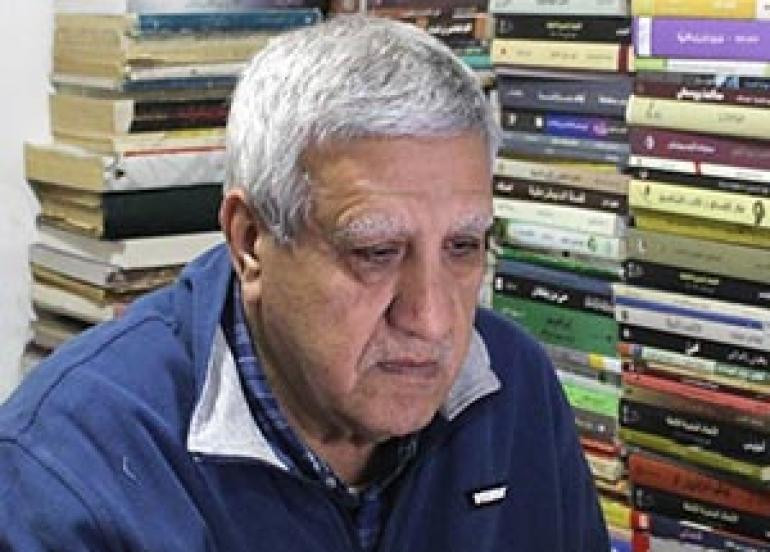أُطل على لندن من نافذةٍ في الطابق الرابع. أمامي أفقٌ فيه السماء ﻻ اتساع فيها، بفعل تلبّد الغيومِ الرمادية الصديقة، ﻷحياء لندن التي تصطفُّ فيها البيوتُ كشرائح قوالب الخبز اﻻنكليزي، ولمتنزهات لندن الواسعة، التي تتزاحم لكثرتها، حتى لتبدو البيوت حييّةً وهي تتطلع برؤوسها من بين أشجارها الباسقة. الغيومُ الصديقة التي تعمق اللون الرمادي بفعل تراكمها، لم تصبح سوداء نزاعة إلى أن تثقل على الناس بالمطر. ومن الصعب أن توحي بالعمق،ﻷن درجات اﻷلوان وحدها التي تمنح هذا اﻹيحاء. إﻻ أنها عظيمةُ اﻻتساع، ما من شك في هذا.
هناك مشهدٌ واحد أعظم من مشهد البحر، يكتب فيكتور هوجو في "بؤسائه"، ذلك هو مشهد السماء. وهناك مشهدٌ واحد أعظم من مشهد السماء؛ ذلك هو باطنُ النفس البشرية.
إن نظم قصيدة الضمير اﻻنساني، لو كان ضميرَ رجل فرد، يقتضينا إذابةَ جميع الملاحم في ملحمة عليا ونهائية. الضمير هو هيولى اﻷوهام، والشهوات، واﻹغراءات؛ هو بوتقةُ الأحلام. إنه وكر المغالطات، وساحة الحرب التي تصطرع فيها اﻷهواء. اخترق في بعض الساعات حجاب الوجه اﻷزرق المسود الذي يحمله كائن بشري مستغرق في التفكير، أنظر إلى ما وراءه. أنظر إلى تلك النفس. أنظر إلى تلك الظلمة. إن هناك تحت الصمت الخارجي، صراعاً بين العمالقة كالذي نجده عند هوميروس، وحشوداً من اﻷشباح كالتي نقع عليها عند ميلتون، ومتاهات مخيفة كالتي نلقاها عند دانتي. أي شيء مظلم هي تلك الﻻنهاية التي يحملها كل امرئ في ذات نفسه. والتي يقيس بها في يأس رغبات دماغه، وأفعال حياته!
هذه اﻷصداء مما كتبه فيكتور هوغو ارتسمت في دماغي، وأنا أحدق في سبابة يدي اليمنى، وهي تشير إليّ. أنا الذي أقفُ أمام النافذة، في الطابق الرابع من المبنى اللندني.
هل أتعرف على ذاتي عبر اﻷلم؟ هل أتعرف على سعة النفس عبر الخوض فيها كما يخوض الغواص البحار ورجلُ الفضاء السماء. وهل يمكن أن أفقد التوازن فأضيع كما يضيعا؟ ولكني أعرف أن قدرَ الإنسان يستخف بالإنسان، والموتُ يجعل مذاقَه ماسخاً. وهما ﻻ تنطفئ فاعليتُهما منذ لحظة الوﻻدة حتى لحظة الفقدان.
مرقت طائرةٌ فألقت على شفتيّ كالظل ابتسامةَ الساخر عن غير إرادة. ومرق طائرٌ فأشعرني بضآلة حجمي. وسعةُ السماء أشعرتني بالعجز عن مسعى اﻹحاطة بالنفس، حتى صار مطلبُ سقراط الفلسفي "إعرف نفسك" منديلاً ورقياً متسخاً، ألقيته في القمامة القريبة.
أي اجتهاد إذن يقودني إلى "التخلي"؟ أليس هو مفتاح كل خلاص؟
على اتساعهما شرّعُت ذراعي، بعد أن أطفأتُ كل الرغائب شمعةً شمعة. نفضت عن جسدي الهزيل قطعةَ لباس المرضى، وأفرغتُ رأسي من حشو الكلام، وقلبي من شحناتِ ردود اﻷفعال. وهمستُ : سأحلّق لو أردت، تحليقَ طائر عبَر. وسأتصاغرُ حتى ﻷدنى الثواني تَحارُ بمقدار حجمي. وسأجعل من "التخلي" ثقباً يذكرني بثقب جيبِ المشرّد، في المدن الحديثة الكبرى. ما من ثمرةٍ من ثمار الدنيا إﻻ وتخرج منه لحظةَ دخولها فيه. إنها أكثر لحظات المنفى سحراً، وأوفرها كرماً.
كانت لندن مقبلةً على النوم، بحرُها وسماؤها أكلتهما العتمة، في حين شعرتُ أن النفس بدأت تتسع، وأني أتحفّز للغرق:
طويتُ من العمر سبعين، مرَّ السحابةِ في الصيفِ، والحزنُ وابلُها والظلالُ.
وما النفيُ في الأرضِ إلا رسولٌ يسامرني منه، والقوتُ والكأسُ ما بيننا،
والتباسُ الرؤى والسؤالُ.
وكلَّ خريفٍ أراهُ يمنُّ علي بـباليتةِ الرسم،
تنعَمُ فرشاةُ روحي بألوانها، ويطيبُ الخيالُ.
ولو حانَ أن أستريحَ، وأُلقي على الأرض عبءَ الحياة،
فحزني فمٌ وابتهالُ،
يقول: النهايةُ لحنٌ على وتري لا انتهاء له أو مقرٌّ،
ولحمتُه وسُداه الجمالُ.
نافذة على أفق
نشر في: 20 ديسمبر, 2015: 09:01 م