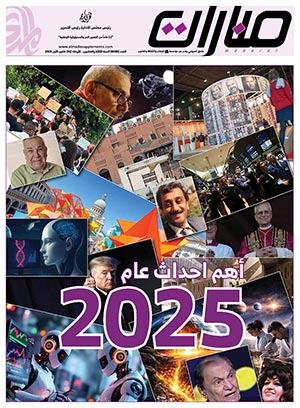على الرغم من الحظر المفروض على جعفر بناهي في صناعة الأفلام، وكتابة السيناريو، ومنعه من السفر لمدة عشرين عاماً إلاّ أنه تمكن من إنجاز فيلمه الجديد "تاكسي طهران" ونجح في تهريبه إلى مهرجان برلين السينمائي ليخطف أكبر جائزة فيه تسلمتها بالنيابة عنه ابنة أ
على الرغم من الحظر المفروض على جعفر بناهي في صناعة الأفلام، وكتابة السيناريو، ومنعه من السفر لمدة عشرين عاماً إلاّ أنه تمكن من إنجاز فيلمه الجديد "تاكسي طهران" ونجح في تهريبه إلى مهرجان برلين السينمائي ليخطف أكبر جائزة فيه تسلمتها بالنيابة عنه ابنة أخيه هانا سعيدي وهي تذرف دموع الفرح وسط التصفيق المُحتدم الذي تعالى في أرجاء الصالة بطريقة انفعالية لا تخلو من التعاطف السياسي مع مخرج سينمائي يقف على الضفة المناوئة للنظام الثيوقراطي المتشدد في إيران. تُرى، هل يتوفر هذا الفيلم على كل الاشتراطات الفنية التي تؤهله لنيل جائزة الدُب الذهبي أم أن هناك أسباباً سياسية دفعت أعضاء لجنة التحكيم لمؤازرة هذا المخرج السينمائي الذي لا يجد حرجاً في تحدّي السلطة الدينية واستفزازها بشكل متواصل.
أنجزَ جعفر بناهي منذ صدور القرار الذي يقضي بمنعه من صناعة الأفلام عام 2010 وحتى الآن ثلاثة أفلام تُعتبر استفزازية من وجهة نظر النظام الإيراني وهي "هذا ليس فيلماً" 2011، و "ستائر مُغلقة" 2013، و "تاكسي طهران" 2015 لكن النبرة الانتقادية لهذا الفيلم الأخير عالية جداً وقد تجاوزت الحدود المتعارف عليها في مجمل أفلامه السابقة.
الشكل المُستنسخ
لا يمكن اعتبار "تاكسي طهران" فيلماً أصيلاً لعدة أسباب من بينها الشكل المُقتبَس الذي استعاره من فيلم "عشرة" للمُخرج عباس كيارستمي ونسج على منواله. فهو لم يأتِ بشيء جديد على صعيد الشكل والتقنية والمقاربة الفنية التي أمدّت الفيلم ببناء معماري رصين لم يفقد تماسكه حتى اللقطة الأخيرة من نهايته الذكية المفتوحة.
يمكن تقسيم "تاكسي طهران" إلى ستة مَشاهد رئيسة ساهمت في بناء الفيلم من دون أن نهمل المَشاهد الأخرى التي أثثت السياق السردي وأكملت الحبكة القصصية التي تُعبّر عن وجهة نظر كاتب النص ومخرجه الذي سعى في هذا الفيلم تحديداً لأن يقدِّم أنموذجاً لسينما المؤلف.
لم يبذل بناهي جهداً كبيراً في التنكّر والتمويه فقد عرفناه منذ اللحظة الأولى ولم ينفعه "الكاسكيت" الذي وضعه على رأسه أو النظارات السود التي غطّى بها عينيه الأمر الذي يدفعنا كمُشاهدين للاعتقاد بأن بعض الشخصيات التي اشتركت في الفيلم حتى وإن لم تكن مُحترِفة كانت تعرف بأن بناهي ليس سائق سيارة أجرة وإنما هو مخرج يصور فيلماً سينمائياً فهو لم يأخذ نقوداً من أي راكب باستثناء المعلمة كما أن الكاميرات الثلاث قد تمّ اكتشاف واحدة منها في الأقل وهي المثبتة في مكان لوحة عدّاد السيارة حتى وإن تصور بعض الراكبين خطأً بأنها جهاز حماية ضد السرقة! هل يعتقد بناهي بأن المواطنين لا يستطيعون تمييز الكاميرات الرقمية عن سواها من الأجهزة الحديثة بعد أن أصبحت مُتاحة للجميع تقريباً؟
ما مِن شخصية من شخصيات الفيلم كلها إلاّ وتحمل نبرة نقدية واضحة أو أن وجودها في الأقل يحيل إلى خلل ما في طبيعة النظام الإيراني القامع للحريات الخاصة والعامة. فلو كان "النشّال" حاكماً للبلد لأعدمَ شخصاً أو شخصين من اللصوص وحينما تعترض المعلِّمة الشابة على فكرة الإعدام لأنها ليست حلاً لمشكلة السرقة تثور ثائرة النشّال ليستجير بالشريعة التي تعاقب اللصوص عقوبات مروِّعة من دون أن تعالج جوهر المشكلة. ثم تُصعِّد المعلمة من نبرتها حينما تقول بأن إيران هي ثاني دولة في تنفيذ الإعدامات بعد الصين، كما أنهم أعدموا أناساً بسبب عمليات نصب وتزوير واحتيال وهي جرائم لا تستدعي الإعدام أو العقوبات المُشددة. هذه جرعة قوية من الانتقادات التي وجهتها المعلمة للنظام الإيراني لكن السؤال الأكثر أهمية هو: هل كان المخرج يعرف هاتين الشخصيتين من قبل، أم أنهما ركبتا سيارته بمحض الصدفة؟ وهذا الأمر ينطبق على الشخصية الثالثة التي تبيع الأقراص المدمجة، فأوميد كان يشكِّك بأن الشخصين اللذين تناقشا كانا مُمثلَين، وليسا راكبَين عابرَين.
أحداث مُفتعَلة
تغطي شخصية أوميد مساحة كبيرة من الفيلم حيث نراه يصوِّر وصية رجل مدمّى وقع له حادث سير على دراجة نارية بينما كانت زوجته تنتحب وتلومه لأنه لم يضع الخوذة الواقية على رأسه. يؤكد بعض النقاد بأن بناهي أراد من تصوير هذه الحادثة "المُفتعلة" أن ينتقد الإرث الذي تقرره الشريعة وتحْرم المرأة من بعض حقوقها. يكرر أوميد تأكيده، وهو على حق، بأن هذه الحادثة أيضاً مُخطط لها سلفاً وهي جزء من سيناريو مرسوم مسبقاً، وأن هذه "الألاعيب" لا تنطلي على شخص مولع بالسينما، ويتاجر بالأقراص المدمجة بطريقة غير شرعية.
تمتد سلسلة الانتقادات إلى المرأتين الكبيرتين في السن اللتين تريدان الوصول إلى "ينبوع علي" لإعادة السمكتين الذهبيتين إلى ماء الينبوع قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً وإلاّ فإن أمراً جللاً سوف يقع ويحدث ما لا تُحمَد عقباه.
ينطوي اللقاء بصديقه القديم على جريمة سرقة حدثت في رابعة النهار لكن هذا الشخص لا يريد تبليغ الشرطة وكأن لسان حاله يقول أن طهران تفتقر إلى الأمن والأمان وأن اللصوص يصولون ويجولون في طول المدينة وعرضها وأن الضحايا مخذولون ولا يحرِّكون ساكنا.
تتضاعف النبرة الانتقادية للسلطة الدينية التي تفرض اشتراطاتها الصارمة على الأفلام التي سيتم عرضها على المشاهدين. ولعل الفيلم الذي تريد أن تنجزه ابنة أخيه هانا سعيدي هو نموذج للتقيّد الصارم بالشروط التي تفرضها المؤسسة الدينية على المخرجين الذين يجب أن يحترموا الحجاب، وان لا يتيحوا فرصة للاحتكاك بين الرجل والمرأة وما إلى ذلك من محظورات معروفة لا تتهاون فيها المؤسسة الدينية. وربما تكون حادثة فتى الشارع الذي التقط عملة ورقية سقطت من عريس ميسور الحال ثيمة مناسبة للفيلم لو أن هذا الفتى قد أعاد الورقة النقدية إلى صاحبها لكنه لم يفعل فأضاع على المخرجة الشابة فكرة خلاقة تتمحور حول نكران الذات.
تبلغ النبرة الانتقادية ذروتها في لقاء المحامية والناشطة الحقوقية نسرين سوتوده التي تروم الذهاب إلى الفتاة الرياضية غونجة قوامي التي حبستها الشرطة لأنها كانت ترغب في مشاهدة مباراة الكرة الطائرة مع مجموعة من النساء حيث أخلوا سبيل الجميع ما عداها هي إذ ظلت محبوسة لمدة 108 أيام الأمر الذي اضطرها للإضراب عن الطعام والشراب. لم يقتصر حديث نسرين على الفتاة الرياضية حسب، بل امتدّ إلى حبسها ومعاناتها الشخصية في سجن إيفين. تُرى، هل كانت نسرين تعرف بأنّ كلامها يُصور في فيلم سينمائي حينما قالت لا تضع هذا الكلام في الفيلم؟ أين عنصر المفاجأة إذن؟ ولماذا سقطت أقنعة التنكّر والتمويه؟
وعلى الرغم من أن هذا الفيلم قد خطف أكبر جائزة في مهرجان برلين السينمائي "ليس لأنه فيلم سياسي شجاع فقط، وإنما لأنه عمل فني ممتاز" كما ذهب المخرج الأميركي دارين أورنوفسكي لكن من حق الناقد الحصيف أن يتساءل عن حجم التعاطف السياسي في منح هذه الجائزة الكبرى لفيلمٍ غير أصيل من ناحية الشكل، كما يعاني من ضعف في المضمون، وهشاشة في البناء الفني على الرغم من نبرته الانتقادية الحادة لنظام كلنا يعرف بأنه ثيوقراطي ومتخلف لا يُعير اهتماماً للحرية الشخصية والكرامة الإنسانية.