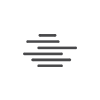لهذه المعلّقة شأن خاص بين المعلّقات، كما بين القصائد الجاهلية عموماً. ومع الإقرار بالمشتركات، إلا أننا لا نستطيع تجاوز ما يميزها، وبخاصة في تقنية القصيدة. شروح المعلقات متيسرة ورأي استاذنا طه حسين في الشعر الجاهلي معلوم معروف والأساتذة الأفاضل العرب
لهذه المعلّقة شأن خاص بين المعلّقات، كما بين القصائد الجاهلية عموماً. ومع الإقرار بالمشتركات، إلا أننا لا نستطيع تجاوز ما يميزها، وبخاصة في تقنية القصيدة. شروح المعلقات متيسرة ورأي استاذنا طه حسين في الشعر الجاهلي معلوم معروف والأساتذة الأفاضل العرب الذين درسوا ودرَّسوا الشعر الجاهلي، مروا على القصيدة وتوقفوا عندها.
سنعيد بعض ما ورد ولكن برؤية قارئ حديث لنرى المفتتح، وهو الوقوف التقليدي على الأطلال، في قسمين :
الأول الوصف لما تبقى من آثار والأسى بعد نزوح من كانوا في هذه الديار الخالية. وهذا جانب درامي ما يزال شعراء العصر بأساليب شتى يهتمون به، لكن بأفق تأمل المصير وما يعقب الحياة والوحشة التي قد تمتد لتمسّنا يوماً.
إذن لسنا أمام تقليد تقني حسب ولكنا أمام وقفة تأمل درامية فيما حدث لقوم كانوا هنا يحيون فلم تبق إلا أحجار وبقايا مواقد نيران.
الشاعر هنا يحاول إيقاظ نفسه بأمل في جانب الحياة الثاني وهو عودة الربيع بعودة سقوط الأمطار واعشوشاب الأرض وبزوغ الحياة ثانية إلى جانب آثار الفناء (أو الهجر) الأولى.
هنا نجد معالجة لليأس والموات بعودة الحياة – وفي هذا إحالة تاريخية لما استعانت به الشعوب من قبل للانتصار على الموت – تموز وعشتار مثلا :
لكن لنحاول استيعاب المشهد مما ذكَرَتْه القصيدة :
عفت الديارُ محلّها ومقامُها
بمنى تأبّدَ غولُها فرجامُها
دمن تجرَّم بعد عهد أنيسها
حجج خلون، حلالها وحرامها
إذن هذه الأرض تقع بين جبلين هما الغول والرجام وقد أضاعت الأزمنة ما فيها، هنا نعود إلى تقليد لا نتركه تقليداً ونمر، هو مواجهة للزمن الذي يحكم الناس مسراتهم وذكرياتهم، وما يرون من زوال وعبارة حلالها وحرامها، ليست موجعة حسب ولكنها تنبيه مخيف ويورث أسى يشغل الكثير من شعر العالم في الأزمنة كلها. لكن ما يؤسي الإنسان هو ما يمنحه أملاً ليواصل العيش في الحياة. هنا يعود المطر وتعود الولادات ويعود الناس وأبقارهم وتعود صفات الجمال والعيش والزرع والحب والأطفال. وفي رأيي هذا إدراك عميق للحياة وفلسفة رصينة هي آخر ما يبقى لنا من فلسفات وأفكار لنعيش ولتستمر الحياة، هي دورة الطبيعة وهو انسجام الإنسان مع ما في الكون الذي يحيا فيه.
وإذ نتابع تفاصيل الموقف، الذكرى، وكيف ظل مستَلباً ينظر للحبيبة وهي بين ناسها تغادر، فهو موقفنا جميعاً اليوم ونحن نشهد ارتحال من نحب وهدم منازل كانت وامحاء ما كنا نرى، وذكريات أعزة ارتحلوا.
فهي بعد الفجيعة نواصل السير أو نواصل الحياة، هم، أو نحن! راحت البقرة بخطوات مهزومة تتعثر على أرض هشّة ورمال مبلولة :
حتى إذا انحسر الظلام وأسفرت
بكرت تزل عن الثرى أزلامُها
وأزلامها قوائمها ...
ولم تنته المتاعب فما أن تسترسل في طريقها حتى يعود الفزع! صوت إنسان وهي معرضة للاصطياد! تهرب ووراءها السهام والكلاب ويبدأ صراع مستميت مع كلاب الصيد لتقتل ثلاثة منها الواحد بعد الآخر .. هكذا هي الحياة الصعبة المدمرة، ينتبه بعدها الشاعر لنفسه يتأمل الحياة وكم يكلف الإنسان المسعى! وهنا يعود يتأسى بالحب ثانية، ويعود يتذكر حب "نوار" الذي ضاع .
والآن، أين هي القصيدة وكيف نقرأها؟ الأستاذ د.محمد زكي العشماوي، في كتابه عن النابغة الذبياني والقصيدة الجاهلية، قدم قراءة جيدة وتفصيلية، لكنه وإن اجتهد وتوسع أكثر ممن سبقه، ظل في حدود القراءة الخارجية والوصف غير إشارات قليلة وسريعة لما هو أبعد.
القصيدة، ياسيدي، في محنة الإنسان حين يخسر أو يألم أو يضطر للارتحال لينجو أو لما هو أفضل. فيواجه في ارتحاله، في رحلة عيشه، عذابات موجعة ومخاطر يتجرع مراراتها كلها ليعيش وبعد كل العذاب والمواجهات يعود، يحنّ، إلى المكان الذي ارتحل عنه.
هذه الدورة المرة، مثلها اليوم من يهجر مضطراً وطنه للمنافي ويظل يحن للمكان الذي استاء أو تألم منه. وهي مثلما عذاباتنا في الحياة حتى إذا قاربنا الموت، صرنا نحنّ إلى أيام مضت ووجدنا فيما استأنا منه، معنى، فنحن نأسى على فقد ونحنُّ لعَوْد.
هذا هو الشعر الذي يخلد ويعمر. هو يتناول القضايا الإنسانية والوجودية المشتركة والدائمة والتي تمر بكل إنسان وفي كل مكان وكل عصر. قراءات مثل هذه نتمناها لتراثنا الشعري.
وكما استدرك الشاعر بعد تأمل الأطلال يأمل المواسم القادمة، يستدرك هنا، بانتقاله من حال إلى حال. هي حيلة شاعر في الانتقال إلى غرض آخر في القصيدة، كما هو إقرار بواقع الحياة واستمرارها. هو هنا ينتبه إلى لا جدوى التعلق بامرأة غادرت وبفروسية (ربما مصطنعة) يقول :
بل ما تذكّرُ من نوارَ وقد نأتْ
وتقطعت أسبابُها ورمامُها!
مُريّةٌ حلت بفَيْدَ وجاورتْ
أهل الحجاز فأين منك مرامُها؟
هكذا، ويمضي في سبيله وفي واقعه الجديد ونحن في مرحلة أخرى من القصيدة، التي هي في رأيي قصيدة مركبة من قصائد.
فالانتقال إلى وصف الناقة مثلما هو تقليد، نحن لا نراه مقطوعاً، وليس هو مجرد مرحلة في الكلام هو انتقل من الحبيبة التي ارتحلت إلى رفيقة في الوحشة، باقية معه، يتأسى بها فليس سواها ترافقه من طريق خال. وهذا تفسير إنساني لا أدري لِمَ فات اساتذتنا الذين يدينون الانتقال من الحبيبة إلى الناقة أو من الأطلال إلى الناقة. وقد نفسرها ببديل أنثوي تعويضي، فهي الرفيقة الوحيدة في اليباس والوحشة.
وثمة انتقالة أخرى في قصيدة الانتقالات هذه. فهو من الأتان الوحشية إلى البقرة المسبوعة التي أكل السبع ولدها، هي قصة أخرى من قصص الصراع مع الطبيعة، الصراع من اجل العيش والبقاء، فبعد الصراع الدامي وانقاذ الوليد، بعد "أن أسرعت قليلا، التفتت فلم تجده، لاتجدي النداءات الفاجعة فالولد لقي مصرعه . غفلت عنه لحظة فاهتبلته الذئاب أو السباع" (الاستاذ العشماوي). هكذا من وحش إلى وحش، من موت إلى موت، هي حياة البدوي: أي رمزية عظيمة عن حياة الشاعر وعن حياتنا!
وأنا بصدد إنهاء كلامي في هذه القصيدة، فكرت بمسألة مرت ولم أتوقف عندها. ارجأتها لأن فيها الكثير من الإشارات وأنها تتطلب فهماً أو رأياً غير تقليدي فيها.
هذه المسألة ترد حين ينتقل "لبيد" من وصف الناقة "رفيقته في الوحشة" إلى ما يماثلها، فهي هنا "أتان" تهاجمها الحمر الوحشية "وفحلها" دفاعاً عنها يتحمل العض والكدمات والضرب حتى ليتقشر جلده وهو يظل يلازمها يطرد عنها الحمر الوحشية أو "الفحول" فيضطر للنأي بها بعيداً عن الأماكن التي تتعرض فيها لمطاردة الحمر الأخرى .. ويرتفع بها إلى أماكن عالية ذات أكام وصخور.. والغريب، أو الملفت، انه يريد ان يبتعد بها عنهم وأنها كانت متمنعة متثاقلة! وهذا الذي لم يلتفت إليه أحد!
الأستاذ مصطفى بدوي يراها مقطوعة عن منطق القصيدة وفيها تناقض. والأستاذ د. محمد زكي العشماوي يرى الامتياز في التناقض وأن ذلك من سمات الإبداع، وأن في الصورتين "البقرة المسبوعة" والأتان ودفاع الفحل هو ذات الصراع من أجل الحياة، وأقول نعم هو في المجمل صراع من أجل الحياة ولكن البقرة "الأنثى" كانت تدافع عن وليدها ثم عن نفسها وهنا "فحل" يدافع عن "أنثاه"!
فشكراً لأستاذيَّ الكريمين وليسمحا لي الآن برأي : فأنا أجد قصة شخصية مضمرة تشغل الشاعر وربما تؤرقه، فهي كامنة وجدت في القصيدة فرصتها، وأنه "الفحل" اتعبته، عذبته رغباتُ آخرين بزوجته أو حبيبته أو أيٍّ تهمُّهُ فقاومهم ثم لم يستطع إلا أن يهرب بها إلى مكان بعيد ويبدو أنها كانت تلتذ برغبات أو اهتمام "الحمُر" بها، فكانت متثاقلة شبه ممانعة كما تقول القصيدة. إذاً، السؤال : لماذا هي مخالفة ومتثاقلة لا تريد مسايرته "والحمر" يريدونها؟ المفروض أن تسرع بالهروب منهم:
هناك قصة جنسية مضمرة وأنه عانى من الحمر "الراغبين" "بأتانه" وهي مرتاحة أو متلذذة برغبتهم فيها!
لا أقطع بهذا الرأي ولكني أراه صحيحا وليس شرطا أن نجد له سنداً تاريخيا، فللكثير منا ما لا يعرفه أحد.