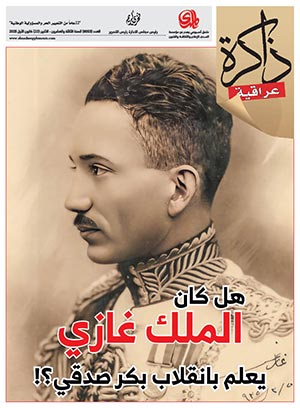معرفتي بفرناندو بيسُوا قديمة، تعود إلى أيام الدراسة في جامعة بغداد، المرة الأولى التي سمعت فيها مقطعاً شعرياً له، أنشدته زميلة لي درست الأدب الأسباني الذي أُنشأ حديثاً في كلية الآداب عام 1977، أعتقد أنهم الأساتذة الأسبان الذين نقلوا لنا الشاعر البرتغالي، ربما لأنهم ظلوا أمينين لثقافة شبه الجزيرة الإبيرية التي ضمت مع بلادهم البرتغال أيضاً؟ ربما ضاع بيسُوا مني زمناً، لكنه ما لبث أن عاد من جديد، أولاً في 1985، عندما زرت البرتغال للمرة الأولى، وثانياً، منذ أيام إقامتي الأولى في مدريد (1987 - 1990). كان شاعر الأنوات المنقسمة والإنشطارات حاضراً في أحاديث صالونات الأدب ومقاهيه، ومن يعيش هناك، لابد أن يفكر بزيارة البرتغال، لشبونة بالذات، على الأقل من أجل البحث عن الآثار التي تركها بيسُوا، فلشبونة لا تبعد أكثر من خمس ساعات بالسيارة عن مدريد. منذ ذلك الحين ما مر عام ولم أزر فيه لشبونة، خاصة في أيام الشتاء، بعد نهاية تشرين الثاني تحمل المدينة نكهة خاصة، روائح سمك الأثمار البحرية في كل مكان، فيما تبعث موسيقى الفادو "التي تغني الفقدان" صدى ميلانكولياً يختلط مع الضوء الفضي الممزوج بلون ذهبي تعكسه مياه الخليج أوقات المساء، يضيع في الأفق البعيد ويمتزج مع روائح معلبة برطوبة المحيط، كل الروائح تلك التي يصعب للزائر شمها في موانئ أخرى، رائحة البحر الممتزجة مع رائحة بُن حُمص للتو، وتبوغ ما زال يُمكن شم طراوتها، رائحة بهارات وأعشاب يابسة وأسماك مجففة، روائح تُذكر بمدن بعيدة، نامت في ذاكرة الإنسان.
في كل زياراتي للمدينة، وجولاتي الطويلة عبر أزقتها وأسواقها ومطاعمها وحاناتها، خصوصاً حانات ومقاهي لشبونة التحتية، فكرت به، بفرناندو بيسوا، من الصعب على واحد مثلي، جوال للآفاق ألا يفكر بقرابة روحية لصديق مثله؟ كنت أراه واضحاً أمامي، مثل الضوء، يتحرك بنظراته الميلانكولية، يتجول يومياً عبر شوارعها، يتنقل بين مقاهيها في الحي القديم الملتصق بالبحر، أو صاعداً سلالمها إلى حي الفاما المشهور بحانات الفادو. "طفلتي الحبيبة، صغيرتي! أنني في مارتينو دي آركادا، أنها الثالثة والنصف، وعمل اليوم قد أُنجز!" أتذكر تلك الجملة التي كتبها في رسالة لحبه الوحيد والقصير أوفيليا كيروز، وأعرف أن عمل اليوم كان بالنسبة له هو الحصول على قوته اليومي عن طريق عمله مراسلاً ً تجارياً ومترجماً في مكاتب شركات الاستيراد والتصدير في الحي القريب من الميناء "بايشا"، وما كان يكسبه لم يكن يكفي حقيقة، حتى لدفع ثمن علبة دخان. أفكر به، كيف أنه أنه عاش طوال حياته فقيراً، مؤجر ثان في غرف مؤثثة. كانت الشوارع والحانات والمقاهي هي البيت الحقيقي له، هناك واظب على قتل الوقت والجوع. أما وطنه فكان اللغة البرتغالية. وعمله الحياتي ـ بعد أن يكون قد أنجز عمله الوظيفي ـ هو كتابة الشعر. حينها كان يجلس غالباً في المقاهي. في "مارتينو دي آركادا" أو في "براكا ديل كوميرسيو"، هنا كتب العديد من قصائده ورسائله الغرامية لأوفيليا، في مقاهيه التقليدية الأخرى الصغيرة التي كان يمر بها بشكل عابر في طريق تنقله بين مكان عمله ومقهى آركادا، في مقهى ً"جاف دي أورو" و "المارتينو"، في مقهى "جيلو" و" باستيليريا ماركيز، في مقهى "لايتراريا دي جيادو"، أو في "البرازيلية" في الحي القديم "الجيادو"، المقاهى التي تحمل الكثير من بهاء القرون الماضية، التي إنقرض بعضها وبعضها مايزال، في كل تلك المرات، رأيته إلى جانبي، وأنا أصعد مدرجات شوارع لشبونة العالية، نسير سوية، ندخل مقهى أو نشتري علبة دخان، ونتحدث مع بعض عن الغربة وعن وعن حب منس وحب قادم لا محالة، عن الشعر، وعن الحياة وهي تسير قدماً وتتعثر حسب المزاج، لكنني وفي كل المرات، لم أودعه، لأنني أعرف، أنني سآتي في عام قادم إلى برشلونة وألتقي به مجدداً، وهل هناك أجمل من صحبة بيسوا.
صحبة بيسُوا
نشر في: 23 يناير, 2018: 09:01 م