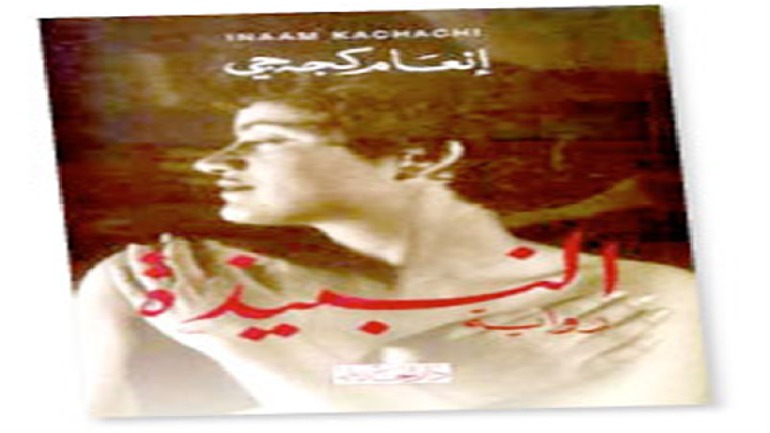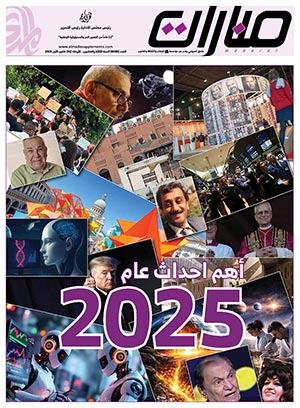درجت الروايات العراقية، بنسبة ما، على العودة إلى الذاكرة، نتيجة لسرعة المتغيرات في الحاضر، وتآكل المكان، وقلق المدينة وما تستجلبه عليها قساوة الحروب، والانقلابات، والهزات السياسية والاجتماعية. وكأن الرواية تمنح نفسها مساحة شرعية للحفاظ على الموروث الشعبي، والتاريخ غير الرسمي المستعاد في أذهان البشر. وعادة ما تتم استعادة الماضي عبر الذاكرة الفردية لأشخاص خرجوا من حرارة الحاضر، وقساوته، إلى بيئة مستقرة تنعم بالأمان وحرية الرصد والتأمل بعيداً عن أسوار المرويات الرسمية ورقابتها ومسوغاتها. وهذا ما حصل مع الشخصيتين الرئيسيتين في رواية النبيذة ( دار الجديد 2017)، وديان الملاح وتاج الملوك عبد الحميد، الأولى موسيقية والثانية صحافية.
لقاء يرتّقي في الحقيقة ثقوب الذاكرة البعيدة للإنسان العراقي.
الأولى، وديان الملاح، تستلم خيط الحكاية من تاج الملوك عبد الحميد التي عاصرت الملكية العراقية، راسمة بريشة الحلم والتأملات حياتها في بغداد الحروب، والحصار، وهيمنة الديكتاتورية، وتغول أبناء الرئيس وحاشيته وحياتهم الخليعة التي خلفت وراءها واحدة من أشد اللعنات السامة في الروح العراقية، أي الاغتراب عن الذات والمجتمع، وحملها المنفيون عن بلدانهم على مر التاريخ، سواء كانوا عراقيين أم عربا أم ضحايا بلدان أخرى. عاشت اللعنة ذاتها، لعنة الحروب والهزات الاجتماعية والانتقالات السريعة في المآسي والدموع والقهر في دخيلة كل مغترب ومنفي عن لغته، وعائلته، وشوارع طفولته.
وديان وتاج الملوك لا تتاح لهما الفسحة لاستعادة تاريخ البلد، العراق، إلا في باريس، وكانت مكاناً لنهاية رحلة شاقة حملت شخوص الماضي وأحداثه السياسية والاجتماعية والفكرية لتتحول إلى مادة جديدة على الورق. وجاء ثقل الذاكرة لدى الشخصيتين أضخم وأثقل من حركتهما في الحاضر، بالتالي كانتا أسيرتين لأرشيف متراكم منذ عقود كثيرة، يسد عليهما التواصل مع حياة أوربية جديرة أن تعاش.
وبجملة روائية رشيقة، جملة أنثوية سلسة وقصيرة، تمتزج بالشعر وومضات الفكر والأمثال والطرائف والتفاصيل، تحفر إنعام كججي في طبقات الذاكرة لشخصياتها بمعول ناعم، فتفرش تاريخ العراق الحديث الذي يظهر أبرز رجالاته ونسائه، فإذا بنا نستمع إلى الباشا نوري سعيد وهو يحلل أحداث وقته، ونطرب لصوت سليمة مراد المعروفة بسليمة باشا، ونجلس مع أبرز رسامي الجيل العراقي العائد من أوربا وفي جعبته آخر الصرعات الفنية والأفكار الرائجة من شيوعية ووجودية وليبرالية. نرى ابتسامة الوصي عبدالإله حين يستقبل زواره في مكتبه، ونجلس مثلما جلست تاج الملوك في الصالة نستمع إلى سحر أم كلثوم وهي تغني لدجلة ولياليه الندية ونساء بغداد الخارجات توا من عباءة الظلمات، ونهرول مع المتظاهرين على جسر الشهداء حيث سقط جعفر الجواهري مضرجا بدمه أثناء الاحتجاج على معاهدة بورتسموث المجحفة بحق العراق، ونسمع أخاه الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري يرثيه بقصيدته التي تحولت إلى نشيد للشعب: أتعلم أم أنت لا تعلم بأن جراح الضحايا فم. كل ذلك عبر عين، وسمع، وحواس الصحافية تاج الملوك وكانت أول رئيسة تحرير لمجلة رحاب البغدادية.
استعارة دواخل الشخصيات، الرئيسية منها أو الثانوية كالفلسطيني منصور البادي والضابط الفرنسي شامبيون والأستاذ والسفير الباكستاني، وغيرهم، أتاح للكاتبة رحلة شاسعة في الزمان والمكان، لتمر على رجالات الحكم وأهم الأحداث مرور نيزك سريع وامض، يوحي، ويرمّز، ويختصر حكاية أزمان عمرها يقرب القرن إلا قليلا. ثم يتناوب السرد ويتواصل، مرة لدى تاج الملوك ومرة لدى وديان، بضمير الأنا مرة وبضمير الغائب مرات، وهو ما نفض عن السرد رتابته، وأغناه بتنوع الإيقاع والرؤى، وهنا يقارن القارئ بين نبيذين، المعتق والجديد، ولكل منهما رائحته وطعمه ولونه.
فوديان الملاح الهاربة من جحيم الأستاذ الذي تسبب لها بالطرش تهرب نحو باريس، والاستاذ هو عدي صدام حسين وكان مشهورا بتصيّد الجميلات بعد أن أصبح مقعدا، إثر تعرضه لعملية اغتيال فاشلة في منطقة المنصور ببغداد تركته مشلولا لا يتحرك سوى بنوابض حديدية وعلى مقعد متنقل. تلك الليلة العنيفة، والفجة، والمهولة، هي التي تسببت بهجرة العازفة وديان إلى باريس عبر القنصل الفرنسي المعجب بعزفها في الفرقة السمفونية العراقية، لتبدأ حياة جديدة حسب وهمها. وكان لقاؤها بالصحافية المعمرة تاج الملوك لقاء بين عهدين، قديم وجديد، وبين تجربتين كلاهما تنتميان إلى الزمن العراقي الحديث، زمن بناء الدولة الوطنية في العام 1920 ثم صعودا نحو العقود التي جاءت بعدها.
لكن اللقاء ذاك، على أهميته للمرأتين، المنتميتين إلى الجذور ذاتها، هو في النهاية لا يمكن وصفه سوى بلقاء أشباح تتبادل الأنخاب عن عالم بعيد، وناء، وخرب، لكليهما.
تبدأ اللحظة الروائية عند العام 2011، وبداية الربيع العربي، بعد أن بلغت تاج الملوك التسعين عمرا، ثم تتراجع الكاتبة بالحكايات إلى جذورها الأولى، فلا يملك القارئ سوى النكوص معها في دهاليز ما بات يعرف بالدولة العراقية، فيتابع الرحلة استشفافا، أو تكهنا، أو استعادة.
كانت الانتقالات السريعة في الزمان والمكان لملاحقة الشخصيات ونسج الوشائج فيما بينها، قد حولت تلك الشخصيات، بعض الأحيان، إلى شخصيات شبحية، يمكنها التكيف مع أي من الظروف والأمكنة والأزمان، باكستان وفرنسا والعراق وإيران وفلسطين وفينزويلا، وكل ذلك على امتداد ثمانين عاما أو يزيد، وهو ما يجعل من الصعوبة على أي كاتب أن يضع تماسكا مقنعا للشخصيات أو الوشائج الفنية المحركة لها، وهي ظاهرة اشكالية عادة ما تشيع في الروايات المؤسسة على الذاكرة.
فالذاكرة، سواء كان ذلك سايكولوجيا أو فيزيقيا، تميل إلى الخلط، والدمج، والقفز على الزمن، والسفر الضوئي بين الأمكنة، عدا عن تشبيح الملامح، وتعرية البصمات من خطوطها. فالقصص تتوالد بعضها من بعض، كما لو أنها تحيلنا إلى أجواء ألف ليلة وليلة، وبغداد الأزل ببساطة نفوسها، وسذاجة عقولها، والحاضر القريب بعنفوانه وخنقه للأحلام والمواهب واستيلاده للكوارث والخيبات، حتى لا يعود أمامها من سبيل سوى البحث عن واحة بعيدة تلوذ إليها، عبر الماضي الذي يشبه الحاضر عادة، ألا تنسخ الحكاية نفسها مرة كمأساة وأغلب الأحيان كملهاة فجة؟