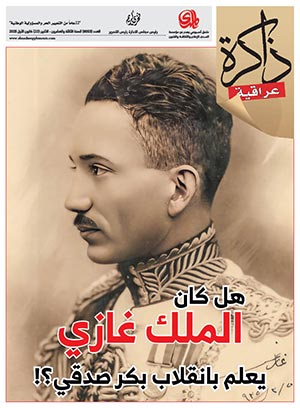فوزي كريم
من الشمس إلى الثلج. من 20 درجة مئوية إلى 7 تحت الصفر. من مناخ يألفه المغاربة إلى آخر لم يألفه الانكليز منذ زمن. لقد عدت توّاً من الدار البيضاء ومراكش. الأولى دعتني إلى معرض كتابها السنوي، والثانية أغوتني بالإقامة أسبوعاً، لم يكلف الكثير. وأكلة "الحريرة" شاهدي على ذلك. وإذا قفزت إلى السمك فهو بالغ التواضع، شأن المغربي، وسمحٌ في نفعه ومذاقه.
أقتصرت زيارة الدار البيضاء على الفندق، وعلى المعرض. وإذا أغوتني الصحبة الفتية إلى خارجهما، وأخذتني من ياقتي عنوة، أعود إلى سريري منتصف الليل، مُعلّقاً في مشجب. استجبتُ إلى حوارين أقامهما معي الكاتب (شاعر وروائي) والاعلامي ياسين عدنان. وهو نجم، خاصة بسبب برنامجه التلفزيوني "مشارف". والمشي معه مهمة شاقة، لأن المسافة التي يمكن أن تُقطع بدقائق، تمتد لنصف ساعة أو أكثر بفعل كثرة الذين يستوقفونه. في الحوارين كنت أحسده على الايجاز الدقيق لمعظم أفكاري النقدية، في تقديمه وأسئلته. في حين تتمرّغ إجاباتي في زحمة تلك الأفكار، فلا أفلت إلا وقد خلّفت فراغات تملأني بالحرج.
أحببت عمارة بهو المعرض، وتنظيمه وكثرة أطفال المدارس بين زائريه. ربما كانت شكوى الناشرين من هذا الجمهور الذي لا نفع منه إحدى مصادر هذا الحب.
في مدينة مراكش، وقد انتقلتُ إليها بعد أيامٍ أربعة، تحولت "الثقافةُ" مجسدةً في كتب للبيع في معرض الدار البيضاء، إلى "ثقافة" مُشاعة مجّاناً في حياة تدب حولك دون توقف. تراها في زهو النخيل (آخر مراحل تطور النبات، كما يرى إخوان الصفاء)، وفي لون المدينة الحمراء، وفي عمارتها التي يتحدث فيها التاريخ، معك بصورة شخصية، ببلاغة تُطربك. السماء الصافية لها سلطان، ولكن سلطانها في خدمة عمران الأرض. فالأبنية تتضح معها بصورة تستوقفك كل لحظة، لا بالحجوم الذي تستدعيها المخيلة من أساطير سومر والفراعنة فقط، بل بالأقواس العربية التي تكاد تفلت من متابعتك البصرية. وإذا سعى البُناة الفرنسيون إلى هذا فبفعل الحب وحده. لأنك لا تملك إلا أن تحب هذه المدينة الغنائية، مقارنة بالدار البيضاء. الشوارع في مراكش الجديدة خارج الأسوار لها امتدادات واسعة، ولكنها في المدينة القديمة لا تقلّ عنها، فهي تتسع بسحر الخيال إلى كل الجهات: لأن الزنقات، والجدران، وأبواب البيوت، ومحلات التجار والحرفيين، تخفي سراً، لا يكف عن دعوتك إلى العبور. وكثيراً ما تعبر، فتجد ما لم تتوقعه. إنها أحياء تُقبل عليك من التاريخ القديم. تأخذ بيدك وتختفيان. وما عليك إلا أن تستجيب، تُعينك في ذلك عامية المغربي، التي ستفتقد فهم ثلاثة أرباعها. وستحتفي بهذا الفقدان الذي سيعينك على الاستجابة، وييسرها لك. ولعل خير دليل على ما ذهبت إليه هو ساحة "جامع الفناء". فإذا لم تشأ أن تتوقف عند كلمة " الفناء"، بفعل الفزع، مع أنه فناء بمعنى الاختفاء أيضاً، فإن كل فاعلية فيها، وهي تمتد طوال النهار والليل، تأخذ بيدك كما أخذتها الزنقات، الجدران، أبواب البيوت، محلات التجار والحرفيين. إنها تخفي سراً لا تُعلن عنه، مهما أطلتَ الإقامة. لا تقف عند سر قارئة الكفً والحصى، وسر الآلات الموسيقية الوترية، الإيقاعية والهوائية، وعازفيها، وسر الحكواتي.. بل تتسع أيضاً على هواها، وكأنها رؤى شاعر تُفاجئه في كل حين.
تضمنت زيارتي لمراكش حواراً أيضاً، لم يغب عنه شخص ياسين عدنان، أقامه معهد لإعداد المدرسين باقتراح الكاتب محمد آيت العميم. المُمتع في هذا الحوار هو الحضور الطلابي، الذي أعد دفتر الإملاء مع الإصغاء، وكأنا في غرفة درس. على أن خاتمة الزيارة كانت تجوالاً مع محمد آيت العميم، وهو موسوعة في مادة مراكش المدينة، والفنان العراقي طه السبع. الذي أقام فيها منذ السبعينيات. عبر التجوال اطلعت على الكثير من لوحاته المباعة في الفنادق، والمتاحف التي كانت بيوتات مغربية مهجورة، ثم أصبحت هدف المستثمرين الأجانب الذين يتمتعون بذائقة فنية.