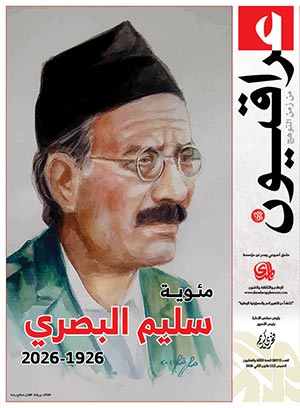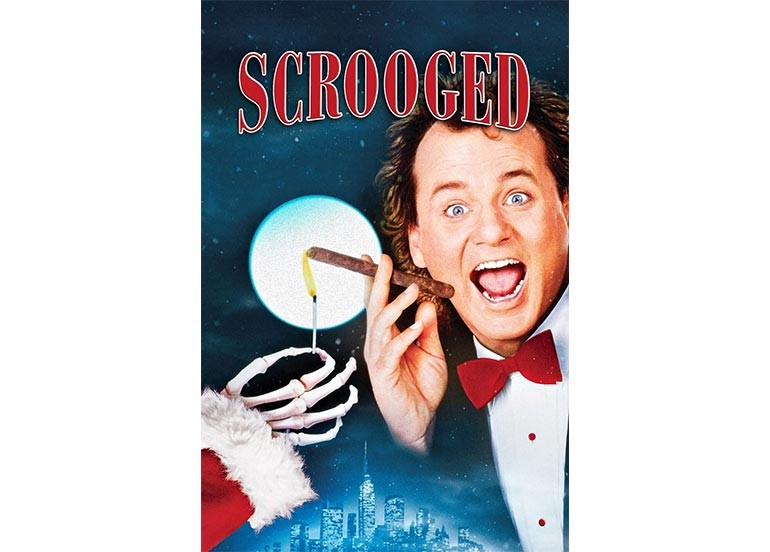أحمد الناجي
واستكمالاً لمتابعة منابت اهتمامات نوفل وافتتانه بعوالم الصورة الفوتوغرافية والصورة المتحركة، نشير الى أنه قد فتح عينيه وسط عائلة كبيرة مترفة متماسكة، يتشارك معظم أفرادها الكبار باهتمامات متنوعة،
تتوزع على مختلف ميادين الثقافة، لاسيما -الأب والأعمام والأخوال والأخ الأكبر، عاش طفولته في تلك الأجواء الحافلة محوطاً بأربعة أشقاء، وعديد من الأقارب، فضلاً عن مجايليه من الأصدقاء، يتشارك وإياهم في ممارسة تنويعات من الأنشطة والاهتمامات والهوايات والألعاب، و يحظى بالرعاية والتوجيه، فهناك أكثر من واحد يهتم به، ويجيب على أسئلته التي تصب كلها في إطار التنمية الايجابية للذات.
نشأ وسط بيئة تملك عديد من نواصي الثقافة، وكانت المكتبة التي يملكها الأب حافلة بالكثير من المقتنيات، ولكن بعضها ممنوع الاقتراب منه، ربما بسبب المخاوف من سوء الاستعمال، فهو الذي يذكر: "كنت أعرف أن لأبي كاميرا لكني لم أجرؤ يوماً على الاقتراب منها أو حتى السؤال عنها... اقتربت من الكاميرا حين آلت لأخي الكبير فعرفت أنها كوداك (رتينا)" (ص17-18).
ولابد من التنويه الى أن الأب كان ضابطاً في الجيش العراقي، يعيش سياقات الأمرة والتراتبية بحكم الوظيفة عن قناعة منسجمة مع الذات، وذلك الأمر هو الذي أدى الى انعكاس الضبط والجدية في البيت على جميع أفراد العائلة بشكل صارم، وسياقات حياتهم تسير وفق نظام وتنظيم، بل وتوجب الطاعة والامتثال، ولا يمكن الفلتان من أي توجيه بأي شكل من الأشكال، ومع ذلك فأن وجود الكاميرا وسط العائلة في مرحلة التلقي والاستيعاب، والتعامل مبكراً مع الصورة، نتاج تلك الأداة السحرية، كان له الأثر في توجيه دوافعه النفسية، وتصعيد ما هو مضمر في دواخله، وكل ما يمور من غرائز وأفكار ورغبات وأحلام الى حالة من التفجر، وقد أشار نوفل الى ذلك بقوله: "ذهبت الى الصورة كالسائر في نومه، نعم كانت خياري، لكني منذ أول الحياة عشت في بيت تشغل الصورة جزءاً منه ومن حياة شاغليه، لم تغب عني حتى اليوم صور لأبي في روما التقطت في الخمسينات"، مضيفاً ما يعتمل في نفسه من مشاعر، " كانت الصورة -واكتشفت أنها مازالت- ممري المفضي الى عوالم أخرى وحيوات أخرى. لم أتعامل معها على أنها طريقة لتجميد اللحظة من أجل العودة لها، أبداً، تعاملت معها ولم أزل على أنها الطريق المؤدي الى حياة ثانية..." (ص17).
عدم إمكانية التعامل مع الكاميرا كان أمراً بلا أدني شك مثار تطلع عيون الطفل الصغير، يولد حب الاستطلاع لديه، وتفرز هكذا حالة في الصغر تداعيات، تداعيات لها أثر في تشكل وانتاج الأحلام التي ترقد مكبوتة في اللاوعي، والحاوية على الكثير من الصور المُتخيّلة، تبقي انفعالات الإنسان دوماً على تواصل مع الخيال، ربما تأخذه الى ضفة التمرد، وقد يقفز التمرد فوق عصا الوالد، أو تشكيل ما يوازي الممنوع من المقتنيات، تعويضاً، حتى وإن كانت على شاكلة طريقة نوفل، الذي توكأ على الذكاء وقام بصناعة صندوق سحري، بدائي من الخشب مع أدوات بسيطة مأخوذة من مخلفات البيت المتروكة والفائضة، يشابه أو يقترب الى حد ما مع ما في المخيلة من تصورات عن السينما، وظيفته عرض الصورة على الحائط بعد تكبيرها الى عشرة أضعاف حجمها، دون الاهتمام بالتشويه الذي يطرأ عليها.
ويتحتم أن نعلم بإمكان الإنسان استحضار عناصر الخبرة التخيلية لاحقاً، كما يقول باشلار بواسطة الذاكرة، لاسيما في العملية الإبداعية أو عند التواصل مع المكان الأليف أو بيت الطفولة، باعتبارها صور مُتخيّلة لذكريات الطفولة الخاصة، (جاستون باشلار، جماليات الصورة، ص221).
وإن كانت الكاميرا الفوتوغرافية محظورة على نوفل والآخرين في البيت، إلا أن بقية المحتويات من الكتب والمجلات في متناول يده، والموسيقى قريبة منه، يتنفس الأغاني التي تأخذ دورها في جهاز (الفونوغراف) المعروف بـ(الجرامافون) أو الحاكي الذي يحوز على هيبة، ويشغل حيزاً مكانياً ومعنوياً في البيت، تضاءلت بعد ذلك أهميته، وأصبح قطعة أثرية، لما انتشرت آلة التسجيل الصوتي (المسجل). ولا بد من التطرق الى ما يُظهره نوفل بالاتساق مع تصوراتنا، حين ذكر: "الموسيقى مشت بجانبي دون أن أحس بها" (ص187). فقد "اعتاد أبي يحضر مهرجانات بعلبك في ستينيات القرن الماضي، يعود من هناك ومعه أشرطة عليها أغانٍ وحوارات وموسيقى" (ص181).