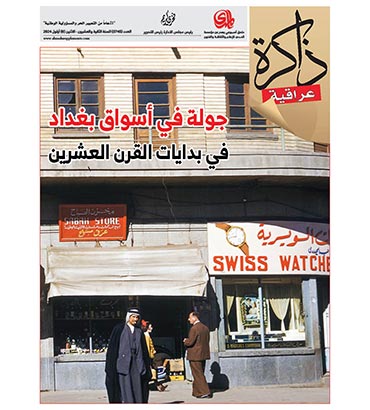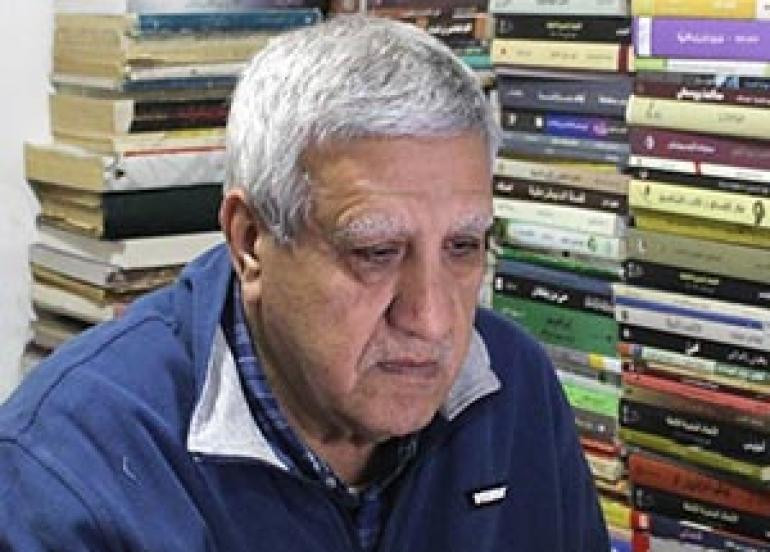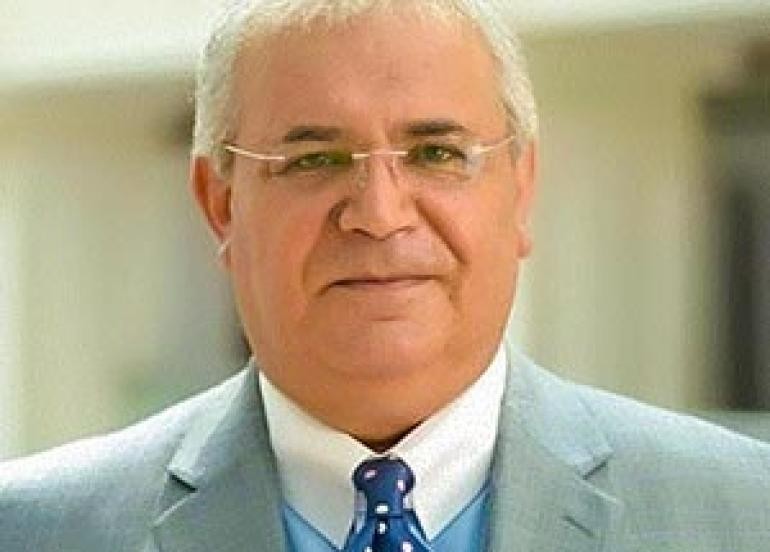ستار كاووش
لم تكن هناك طريقة للحصول على سكن جديد سوى استئجار بيت تابع لمؤسسة كبار السن، لحين إنتقالي الى البيت الذي سأحصل عليه بعد سنة أو أكثر.
كان البيت صغيراً، لذا جعلته مرسماً وبيتاً في ذات الوقت، وإنسجمتُ بسهولة مع الجيران الطيبين. لم يكن لديَّ تلفاز وقتها، لكن هذا الأمر لم يضايقني كثيراً، لأني في كل الأحوال كنتُ أستمع الى الأخبار من خلف الجدار الذي يفصلني عن جارتي التي تجاوزت التسعين عاماً، والتي كانت ترفع صوت التلفاز الى أعلى ما يمكن لأنها ثقيلة السمع.
عدتُ ذات مساء متأخراً جداً، فألقيتُ نفسي بكامل ملابسي في السرير، وأنا استعيد كلمات صديقي قاسم الذي قال لي ذات مرة حين رآني في حالة مشابهة (كنتُ أظن أن كمال الشناوي هو الوحيد الذي ينام ببدلته بعد السهر في الأفلام!). غطيتُ في نوم عميق، لأصحو فجأة أثر سماع صوت غامض ملأ غرفة النوم، كان صوت إمرأة، هذا أكيد، فتفحصتُ الغرفة جيداً، لكني لم أرَ شيئاً ولم أعرف من أين إنبعثَ هذا الصوت، لم أكن أحلم، أنا متأكد من ذلك. حاولت العودة الى الفراش، فإذا بالصوت يخترق هدوء الغرفة من جديد، وهذه المرة كانت الكلمات أكثر وضوحاً (هل أنت بحاجة لشيء؟) فركتُ عَينَيَّ محاولاً إزالة تأثير السهرة، لكن الصوت عاد للمرة الثالثة، وهنا وقفتُ أتحدث للصوت وأنا أفتش الغرفة (من أنتِ، وماذا تريدين؟) عندها خفت الصوت قليلاً وهو يصل مسامعي (أنت من عليه إخباري، ماذا تريد أو تحتاج؟ فقد ضغطت على الزر الصغير الموجود فوق السرير طَلَباً للمساعدة، أنا الممرضة ساسكيا، وأعمل في هذه المؤسسة التي تعيشَ فيها، ومهمتي الإعتناء بكبار السن، فهل بإستطاعتي تقديم شيء لك إن كنتَ بحاجة للمساعدة؟) وهنا تبددت المفاجأة وأنا أنظر الى الزر الصغير الذي لم أنتبه له سابقاً، لأقول لها (يبدو أن هناك خطأ غير مقصود في الموضوع، لاشك أني قد مددتُ يدي سهواً وأنا نائم نحو هذا الزر غير المتوقع، أو ربما كنت أحلم وحركتُ يدي أثناء النوم، عموماً شكراً لك، واعتذر عن الإرباك الذي حصل، انا لست بحاجة للمساعدة، وفوق هذا أستطيع تقديم أية مساعدة، ان كنتِ بحاجة لذلك) فتناهت لي ضحكتها الحانية التي تناغمت مع كلمات من قبيل طاب صباحك، وأقفلت الخط.
بعد بضع ساعات من ذلك أزلتُ الزر من مكانه وأغلقتُ الفتحة الصغيرة التي خلَّفَها على الجدار، وأنا أردد مع نفسي (رغم رقة صوتها، لكني لستُ بحاجة الى مثل هذا الزر قبل مرور ثلاثين سنة على الأقل!). أحضرت القهوة ووقفتُ ممسكاً بفنجاني قرب النافذة أتأمل البناية المقابلة، حيث تعمل تلك الممرضة، وفكرتُ أن أرسم شكلها من مخيلتي على واحدة من لوحاتي الجديدة.
عند انتصاف النهار، حملتُ حقيبتي على ظهري ونزلتُ السلم الحديدي الصغير المؤدي الى الباحة التي تطل عليها بيوت المجمع الذي أسكن فيه، لغرض أخذ دراجتي الهوائية والذهاب للتسوق، وبما أن كل جيراني كانوا كباراً في السن، لذا وجدتُ عند نهاية السلم أربع (شابات) تتراوح أعمارهن بين الثمانين والتسعين سنة، يقفن بمحاذاة صندوق البريد خاصتي، حيث كانت تتكئ دراجتي الزرقاء، وكُنَّ منشغلات بالحديث عن العلاقات بين الجيران، وعند إقترابي منهن مددتُ رأسي نحوهن قائلاً (نهاركن بهيج ياسيداتي الجميلات) وبالكاد رددن تحيتي بإبتسامات أظهرت أطقم أسنانهن البيض، لأفاجئهن بمزاح، متسائلاً وأنا أتظاهر الجديَّة (في الحقيقة، منذ بضعة أيام وأنا أبحث عن موديل، هل تتبرع واحدة منكن بالجلوس لي كموديل عارِ؟) وبما إنهن قد تعودن على مزاحي هذا، لذا قهقهن ضاحكات وهن يضعن أيديهن على أفواههن وينظرن الى بعضهن بإنشراح مبطن، وقد لمحتُ بريق سعادة عابرة تلتمع في عيونهن، ولم تمر سوى بضع ثوانٍ حتى قالت إحداهن وهي توجه كلامها للأخريات (هذا ما تحصلين عليه حين يسكن بجوارك رسام غريب الأطوار!)، لتكمل الأخرى وهي تنظر اليَّ بعد أن اتكأت على عصاها(إذهب في طريقك ايها الولد الشقي، ودعنا نكمل حديثنا) فرفعتُ يديَّ الى الأعلى دليلاً على الإستسلام، وركبت دراجتي بإتجاه سوق المدينة.