لطفية الدليمي
منذ سنوات وأنا دائبة البحث والتفكير في موضوعة محدّدة : لماذا يتّخذ الدين عندنا شكل المنظومة اللاهوتية ( أو الفقهية تبعاً للأدبيات الإسلامية ) بدل أن يكون نسقاً ثقافياً ضمن أنساق عدّة ؟
ولماذا يرادُ للدين أن يكون نسقاً إعتقادياً مقفلاً في فضاء مجتمعي لايستطيبُ مناقشة الأفكار حتى لو جاءت في سياق منظومات توصفُ بالمقدّسة ؟ وقبل هذا وذاك : لماذا صارت خبرتنا الشخصية والجمعية في بيئتنا العراقية ( والعربية إلى حدود تتمايز عن الحالة العراقية ) مشحونة بذكريات تطفحُ بالمرارة كلّما تناهت إليها أية إشارة إلى الدين والجماعات الدينية على إختلاف ألوانها ؟
كانت مقاربتي لهذه الموضوعة شكلاً من أشكال الفضول الفكري العام منذ عقود بعيدة عندما كان العراقي يمتلك فسحة من الأريحية الفكرية تتيحُ له التفكّر في موضوعات ثقافية عامة قد تكون بعيدة عن تخصصه الجامعي أو مهنته في الحياة ؛ لكنّ هذا الفضول إنقلب تساؤلات ملحّة وبخاصة بعد أن تمّ توظيف الدين سلاحاً آيديولوجياً في الحرب الباردة (ظاهرة المجاهدين العرب في أفغانستان على وجه التحديد)، ثمّ تتالت الوقائع المضمّخة بالدماء والتي جعلت مساءلة الدين (في شقّيه الإعتقادي والمؤسساتي) أمراً ذا أهمية حياتية فضلاً عن أهميته الفكرية وراهنيته المؤثرة دوماً في تشكيل حياتنا.
تعمقت مواجهتي الثقافية الأولى مع موضوعة (الدين نسقاً ثقافياً) إثر قراءتي في سبعينيات القرن الماضي حوارية مدهشة بين عالم الإجتماع والأنثروبولوجيا البريطاني المعروف كليفورد غيرتز Clifford Geertz واللاهوتي الألماني بول تيليتش Paul Tillich(ترجم له الأستاذ سعيد الغانمي كتاباً ممتازاً بعنوان بواعث الإيمان)، ثمّ قرأتُ معظم كتب البروفسور غيرتز كجزء من إهتمامي الكبير بعلم الإجتماع الأنثروبولوجي والثقافي ولكوني أتفق مع الرؤية التي مفادها أنّ مجمل مبحث الإنسانيات يمكن دراسته وبحثه (بل وحتى إشتقاقه) من علم الإجتماع الثقافي، أشيرُ بشكل محدّد إلى الفصل الرابع من كتاب غيرتز المعنون (تأويل الثقافات Interpretation of Cultures) الذي ترجمه الدكتور محمد بدوي وصدر عن المنظمة العربية للترجمة عام 2009، كما أشيرُ إلى الفصل السابع عشر من الكتاب الموسوعي (علم الإجتماع) للبروفسور أنتوني غيدنز Anthony Giddens، الذي ترجمه الدكتور الراحل طيب الذكر فايز الصياغ وصدر عن المنظمة العربية للترجمة عام 2005، أرى أن هذه القراءات المقترحة عظيمة الأهمية في تمهيد الأرضية الفكرية لدراسة موضوعة (الدين باعتباره نسقاً ثقافياً).
لم يعُد شيئاً غريباّ في العالم الغربي أن يتمّ التعامل مع الدين كنسق ضمن مثلث نسقي (العلم، الفلسفة، الدين) على أن تكون معلومةً شروط وحدود التداخل الممكن بين هذه الأنساق الثلاثة وبما يؤدي إلى تنشيط التعشيق الثقافي بين هذه الأنساق وعدم تطفلها على الفضاء المفاهيمي لكلّ نسق بينها ؛ إذ لم يعدْ مقبولاً أن يقدّم الدين - مثلاً - رؤية إزاء موضوعة علمية بكيفية توحي بنوعٍ من علوية الدين على العلم، هذا لم يعُد مقبولاً أو مستساغاً أو منتجاً. هل يمكن أن نتوقّع رأياً للكنيسة (كاثوليكية أو بروتستانتية أو أي من الكنائس السائدة في العالم الغربي) في كيفية معالجة الجائحة الكورونية الحالية؟ أبداً. هذا ليس من إختصاص النسق الديني الذي تمثله الكنيسة والأفراد المتديّنون بأيّ شكل للتديّن، وفي المقابل ثمّة إحترام فكري متبادل لدور كلّ نسق ثقافي من هذه الأنساق الثلاثة لبعضها وتأشيرٌ صارم لمناطق فاعليتها وتأثيرها في الحياة من غير قسر أو ترويج دعائي ذي نبرة عدوانية تجاه النسق الآخر، ومن غير توظيف آيديولوجي لمؤسسات الدولة في شنّ حروب عقائدية بين هذه الأنساق الثلاثة. قد يحصل إختلال أحياناً وهذا أمرٌ متوقّعٌ في كلّ المناشط البشرية ؛ لكنّ صيغة التفاهم والإحترام المتبادل تبقى سائدة، ولكلّ فردٍ في نهاية الأمر رؤيته وقناعته المحكومة بضميره وميوله الثقافية وتكوينه البيولوجي (ثمّة مؤثرات ثقافية تسمى ميمات Memes تعززت القناعة بأنها تشابه وظيفة الجينات لقدرتها على نقل التشكّلات الثقافية المرجعية " اللغة، العادات والتقاليد، نمط التعامل مع البيئة،،،" بين الافراد).
سأحاولُ في الفقرات التالية بيان أهمّ الأسباب التي تعيقُ إمكانية تحوّل الدين لدينا إلى نسق ثقافي يتبادل التأثير المنتج مع الأنساق الثقافية الأخرى بدلاً من إنكفائه وتمركزه على نواة عقائدية صلبة ومغلقة:
- رسوخ فكرة المرجعيات الحاكمة في مجتمعنا:
تلعب المرجعيات دوراً حاكماً في مجتمعنا العراقي، قد تكون المرجعيات الدينية أكثرها سطوة ؛ لكنّ الواقع يخبرنا أنّ المرجعيات تنشأ لدى الفرد إبتداء من سنوات نشأته الاولى داخل منظومة العائلة التي يسود فيها مثال الأب / الحاكم كلي السطوة، ثمّ تبدأ سلسلة المرجعيات المؤسساتية الحاكمة: المدرسة، الجيش، المؤسسة الوظيفية، مؤسسات الدولة،،، إلخ، ربما تكون بعضُ بواكير فكرة الليبرالية " المنضبطة " في العراق قد بدأت مع أربعينات وخمسينات القرن الماضي الذي شهد ولادة حركات ثقافية ثورية على صعيد الفن والعمارة والأدب ؛ لكنّ هذه البواكير الاولى تمّ وأدها بقسوة في العهود السياسية اللاحقة التي تسيّدت فيها العسكرتاريا الفظّة، وحدها ظلت المرجعيات الدينية تتكئ على سطوتها الإعتبارية المستمدّة من المقدّس الديني حتى لو كان يتحرّك داخل إطار المخيال الفلكلوري الشعبي.
- طبيعة المنظومة الإعتقادية:
يمكن تفكيك هذه الظاهرة ببساطة بالنظر إلى الحقيقة التالية: المسيحية في جوهرها هي لاهوت + أخلاقيات ؛ وعليه يمكن كخطوة أولى باتجاه تشبيك الدين مع الأنساق الثقافية الأخرى تحييد اللاهوت والعمل في منطقة الأخلاقيات وحدها. نجحت هذه الستراتيجية مع المسيحية بل وتعدّت فضاء الأخلاقيات نحو مساءلة الثوابت اللاهوتية المسيحية وتناولها بطريقة مختلفة تماماً عن السائد المألوف. هل يمكن أن يحصل الأمر ذاته مع المنظومة الإعتقادية الإسلامية؟ لاأظنّ ذلك للسبب التالي: الإسلام هو لاهوت (بمعنى منظومة إعتقادية) + أخلاقيات + فقه (بمعنى الجهد التأويلي للنصوص المقدّسة)، وفي الفقه تكمن العقدة الكبيرة ؛ إذ ليس من المتوقّع أن يتوجّه الفقهاء نحو مقاربات تأويلية تعزّز مساحة الإشتباك النسقي الثقافي بل غالباً مايحصل الإنكفاء في جزيرة فقهية منعزلة، سمعتُ مرّة أحد العراقيين يتحدّث عن الرئيس الفرنسي ماكرون بعد حديث الأخير عن الإسلام، عندما نتعامل بمنطق واقع الحال سنتفهّمُ أنّ من حقّ الرئيس الفرنسي الحديث عن الإسلام لكون (كذا) مليوناً من المسلمين يقيمون على أراضيه وبالتالي يشكّلون قوة مؤثرة لها تبعاتها على المؤسسات الفرنسية والدولة الفرنسية بأكملها، لم يلجأ هذا الرجل إلى لغة الخطاب الهادئ الرصين بل قفز فوراً إلى لغة إستعلائية فقال: كيف نسمحُ لهذا " الأغلف " ماكرون أن يبدي رأياً بالإسلام؟
هل هذه لغةٌ تسمحُ بولادة أي نسق ثقافي مع الآخر المختلف في هذا العالم؟
- بلادة منظومات التعليم:
تمثل منظومات التعليم لدينا وجهاّ آخر من أوجه التكريس المرجعياتي بدلاً من أن تكون أماكن حقيقية لتنشئة عقل مدرّب على المساءلة والفضول المعرفي. تكمن بلادة منظومات التعليم في تناقض ثنائي متلازم: إعلاء شأن الاصولية الدينية والسياسية من جانب، وفقدان دور المزوّد الحقيقي للمعرفة المنتجة، وهكذا فهي تلعب دوراً مزدوجاً شديد الخطورة عندما تتخلى عن دورها في تعليم اللغات والفلسفة والتطورات الحديثة في العلوم والرياضيات والثقافة المعاصرة وتلجأ نحو التكريس الآيديولوجي على مستويات عدّة.
- غيابُ العقل الفلسفي:
الذائقة الفلسفية التي يحرّكها عقل فلسفي مدرّب على مساءلة الثوابت في كل جوانب الحياة هي ذائقة لازمة لتحقيق تثوير حقيقي في الإنجاز العلمي والتقني وولوج بوابة إقتصاد المعرفة وعتبة الثورة التقنية الرابعة، ومن ثمّ - وبالتبعية المحتّمة – خلق عقل يستطيبُ إستكشاف الثقافات العالمية والترحّل بينها وعدم الإنكفاء في حيّزٍ لاهوتي مصبوغ بلون ثقافي آيديولوجي واحد.
إنّ الملاحظ في بيئتنا العراقية بالتحديد (البيئة العربية في بعض البلدان العربية أفضل حالاً من العراق بكثير) هو غياب التنشئة الفلسفية في مراحل ماقبل الجامعة، ثمّ حتى لو حصل أن درس بعض الأفراد الفلسفة في الجامعة فإنّ الأدبيات الفلسفية السائدة فيها تتموضع في شكلين معروفين : فذلكات تأريخية أقرب إلى الهوامش الخاصة بتدوين الوقائع التأريخية الخاصة بفلسفة معيّنة، أو فلسفة تتصادى مع بعض جوانب تراثنا الذي ماكانت فيه الفلسفة سوى شكلٍ مضمر من الدرس الفقهي وعلم الكلام حتى باتت الفلسفة لدينا أقرب إلى رطانات فقهية.
لن تكون الفلسفة لدينا عامل تحفيز لزيادة رقعة الإشتباك النسقي الثقافي مالم تحصل (قطيعة إبستمولوجية) بينها وكلّ الزوائد الفلسفية البالية في تأريخنا الثقافي عبر تعشّقها مع الثورات الحديثة في اللغة والسايكولوجيا الإدراكية والمنجزات التقنية الثورية.
- تخلّف البنية التحتية للثقافة العلمية والتقنية
العلمُ عندنا ليس سوى بناءٍ فوقي Super-Structure قوامه كلمات مسطورة في كتب – مدرسية على الأغلب – يقرؤها الطلاب ليحوزوا مراتب مهنية تدرُّ دخلاً عالياً، مهنٌ راقية كما يسمّونها، العلمُ عندنا ليس سوى سُلّمٍ موصل لوظيفة وليس ثقافة جمعية ترتقي بواقع الحال بخطوات عقلانية محسوبة، هنا يتقافز سؤال ستراتيجي أمامنا: لماذا صار الأمر على هذه الشاكلة؟ قدّم - وسيقدّمُ - منظّرو التنمية وصُنّاع السياسات الاقتصادية وخبراء الامم المتحدة الكثير من النماذج والتسويغات عن معيقات التنمية في منطقتنا العربية ؛ لكنّ التسويغ الاكثر معقولية وقرباً من أرض الواقع هو أنّ العلم لايصنع الثروة عندنا بل يبقى محض عبارات فوقية غير مؤثرة في تشكيل حياة جديدة وصناعة موارد مستجدّة غير مطروقة لخلق الثروة مع مايستلزمه هذا الأمر من توطين خبرات جديدة، وتثوير نظم التعليم ، وإشاعة رؤية جديدة للأنساق المجتمعية، وتفكير جديد بشأن كيفية إعادة توزيع الثروة طبقاً للكفاءات والمجهودات الحقيقية.
إذا كان الحال عندنا على هذا النحو من الطفيلية الريعية ؛ فهل لنا أن نتوقّع من يفكّرُ في إمكانية توظيف العلم والتقنية لزيادة مداخيل الثروة ومايستتبعُ هذا الأمر من تغيير بنيوي في العقل وطبيعة الحياة التي يعيشها الناس؟ للأسف ساهم الريع النفطي في تكريس الأصوليات الدينية والسياسية والمجتمعية وانغلاقها تجاه الآخر، وصار الدين سلاحاً يتظافر مع الريع النفطي في تكريس نمط المغالبة على المال والسلطة وإهمال الشأن الثقافي، و تكريس سياسة الانغلاق على الثقافات العالمية.
- أخدوعة تعايش العلم مع اللاهوت الديني:
معروفةٌ تلك القرون الصراعية التي شهدت إحتراباً فكرياً عظيماً بين العلم في بواكيره الأولى و السلطات الدينية الممثّلة في المؤسسة الكنسية وأنساقها اللاهوتية الراسخة، وقد خسر الكثير من العلماء حياتهم - أو حرّيتهم الفكرية في أقلّ التقديرات -، وتطلّب الأمر قروناً من النضال الفكري حتى بلغنا حالة حصل فيها - في الغرب بخاصة - نوع من الإعتراف بفصل الأدوار بين الأنساق اللاهوتية والأنساق العلمية، وتطوّر الأمر حتى بلغنا مرحلة الدولة المدنية المحكومة بقوانين إنسانيّة تُعلي الشأن البشريّ بعيداً عن التصوّرات الأخروية.
ليس ثمّة من إمكانيّة للتعايش القسريّ إذن بين العلم واللاهوت، وهنا يمكن الإشارة إلى قضية شديدة الأهمية في هذا الجانب وهي إمكانية بقاء كلّ من العلم واللاهوت ماكثاً في فضائه الخاص وضمن هياكله المؤسساتية من غير تأثير مباشر أو غير مباشر من جانب اللاهوت على المؤسّسة العلمية أو بالعكس. يمكن التعايش بشرط إنتفاء صفة القسرية في هذا التعايش على الطريقة الملتوية التي يُشيعُ بها بعض الأساتذة ذوي التوجهات الإسلامية الأصولية تأويلات في غاية الرثاثة لبعض النصوص القرآنية بغية جعلها تنساق قسراً للرؤى العلمية الراهنة، والأمثلة في هذا الشأن كثيرة، وقد ساهمت في إشاعة نمط من الأصولية الثقافية المعادية لأي إنفتاح ثقافي.
* * *
الموضوع واسع وينطوي على مؤثرات أخرى كثيرة، منها مثلاً: إنكفاء جهد الإصلاح الديني في المنطقة العربية، وأننا كنا بيادق في لعبة الحرب الباردة، وسيادة الفهم الفلكلوري الشعبوي لمفهوم العلمانية، وإلتباس فكرة " الأخلاقيات " والوهم السائد بأنّ الأخلاقيات صناعة دينية وليست إختيارات شخصية مسنودة بدوافع من خارج الفضاء الديني، وتغوّل الأصولية "العلموية" في مقابل الأصولية الدينية بدلاً من إقامة حوارات مشتركة تُنضَّجُ مفاعيلها على نار هادئة، وطبيعة الشخصية العراقية والعربية التي تميلُ إلى الحسم واليقينية القاطعة بدلاً من التشكيك والمساءلة ومحاولة فهم الظواهر بعيداً عن مرجعيات مسبّقة، شيوع الفكر المؤامراتي الذي يظن بأن أي انفتاح ثقافي على العالم ينطوي على مؤامرة يُراد منها نزع الروح الجهادية عن الاسلام لترويضه وتعطيل مكامن القوة "المفترضة " فيه.





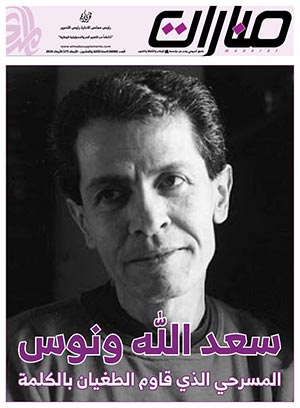





جميع التعليقات 1
Anonymous
كلام منطقي ولهجة تنهج للبناء الصحيح لمن يةد سماع والاصغاء لهذه الافكار النيرة. بوركت الاستاذة لطيفة بفكرها لبناء مجتمعي سليم وقوي والف شكر ..... د. عادل مكية / الولايات المتحدة الأمريكية