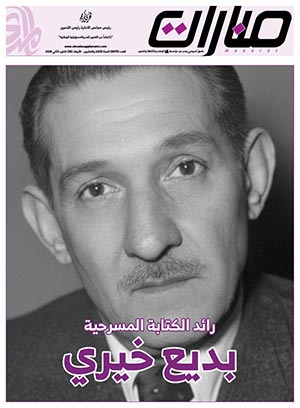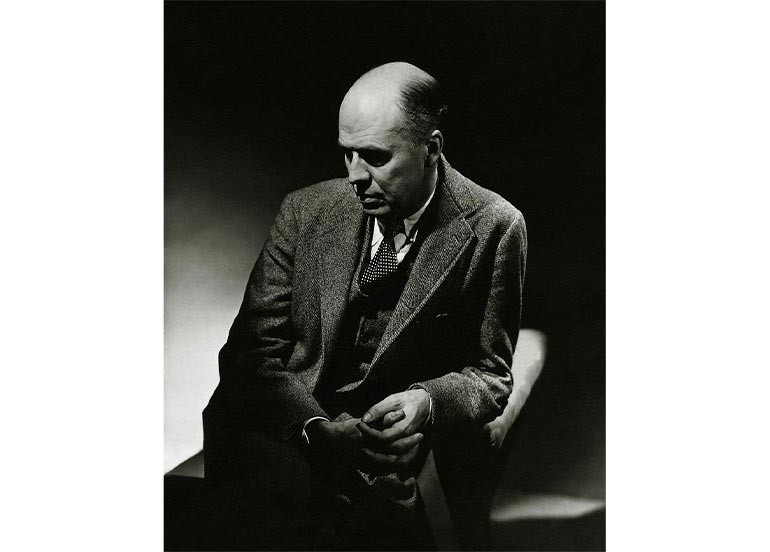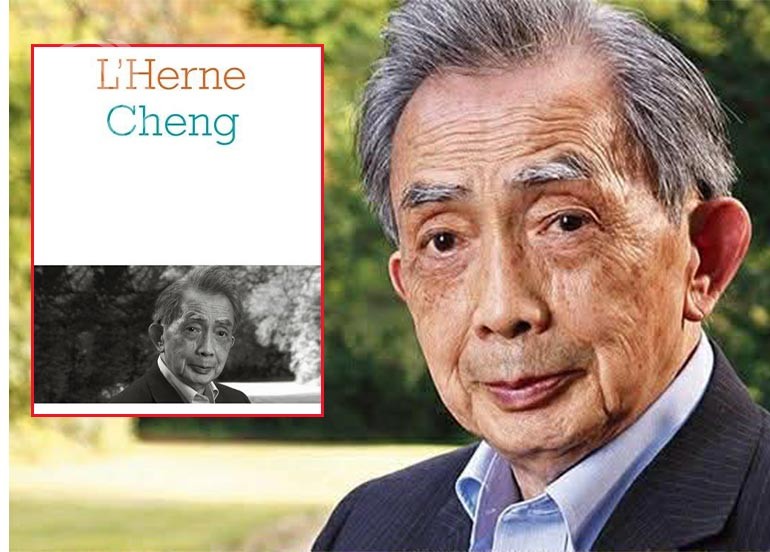جمال العتّابي
عناصر بناء اللوحة الأساسية المتمثلة ب( التكوين، المنظور، الظل والضوء)، تلك المفاهيم ماكنت لأستذكرها، لولا إن من أيقظها من غفلاتها،
هو تأمل هذا العمل الفني لوحده، لفنان تشكيلي مقيم في بلدان الغرب، ليس مهماً أن نعرف إسم الفنان، لكن المهم أن نعرف انه قطع رحلة العمر كلها، مؤكداً حضوره الفني الحي، متواصلاً مع الرسم، بما توفرَ له من إمكانات ومهارات عالية، ليكون (أسطة محترف) في هذا الحقل الإبداعي، مضى بتجربته وخبرته التشكيلية، شوطاً نالت إهتمام النقاد، والدارسين المتخصصين في التشكيل. وبغض النظر عن كل ماكتبه هؤلاء الأصدقاء، وهو موضع تقديرنا وإعتزازنا ، مثلما هي تجربة الفنان ومسيرته الشخصية الفاعلة في إطار الحركة الإبداعية، التي تميزت ببناء عالمها الخاص، الذي يحمل سمات شخصيته الواضحة، وهي تحكم الصلة بين لغة مرمّزة، وأخرى مشهودة بخصوصيتها، ومع ان النظرة العابرة لايمكن أن تستقصي كل أبعاد أعماله ، فأن لوحة ما خارج هذا السياق، تستوقفنا، لخلل بنيوي في تكوينها، يصعب على المشاهد العابر إكتشافه، وهي مفروشة بعناية تامة، وذكاء، على أرضية منظوراً إليها بعين الرسام، لذا يلزم الناقد مهمة، تفكيك اللوحة، ومعالجة الإشكاليات الواقعة فيها.
إن أولى المسلمات في تنفيذ اللوحة، هي مراعاة عدم الفصل بين عناصرها الأساس، لأنها عناصر متلازمة مدروسة، وتأملها بعين المتبصر، لا عين الباحث عن تسلية، سندرك وجود أكثر من خلل في عناصر اللوحة، يتمثل في التكوين أولاً، بمعنى غياب التوازن، والتناظر بين كتلتي العمل ، يساراً، ويميناً، فالرسام لم يوظف طاقته الفنية المختزنة في معالجة الفراغ على اليمين، بما يوازيه بالكتلة المزدحمة بالأشخاص على اليسار، فهو الأقدر على الإبلاغ والمكاشفة، وتحريك المضامين، بما يمتلكه من مهارات ورؤى، مؤهلة للتعبير عن الشكل بطريقة متوازنة ومقبولة.
الخلل الثاني في اللوحة، هو المنظور الذي فقد خاصيته هنا، كان على الرسام أن يحسب بدقة المسافات بين القريب والبعيد، ومراعاة القياسات والابعاد، في الوجوه، التي بدت للمشاهد بحجم واحد، وفي غاية التقارب، وثمة ملاحظة تتصل بمشهد الوجوه، انها كانت مشتتة النظرات، كل واحدة منها تبحث عن شيء، في إتجاه مختلف، وشارد، تأخذ بعضها الحيرة، وبدون إنفعال، وغالباً ماتكون غير مفهومة.
إن دقة العمل، والإلتزام بعناصره الأساسية، يفسران طبيعة التدابير الفنية، ومقاساتها الصحيحة، وبالتالي وجوده المؤثر فينا، بل صداه في حواسنا وآلاتنا البصرية، انها مغامرة غير مأمونة، تضع قوانين الرؤية جانباً، وتذهب نحو خداع المتلقي، بأناقة الألوان الترابية وتدرجاتها، (القهوائي)، في خلفية اللوحة التي تنتمي إلى المدرسة الكلاسيكية، أو ما تعرف بمدرسة فلورنسا، التي تعود إلى خمسة قرون خلت، لألوان هذه الفترة قدرة على ان تسحر المتلقي، دون إنتباه من الرسام إلى ان ملابس شخوصه، لا تنتمي إلى ذاك العصر، انما هي ملابس عصرنا الحالي.
، وحيال هذه المؤشرات، إستوقفنا الإرتباك الثالث في اللوحة، أو الإشكالية الأخرى المتمثلة بمصدر الضوء، فالمتأمل للبيت البعيد في أفق اللوحة، يدرك ان المصدر قادم من جهة اليسار، الا ان واقع اللوحة مصمم على خلاف هذا الإفتراض، فإختلف الضوء بين كتلة وأخرى دون عناية بالمصدر، صورة الغزال تعطي إنطباعاً لحالة التشتت التي لم يلتفت لها الفنان كما يبدو،
إن الرسم كما يقول الفنان التشكيلي الفرنسي (أدغار ديكا 1834-1917)، ليس إثبات الشكل، بل هو الكيفية التي نرى بها الشكل، وعلى هذا الأساس، لم يضع الفنان في الإعتبار أن يعالج التوازن القلق، في اللوحة، على الرغم من إستعانته بجهاز الفانوس في التكبير، واستخدام الكولاج لحركتين مختلفتين في لقطة الرجل وهو يسكب الماء، ونفسه واقفاً إلى أقصى اليسار، ان المآخذ السلبية على إستخدام هذه الوسيلة، في تكبير الصورة، تأتي حين يغيب الإيقاع المنظم بين الحالتين، في اللون، والوضوح، والحركة، والظل والنور، والخط والكتلة لذا تأتي النتائج رهن تقييمات متعددة ومتباينة. وغالباً مايقع الفنان في أخطاء، بسبب الإستخدام غير الموفق للفانوس.
أحسب ان هذه القراءة ستثير عدداً من التساؤلات، لدى الكثير من القرّاء، وبالأخص عند الفنانين التشكيليين، وسيقف البعض منهم بالضد من الآراء المطروحة، وربما يصعب على البعض الآخر قبول وجهات النظر الواردة في التقييم، وعلى الأغلب ستكون التساؤلات حول حرية الفنان في العمل، وإختيار اسلوبه، وحقّه في العيش، وستذهب الإعتراضات بعيداً نحو: أليس من حق الفنان تطمين حاجاته الإنسانية؟ وأكثر من ذلك، أليس هذا الرسام(أشرف) من اؤلئك مزوري الاعمال الفنية، ومهربيها؟
لذا سأختزل الإجابات، معكم أيها الأصدقاء، لأقول : نعم! من حق الفنان أن يعيش، ويأكل، ويشرب، ويجد له مأوى يليق به لينتج، ويبدع بحرية ورفاهية.
لكن حين يفقد العمل الفني مهمته الإبداعية، ويندفع بإتجاهات يغلب عليها الطابع (التجاري)، وقتئذٍ تتراجع القيم الجمالية إلى الوراء، ويتحول الفنان إلى أداة تسهم في التلوث البصري، ومهمة الرسام ليست هكذا، انه راصد أنساق، ورموز، ورسام تكوينات مثيرة ومقلقة، بمخيلة واسعة لاحدود لها، وبلغة لونية ساطعة. ونحسب كذلك ان العمل الفني ينبغي أن يكون متطابقاً مع أفكار الرسام، وصدقه الفني، وحواراته وتأملاته مع الذات واللون.
ربما في صورة أو لوحة، أو معرض تشكيلي، مشاهد تريق دفقاً من الأنوار والجمال، كما فعل الموسيقار الروسي(موديست موسورجسكي 1839-1881)،الذي يعدّ أحد الموسيقيين الخمسة المجددين، إذ أثارت لديه أعمال صديقه التشكيلي والمعماري الروسي (فيكتور هارتمان 1834 - 1873)،في معرض إستعادي لرسوماته، جملة من الأحاسيس والأفكار، فألّف عملاً سمفونياً من خمسة عشر حركة، تمثل كل واحدة منها، خلاصة لتأمله في لوحة من اللوحات، فكانت الموسيقى مذهلة بتوازيها مع لوحات هارتمان، وبنفحة من روح عصره، ومن أكثر أعماله الإبداعية عرضاً، وأجملها وأنقاها، لذا يستحق أن نطلق عليه لقب (ملوّن النغمات).
ان مسؤولية فنية وثقافية تواجهنا، في تأصيل الأعمال الجادة، والإتجاه نحو المحتوى العميق، في العمل الإبداعي، والمعاودة الحرة لقيم الجمال، هذا البحث هو شاغل المبدع، وسرّه الخفي الذي يواجه به العالم، وهو مايدعو الكاتب الفرنسي (أندريه موروا 1885 - 1967) إلى التساؤل : لماذا نجمّل المنازل والمباني، مادام يكفينا منها أن تكون ملجأً أوسقفاً؟ ، ليكون جوابها تفسيراً لموقف الإنسان من الفنون إجمالاً، وهي ذات الأسئلة التي ترتسم في ذهن المتلقي، فتأخذه الحيرة في الإجابة عنها أو تفسيرها.