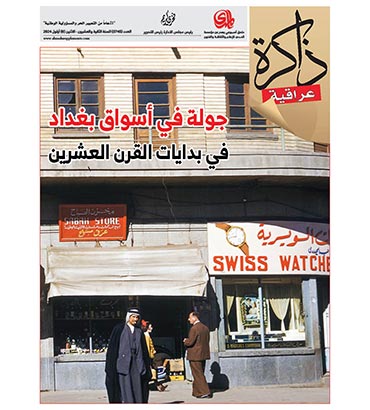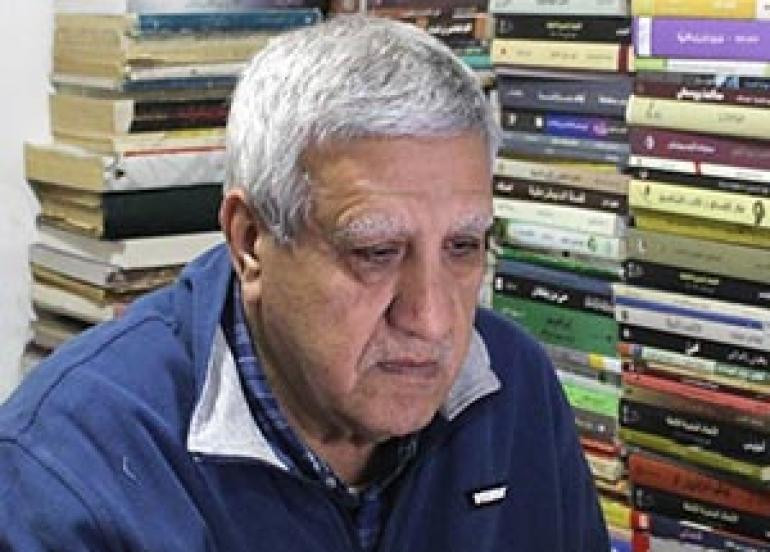طالب عبد العزيز
ليس بيننا، نحن الشعراء، من لم تفتنه قصائدُ الرائي العظيم آرثور رامبو(1854-1891) كما ليس بيننا من لم تحدثه نفسه بإمكانية إعادة نسج حياته ثانية، وإن بطريقة مختلفة، على عمق الزمن الذي يفصل بيننا. هذا الطفل الممسوس بنار الابجدية مازال يحرّضنا على الشعر والنفور والرفض والموت بطريقة مختلفة الى اليوم، نحن الذين لم تتحقق ذواتنا الشعرية كما شئنا لها، فلم نتهكم على قول معلمنا:( الوطن ينهض) بقولنا: ( ولماذا لا يجلس؟) ليضحك الطلبة في الدرس.
أن تقترن الموهبة بالشجاعة، والوطن بمحاولة التخلص منه، والأسرة بنبذها وهجرتها، والاستقرار بوجوب عبور الاودية والسفر والتجوال، والتجديد برفض السائد في صبي شاعر ذاك ما تطلعنا اليه، في مرحلة مبكرة ما من حياتنا. هذه الثنائية التي جعلت من الشاعر أمثولةً في الخلود، وإن عبْر الحياة، إن لم يتحقق الشعر، إذا ما أدركنا بأنَّ رامبو لم يعد يحمل في حقيبة سفره الابدي غير المال، وجواز سفره ومرتسمات خرائط وجهتها للشرق، الارض التي ستلفظه محمولاً على نقالة من تصميمه.
رامبو الذي تقول الروايات بانّهُ كان شجاعاً، مغامراً، ورافضاً، وأنَّ الحرب كانت واحدةً من أسباب هروبة من باريس باتجاه الساحل العربي، الحرب التي رفضها بهروبه ذاك، فأتذكرُ أنني كثيرا ما خططت لحفر نفقٍ عميق، في بستاننا بابي الخصيب، والاختباء فيه، حتى نهاية الحرب مع إيران، وحتى اللحظة هذه ما زلت أقف في المكان ذاته، أتطلع في الحفرة المفترضة، التي كنت اعتقد بانَّها ضامنة لي، وبمستطاعها الاختفاظ بجسدي طرياً، خالياً من القروح.. لكنني، لم أفعل، فلم أكُ لأمتلك شجاعته، وهنا أسجل إعترافي بجبني، أو لأجمّل القول بعض الشيء فأقول : بأنني آثرتُ الموتَ والتخلي عن الحياة والشعر على شباب زوجتي ونعومة أكفّ اطفالي.
لكنني، وفي جانب آخر من قراءتي لأعمال رامبو والكتب العديدة التي كتبت عنه شاعراً وانساناَ، كثيرا ما أذهبُ مع رأي الشاعر سامي مهدي في كتابه المختلف(أرثور رامبو. الحقيقة والاسطورة- قراءة مختلفة لسيرة رامبو وشعره وتفوهاته النظرية) الذي لم يكن وحده من توقف عند حقيقة الشاعر وأسطورته، والتي تذهب في بعضها الى تغليب اسطورة حياته على أهميته شاعراً، فهذا ايف بوفوا يقول:” من المحتمل أنَّ فرصة إعادة اختراع الحب قد اختفت الى الابد مع الطفولة الساذجة.. إن رامبو يكفُّ عن الكتابة عندما تحرمه نهاية الطفولة، الملزِمة أكثر من أيِّ قرار فكري، من الامل في تغيير الحياة».
ولعل فكرة تغيير الحياة عبر الشعر هي ما يجعل من حياتنا في الشعر مستحيلةً، حيث تخفق اللغة وابتكاراتها، وتخفق القصائد ولحظات خلقها، مثلما تخفق محاولات التجديد، ويخفق معها كل تطلع شعري، وبأيِّ متّجه كان، ذلك لأنَّ الاسيجة ستظل ترتفع وتعلو، لتصير سوراً من صوّان صلد، ستتحطم عنده الاخيلة والشجاعات والحماقات والتهورات أيضاً. كان رامبو قد اصطدم بالعقبات تلك كلها، وكنا ومازلنا نصطدم نحن الشعراء بذلك كله، وقد تضاعف كثيراً. لكنَّ عزاءنا، كلَّ عزائنا يكمن في الذين سيكتبون حياتنا، حياتنا التي لم تكن لتتسع كثيراً، لأننا لم نكن شجعاناً بما يكفي لتصبح اسطورةً.
في الكتاب الذي الذي بعث به لي الدكتور حسين مجيد، وهو أكثر الاساتذة عناية برامبو( أخي رامبو) لمؤلفته أزابيل رامبو، شقيقة الشاعر، تنسجُ اسطورةً، لم تعشها هي، إنما بناءً على قراءتها لرسائله، فهي ترصد رحلته الى الشرق سنة 1870 هاربا من الحرب، فنراها تعبر الجبال والاودية والسهول معه، ومعه تعاين الشمس الشاحبة في لندن، ونراها معه تحت سماء ايطاليا الزرقاء، وهي ذاتها في جليد سان جون، ومعه تتيه في جزيرة جاوة، ثم ترافقه الى الجزر التي مرَّ بها، حتى العاصفة التي كادت أن تودي بحياته، في رأس الرجاء الصالح، قبل بلوغه عدن والحبشة. يقول أحدهم: هناك أكثر من ثلثمائة كتاب عن حياة رامبو، هو الذي لا نجده شاعراً كبيراً إلا في قصائد معدودة.