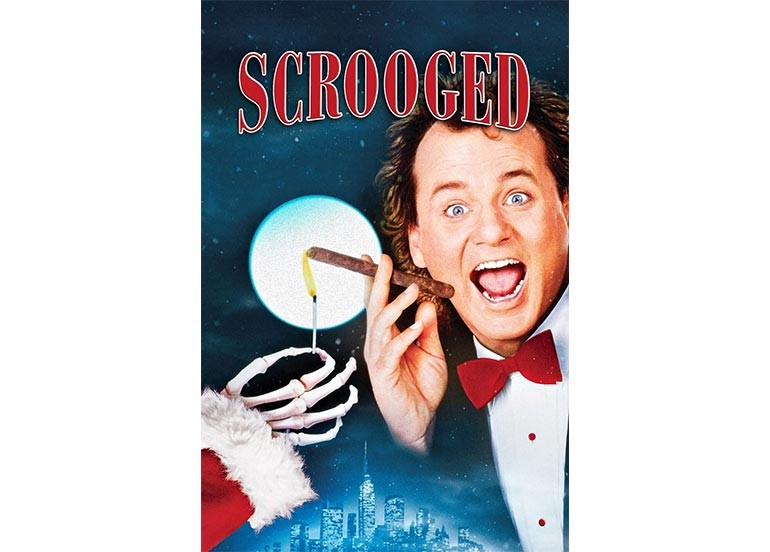عدنان حسين أحمد
يُعدّ فيلم “التل” للمخرجَين لينا تسريموفا ودونيه غيربرانت من الأفلام الوثائقية المُذهلة التي تضع المتلقي في دائرة الدهشة والإبهار لما يتوفر عليه من شكلٍ ومضمون فنيين يتلاقحان منذ مُستهل الفيلم
حتى نهايته مع البُعد الرمزي لكل حكاية يرويها رجل ناضج أو امرأة طاعنة في السن أو فتاة يافعة تتطلع إلى المستقبل بشغف لا ينقصه الوعي الحادّ الذي تستمده من مدرسة الحياة القاسية في تلك المضارب التي تحمل تداعيات انهيار الامبراطورية السوفيتية التي خلّفت وراءها جيوشًا من العاطلين عن العمل والأمل. يتمحور فيلم “التل” الذي عُرض في القسم الموازي لمهرجان (كان) السينمائي هذا العام على مكب ضخم للنفايات في قيرغيزستان يسكنه الرجال والنساء وبعض الأطفال بينهم جندي سابق مُصاب بصدمة نفسية، وامرأة كبيرة في الخامسة والستين من عمرها فقدت خمسة من أبنائها، وشاب مُعدَم، ومراهقة يافعة محرومة وغيرها من الشخصيات التي سُدّت بوجهها السُبل ولم ترَ غير هذا المكبّ الأسطوري الهائل للنفايات التي تعتاش عليها شريحة واسعة من المجتمع القيرغيري الذي وجد نفسه في العراء يحاول ترميم ما أعطبتهُ الإمبراطورية السوفيتية المنهارة.
ربما تكون شخصية ألكسندر أو الغجري، كما يُطلق عليه، هي الأكثر تعقيدًا وثراءً بين شخصيات الفيلم برمتها. فهو مثقف، وواعٍ، عركته الحياة الاجتماعية والعسكرية والاقتصادية للبلد الذي يعيش فيه. ويبدو أنّ المخرجَين، لينا القوقازية، ودونيه الفرنسي، قد وضعاه في قلب الأحداث وجعلا منه بؤرة القصة السينمائية التي كتباها، وبرعا في سرد تفاصيلها الدرامية المؤثرة والفاتحة للأعين والأذهان. وعلى الرغم من أهمية الأدوار التي أُسندت للشخصيات الأخرى باختلاف مرجعياتها الاجتماعية والثقافية والعِرقية إلاّ أنّ هذا الجندي الغجري يكفي لأن يكون نواة الفيلم وجوهره الذي يقول كل شيء دفعة واحدة. ولهذا السبب سنتتبّع سيرته الذاتية، ونقتفي مواقفه الفكرية، ورؤيته للحياة التي هزّتهُ من الأعماق سواء في حياته الشخصية أو في أثناء خدمته العسكرية، ومشاركته في الحروب التي كشفت عن وحشيته، وأظهرت جبِلّته الشريرة التي سوف ينتبه لها مؤخرًا قبل أن ينزوي ويعتزل الحياة الاجتماعية مفضلاً الحياة في هذا المكبّ المُخيف الذي يحدّق بأطراف المدينة مثل غول مسعور لا يتورع عن ابتلاع آلاف الفقراء والمعوزين الذين لفظتهم الحياة (الديمقراطية) غِبّ انهيار عقلية القمع والاستبداد والمصادرة ومازالو يتضوّرون جوعًا، ويموتون بسبب الأمراض المتفشية، وصعوبة الحصول على الدواء بينما هم يتوسدون أكداس النفايات، وينامون بين مخلفاتها العفنة التي تُزهق الأرواح. نشأ ألكسندر وترعرع في العاصمة القيرغيزية بيشكك وتطوّع في الجيش، وتدرّب على القنص لمدة سنتين، وخدم الوطن لمدة ست سنوات لكنه خرج خالي الوفاض بلا راتب شهري أو معونة اجتماعية. يتذكر ألكسندر المعركة الفظيعة التي وقعت بالقرب من كروزني، عاصمة الشيشان. وفي المرة الأولى التي أطلق فيها ألكسندر النار على عدوٍ لا يعرفه بكى لمدة 15 يومًا متتالية. وفي المرة الثانية والثالثة كان القتل أسهل بعد إن اعتاد عليه، وفي المرة الرابعة كان مستمتعًا به! لا يجد ألكسندر حرجًا في القول: ”لقد اعتدنا أن نخوزق النساء والأطفال ونسحق العدو بدباباتنا”. وكان يعتبر نفسه “مجرد آلة قتل ووحش تجاوز كل الحدود”، ثم يُمعن في الإساءة إلى نفسه ومنْ هم على شاكلته بأنهم كانوا: ”كلاب حروب مُدرّبة” وسيبقون كذلك من وجهة نظره. ولهذا يرفض العودة إلى المجتمع ويفضّل العيش في هذا المكان الموبوء الذي تحاصره الأوبئة والأمراض، والعزلة الاجتماعية القاتلة.
الشخصية الثانية هي تاجخان المولودة عام 1959 في إقليم (أوش) أنهت دراستها عام 1977. ثم تزوجت وأنجبت 8 أطفال. كان زوجها يعمل في (الكولخوز) ،أي المزرعة الجماعية، وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي وجد نفسه بلا عمل فاتجه إلى مكب النفايات منذ 27 عامًا، بينما انهمكت تاجخان في العمل بالمكبّ ذاته منذ 17 سنة. وخلال هذه السنوات المُضنية فقدت 5 أبناء كان البعض منهم يعاني من أعراض بسيطة مثل الصداع أو الآلام العرضية. كما أصيب زوجها بجلطة دماغية الأمر الذي أضطرها للاستمرار في العمل بمكب النفايات لتحصل على ما يسد رمق الأسرة. وكلّما احتاجت شيئًا ضروريًا كانت ترهن خاتمها الذهبي للحصول على بعض النقود على أمل استرداده في وقت لاحق.
تستدير عدسة الكاميرا صوب “كيْرات” وهو شاب في أواسط العشرينات من عمره لم يكن يفكر ذات يوم بأنه سيعمل في مكب للنفايات ولكنه يصف هذا العمل بالقدر المكتوب الذي لا يستطيع الهرب منه. وهو يساعد أمه الكبيرة في السن إذا ما صدفها وهي تحمل كيسًا كبيرًا من القناني البلاستيكية أو الزجاجية الفارغة. لقد جرّب العمل في الانشاءات لكنهم لا يدفعون بالمقابل أجورًا مجزية للعمل الشاق ففضّل العمل في مكب النفايات لكن اللافت للانتباه هو خشيته من أنّ الحكومة قد تغلق هذا المكان الذي تعتاش عليه العوائل الفقيرة التي لا تمتلك سوى جهدها العضلي وصبرها على تحمل الظروف الصعبة.
تمثل البنت المراهقة (جزيرة) أنموذجًا للفتاة الطموحة التي ترى نفسها بعين واقعية لا تستصغر الفقراء، فالناس في المدن ينظرون إليهم كمشرّدين يعيشون في قاع المجتمع، ويلتقطون ملابسهم من النفايات. وعندما بدأت تواعد شابًا من المدينة اختلفت معه لأنه ينظر إليها كصبية متشردة ترتدي ملابس رخيصة الأمر الذي دفعها لمقاطعته لأنها عتادت أن ترى نفسها “كملكة” وأن كل شيء يسير على مايرام رغم شظف العيش وضيق ذات اليد.
هناك شخصيات كثيرة يزخر بها هذا الفيلم الوثائقي المُعبِّر مثل أليونا، زوجة الكسندر التي بدت متصالحة مع نفسها وهي تسوّي شعرها تارة، وترتّب هندامها المتواضع أمام عدسة الكاميرا تارة أخرى. وكذلك بودولَي، الأكبر سنًا بين المشرّدين حيث أمضى 40 عامًا بين النفايات العفنة والروائح العطنة التي تخنق الأنفاس. ثمة شخص يدوّن سيرته الذاتية ويكتب أشعارًا يستمد مادتها من ذكرى حبيبته متماهيًا مع جمال الطبيعة الذي لا يبتعد كثيرًا عن المكب مثل شروق الشمس ومغيبها، ولعل هذا التماهي هو الذي يمنحة القدرة على تحمل صعوبة الحياة، وضنك العيش في هذه العزلة (البرّية) المقيتة.
قد لا يجد البعض في هذا الفيلم شيئًا مميزًا على الصعيد البصري لكن المتأمل للحرائق المندلعة في جبال من النفايات، وأضوية السيارات الكشّافة التي تخترق سدول الليل هي التي رصّعت الفيلم بجماليات بصرية قلّما ينجح في تحقيقها مخرجون متمرسون. كما لعبت الغربان المحلِّقة في السماء، والقطط والكلاب التي تجوس بين أكداس النفايات وممراتها وحفرها الكثيرة دورًا في إضفاء الجو الحميمي الذي يحطم جدران العزلة الموحشة ويمنح المكان ألفة مُحبّبة تعيد للمشرّدين بعضًا من بهجتهم المفقودة.
جدير ذكره أن لينا تسريموفا هي مخرجة قوقازية مبتدئة ماتزال منهمكة في دراستها الجامعية وتعمل على إنجاز مشروع ترحيل القوقازيين الذين اتهموا بالتعاون مع النازيين في ظل حكم ستالين الذي تميز بالقسوة والدموية والعنف. أما دونيه غيربرانت فهو مخرج فرنسي ذائع الصيت ومن أفلامه المتفردة “مسألة الهُوية”، “قبلَ ظهور السماء”، “معسكرات الصمت” وغيرها من الأفلام الوثائقية والروائية والقصيرة.