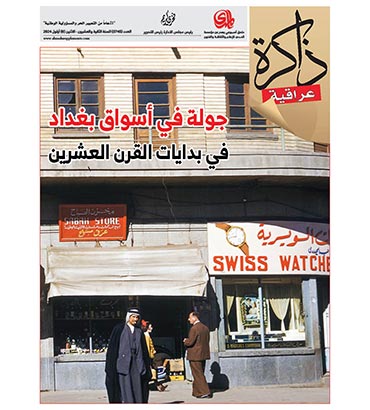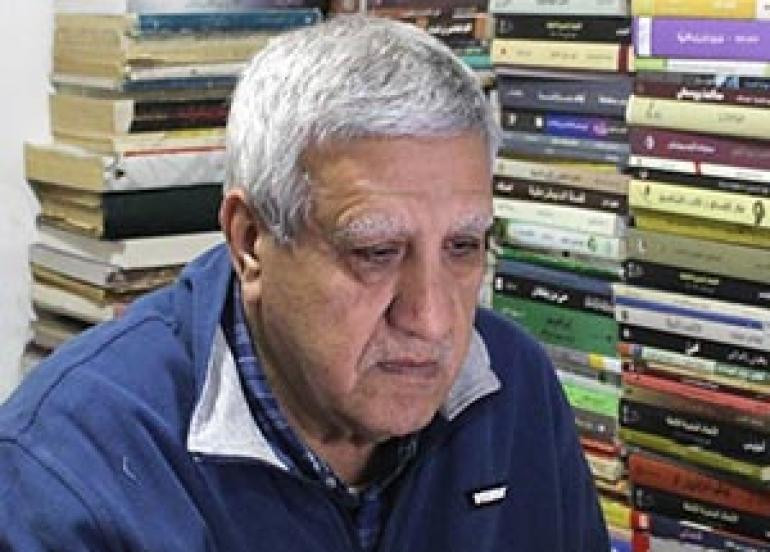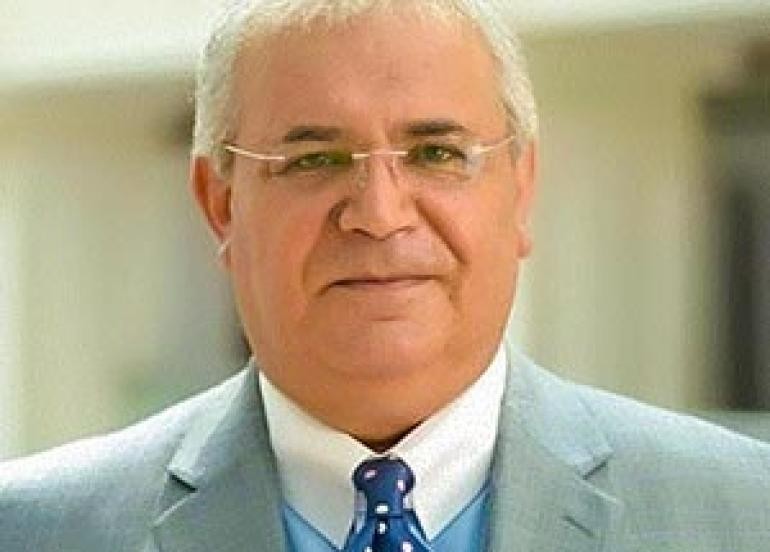طالب عبد العزيز
لا تقلقْ، لأنك لم تبلغ وجهتك بعد، فما أنت من الخسران بشيئ، هناك الكثير مما لو تجاوزته لأكل قلبك الندم، ولطالتك صيحات أمّك، في آمادك العاليات، وأنت تتحلق من غصن لغصن في أشجار متاهاتك. كلُّ كمال مقلقٌ، وكل وصول حيرةٌ، لكنْ، كل نقصان سرور،
وكل عوزٍ مذلة وتوسل، أرأيت أجمل من مذلة بين يدي الحبيب؟ وهل يضيرك عوزاليه؟ وفي كل رهبة من لقائه تدفق للدم فيك. هبْ أنك بلغت أعلى غصن في شجرة اليوكالبتوس، التي تسلقتها طفلاً، ما أنت صانع بالسماء؟ ما أنت تارك في الارض؟ رأيت منارة جامع المُقام، وخزان الماء العتيق في باورهوز، والقباب الخضر التي تحيط مسجد الموسوي.. ثم ماذا؟ هل ستقف على بغيتك عند حدٍّ ما؟ أبداً، فهذا الفضاء يتسع، كلما أعملت ببصرك فيه، فهو محدود عندك، وأنت متسعٌ موقوف لديه، فقفْ حيث أنت، قفْ.
قبل أن تكمل الشمس نسيجها على مدخل الفندق، دخلتُ مدينةً ما، لن اسمّها، إذ، كل اسم لشيءٍ يُذهب ببعض معانيه، وكل تعريف افساد لصورة مرسومة له. ومن الحافلة الكبيرة التي جاءت بنا، من المدينة التي كنا فيها قبل اسبوعين، أخذني سائق سيارة الاجرة الصغيرة الى السوق، لم يكن سوقاً، إنما دكانة لبقال وحيد، أجْمَلَ بضاعته في كيس، كان جالساً بانتظاري، أنا زبونه الوحيد، وهو بائعي الاخير، في السوق الكذب، لا يُحسن لغتي، ولا أحسن لغته، لكنه مدَّ يداً يابسةً فصافحته، وأطلتُ ابتسامة بوجهه، فانفرجت اساريره، أثنى على السائق، قبل أن يسلّمني ما ابتعت منه. في المدينة التي لم تُقفلْ أبوابُها بعد، كان السور عالياً، ليس ذاك الذي شيّده كالفينو في مدن ماركو بولو، أبداً، هو سورٌ ظل يرتفع، شيئاً فشيئاً، في ظلام المدينة الذي ران، ومن جوفها الخَرِب رحت أسمع وقع المطارق.
يعمدُ سفّافو الحُصُر من الخوص في مدن النخل ومثلهم يفعل نسَّاجو البسط والسجاد في مدن الاغنام والماعز، وكلُّ ذي صنعة وحرفة قوامها الحجر والخشب والحديد والجريد الى جعل عيب ظاهر، في ما يسفّون وينسجون ويشحذون وينجرون ويبنون، فترى الحصيرجميلاً، والسجادة باهرةً، والبساط غاية في الأناقة، والباب بدعةً في الصنع لكنك ستقع على غرزة ناقصة فيه، أو ثقف صغير ترك، أو مسار وشيعة متعرج، شذَ عن جادته، هو اختبار المتأمل العجل، وإذكاء في الخيال، وسقط متعمد، تقصدته الاصابع والعيون، فأنزلته العقول منزلته الحق. قبائل السفافين والنساجين والنجارين والبنائين تواتروا على ذلك، توارثوه عن أسلافهم، وظلوا يوهمون الناس بكمال صنعتهم، التي لن تكمل أبداً. إذْ، كل ما يفعله الانسان ناقصٌ، ومخروم، فالكمال صنعة الآلهة التي في السماء. بالترك والنسيان والغفلة العمد حافظ هؤلاء على أصابعهم، لتظل تسفُّ وتنسجُ وتنجر وتبني.
وفي معنى الحبَّ يقول صاحبٌ لصاحبه:” لا أخطبُ اليه مودةً، لكنني، طيرُ السماء، على ألفه من الارض يقعُ. يا الله، أفي اللغة قول أصدق من هذا؟ أسألُ، أحياناً: ترى، هل القبلة والعناق واللثم والضم وسواها حدود مثلى ونهائية للحب والود؟ أما كان أجدر بالطبيعة أن تمدَّ بالحدود تلك، إلى ما لا نعلمه وندركه، أبشتباك الاصابع يستنفدُ هذا الحب، أبنطواء الجيد على الجيد نبلغ المراد؟ أبغرز الأنف في غابة الشعر الجعد نسترد الارواح؟ وماذا عن اصطكاك أضلاعنا بأضلاع من نحبهم؟ هل وفيناهم حقهم في الودِّ والحبِّ والشوق.. ما لهذه الروح لا تُروى بشيء؟ ما لهذا الجسد لا يكف متلهفاً محترقاً، تتدفق أنهار وجده، وتنبثق عيون شوقه، وهو ظامئ أبدي، وتتلاطم بحار مراده من حوله وهو غريب؟